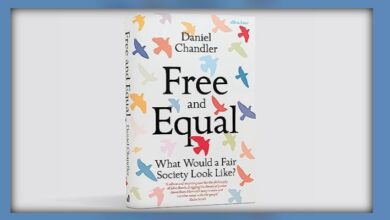في حاجة المسلمين اليوم إلى الكندي
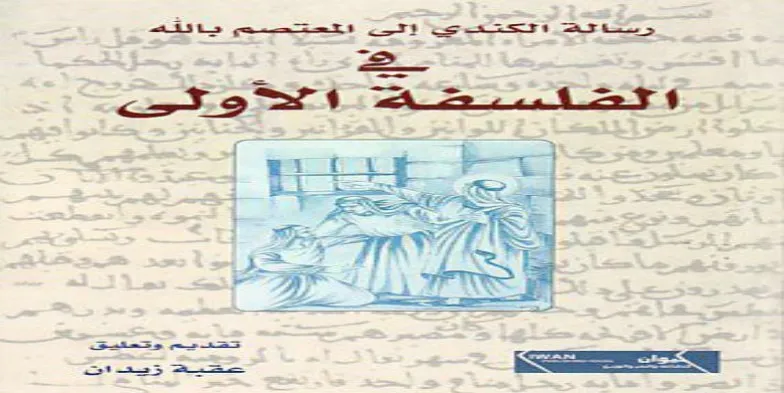
قد يتساءل البعضُ أينَ تكمُنُ راهِنيَّة أبي يوسف يعقوب ابن أسحاق الكندي اليوم بالنسبة للمسلمين، وما الحاجة لهُ في زمننا وهو الذي عاش في بداية القرن الثالثِ الهجري والتاسعِ الميلادي، ويبدو هذا الاعتراض مقبولا ومنطقيّا بالنظر إلى المسافةِ الزمنيَّة التي تفصلُنا عنه. وقد يقول البعض: الكندي عاش في زمانه وفي ظروفٍ تختلفُ عن حاضرنا اليوم، ولا فائدة في العودة إليه. لذلك سنُوضحُ حاجة المسلمين للكندي من خلال مشكلتين أساسيتين نعيشُها اليوم:
– المشكلةُ الأولى: تكمُنُ في التخلّفِ الحضاري الذي يعيشهُ المسلمون والعرب في جميع الميادين، ممّا جعلهم في مأزقٍ حقيقيِ مع المجتمعات المتقدِّمة، فلا هم قادرُون على المساهمة في هذا التقدُّم ولا هم استطاعوا الاستفادة منه.
– المشكلة الثانية: وهي نتيجةٌ طبيعيَّة للأولى، تَقَوقُعُ المسلمين والعرب على الذات وتمجيدُها بشكلٍ مَرَضِي، ممَّا أدَّى إلى انتشار ميولاتِ التطرّف الديني والقومي ورفض الآخر، بسبب الجهل به وغيابُ حوار معه.
ولكن، هذا التشخيصُ لحاضرِ المسلمِينَ والعربِ اليوم معروف، ولا ينكرهُ إلا جاحدٌ أو متعصِّبٌ لهويَّة قاتلةٍ حسب تعبير أمين معلوف في كتابه الهويّات القاتلة، فأين تكمُنُ علاقةُ الكندي بحاضر المسلمين والعرب؟
لمعرفةِ علاقة الكندي بحاضِرِ مجتمعاتنا العربيَّة والإسلاميَّة التي شخَّصنا بعض مشاكلها سابقا، لا بد من المقارنة بين مجتمعاتنا في الماضي والحاضر الذي نعيشهُ وسنجِد الكثير من عناصرِ التشابُه، والتي نلخّصُها في النقاط التالية:
– عاشَ الكندي في بداية تشكُّلِ المجتمع العربي الإسلامي الذي لم تكُن لهُ معرفةٌ علميَّة حقيقيَّة ما عدا تعاليم الدينِ الجديد، ومع توسُّعِ العربِ المسلمين وغزوهُم للحضاراتِ المجاورة اكتشفوا تأخّرهُم العلمي أمام تقدُّمِ غيرهم من أتباع الدياناتِ الأخرى، وهو ما جعل الجو متوتّرا بالصراعات المذهبيَّة والعقديَّة.
– ترأس الكندي المشروع التنويري للخليفةِ العباسي المأمون وعكفَ على ترجمة ودراسة الفلسفة اليونانيَّة وعُلومها، من خلال إشرافه على بيت الحكمة الذي جمع فيه الخليفةُ أعلام الفلسفة وعُلومَ الأوائل من الأقطار التي فتحها المسلمون، وهو ما ساهم في ظُهور ِحضارةٍ عربيَّة إسلاميَّة أبدعت في ميادين كثيرة.
هكذا يبدو التشابهُ واضحا بين زمنِ الكندي وحاضِرنا، فنحنُ أيضا نعيشُ اليوم أكثر أوقاتِ تخلّفنا وعجزنا، بعد صدمةِ الحداثة والتقدُّم العلمي الذي يعيشه العالم المتحضِّر، كما أننا لم نستطع تجاوز عُقدةِ الذاتِ والبُكاءِ على الماضي، مما ولَّد لنا حِقدا على الآخر المختلفِ عنا وكُرهها لِكُل ما أنتجهُ من علومٍ أو قيمٍ إنسانيَّة، وازداد التطرّفُ الديني والتعصُّبُ القومي حتى أصبح سمتنا التي تميِّزنا بين الأمم.
نعيشُ اليوم أكثر أوقاتِ تخلّفنا وعجزنا، بعد صدمةِ الحداثة والتقدُّم العلمي الذي يعيشه العالم المتحضِّر، كما أننا لم نستطع تجاوز عُقدةِ الذاتِ والبُكاءِ على الماضي، مما ولَّد لنا حِقدا على الآخر المختلفِ عنا وكُرهها لِكُل ما أنتجهُ من علومٍ أو قيمٍ إنسانيَّة، وازداد التطرّفُ الديني والتعصُّبُ القومي حتى أصبح سمتنا التي تميِّزنا بين الأمم.
أعتقدُ أنَّ الكندي يمثِّلُ خير نموذجٍ لمحاولة تجاوز بعضِ هذه العوائق الحضاريَّة، لأنهُ انتبه في بعض كتبهِ إلى ميل المسلمين في بدايتهم لرفضِ عُلوم وإنجازات الحضارات السابقةِ، وهُو ما رفضهُ مُعتبرا أنَّ الاستفادة منهم واجبة، وقد عبَّر عن ذلك في نصٍّ ما أحوجنا لقراءتهِ اليوم يقول فيه:”وينبغي لنا أن لا نستحِي من استحسانِ الحقِّ واقتناءِ الحقّ من أين أتى، وإن أتى من الأجناسِ القَاصية عنّا والأمم المباينةِ لنا، فإنه لا شيء أولى بطالب الحقّ من الحقّ، وليس ينبغي بخسُ الحقّ، ولا تصغيرٌ بقائلهِ ولا بآلاتي به، ولا أحد بخس بالحقّ، بل كلٌ يشرّفهُ الحقّ.”(رسائل الكندي الفلسفيَّة، تح:ع.ه.أبوريدة،ط2،القاهرة،ص.33).
يدعُو الكندي مِن خلالِ هذا النصِّ المسلمينَ في زمنهِ إلى الانفتاح على غيرهم، من خلالِ الاستفادة منهُم وعدم الاستحياء من ذلك، ولو كانُوا من دياناتٍ مختلفةٍ وأجناسٍ مخالفةٍ لنا، وهي نظرةٌ تَعتبرُ أن الحقَّ لا دين لهُ ولا جنس لهُ، لأنَّ العرب المسلمين زمن الكندي استضموا بعُلومِ وتراثِ الأقوامِ المخالفينَ لهُم واختلفُوا في التعاملِ مع هذا التراثِ اليوناني والمسيحي واليهودي والفارسي والمصري وغيره، فكان الكندي واضِحا في ضَرُورةِ أخذِ ما يُفيدنا من هؤلاءِ وأن لا نبخسهُ أو نحتقره، وهو العمل الذي قام به الكندي نفسه بتشجيعٍ من الخليفةِ المأمون، الذي شجَّع على نقل علُومِ الأوائلِ ودراستها وتعلِّمها، ما سيجعل الحضارة العربيَّة الإسلاميَّة حضارة متقدِّمة لقُرون من الزمن.
ثُم يُضيفُ الكندي أنهُ لا يجبُ ذَمّ المخالفينَ لنا إذا قصَّرُوا في بعضِ الأحيانِ عن الحقّ أو خالفُونا، ويقُول في نفسِ الكتاب: “ومِن أوجبِ الحقِ ألا نذُم مَن كانَ أحدَ أسبابِ منافعِنا الصغارِ الهزليَّة، فكيفَ بالذِينَ هُم أكبرُ أسبابِ منافعِنَا العِظام الحقيقيَّة الجدّيَّة، فإنهُم، وإن قصَّرُوا عن بعضِ الحقّ، فَقَد كانُوا لنَا أنسَاباً وشركاءَ فِيما أفادُونا من ثمارِ فكرهِم التي صارت سُبلا وآلات مؤديَّة إلى علمِ كثيرٍ مما قصرَّوا عن نيل حقيقته.”(ص.32).
نُلاحظُ مستوى الخِطابِ الذي يستعملهُ الكندي للكلام عن الآخر المخالفِ، فهُو يعتبرهُ شريكاً ونسيباً في الحقّ، وأفكارهُم ثمارٌ تفيدُنا يَسَّرت لنَا سُبل العيشِ والرقي الحضاري، وهُو ما حدث بالفعل فقد كانَ للحضارةِ اليونانيَّة الفضل الكبير على العربِ والمسلمينَ في تطوّرهم وتقدّمهم لقرون، في زمنٍ ازدهرت فيهِ حضارتهُم وصارت مركز العالم، كُل ذلكَ كانَ بسببِ هذا الحوار والأخذ من اليونان، وهُو ما أنتجَ شخصيَّات علميَّة مرموقة أفادت الإنسانيَّة إلى اليوم منها ابن سينا والخوارزمي والرازي وابن النفيس والفارابي وابن طفيل وابن باجه وابن رشد…، ولا يفُوتُ الكندي أن يدعُوا لشُكرِ من سبقُونا وأفادُونا من ثمار فكرهم ويقول:”فينبغيِ أن يَعظُمَ شُكرُنا للآتِينَ بيسيرِ الحقِ، فضلاً عَن من أتى بكثيرٍ من الحقّ، إذ أشركُونَا في ثمارِ فكرهِم وسهّلُوا لنَا المطالبَ الحقِيَّة الخَفِيَّة، بمَا أفادُوناَ مِنَ المقدّمَاتِ المسهّلةُ لنَا سُبُلَ الحَقِ…”(ن.م.ص.32).
بعدَ عرضِ هذهِ النصُوصِ نجدُ أن الكندي بالفعل ضرُوريٌ لزَمانِنا، وكأنهُ يقدِّمُ حلُولاً لحاضِرنَا؛ هذا الحاضرُ الذيِ نسينَا فيهِ تُراثنا وماضينا الزاخر، نسينا أنَّ سبب تخلّفنا هُو رفضُنا للعُلوم والبحث العلمي، وانغلاقناَ على الذاتِ وتحقِيرنا للغير، لم نستطِع أن نفهَمَ أنَّ أي فِعلٍ حضارِي للخُروجِ من وضعِ التخلُّفِ، لا بُد أن ينطلقَ من الغيرِ المختلفِ، والتعاونِ والشراكةِ معهُ وقبُولُهُ أولاً، لأنهُ بدُونِ قبُولٍ لاَ يتحقَّقُ حوارٌ ولا شراكة، خاصَّةً ونحنُ نعيشُ في زمن التطرّفِ الديني والتعصُّب المذهبي الذي ابتليت بهِ مجتمعاتُنا العربيَّة والإسلاميَّة، هذا التعصُّب كان نتيجة لتخلّفنَا الذي اكتشفناه متأخّرينَ مع صدمَةِ الحداثة، وعِوَضَ أن نبني جسُور حوارٍ وشراكة مع الأممِ المتقدِّمة، نَصبنَا لها العداءَ وانقلبنا على الذاتِ نمجّدها ونبكي على الأطلالِ، لذلِكَ تبقى تجربةُ الكندي الملقبُ بفيلسوفِ العرب، علامة مُتميّزة فيِ تاريخناَ العربي الإسلامي لابد من العودةِ إليهَا لتعلّم الدُرُوسِ والعِبَرِ.
سبب تخلّفنا هُو رفضُنا للعُلوم والبحث العلمي، وانغلاقناَ على الذاتِ وتحقِيرنا للغير، لم نستطِع أن نفهَمَ أنَّ أي فِعلٍ حضارِي للخُروجِ من وضعِ التخلُّفِ، لا بُد أن ينطلقَ من الغيرِ المختلفِ، والتعاونِ والشراكةِ معهُ وقبُولُهُ أولاً، لأنهُ بدُونِ قبُولٍ لاَ يتحقَّقُ حوارٌ ولا شراكة، خاصَّةً ونحنُ نعيشُ في زمن التطرّفِ الديني والتعصُّب المذهبي الذي ابتليت بهِ مجتمعاتُنا العربيَّة والإسلاميَّة.
*المصدر: التنويري.