لماذا ينبغي استعادة أفلاطون؟
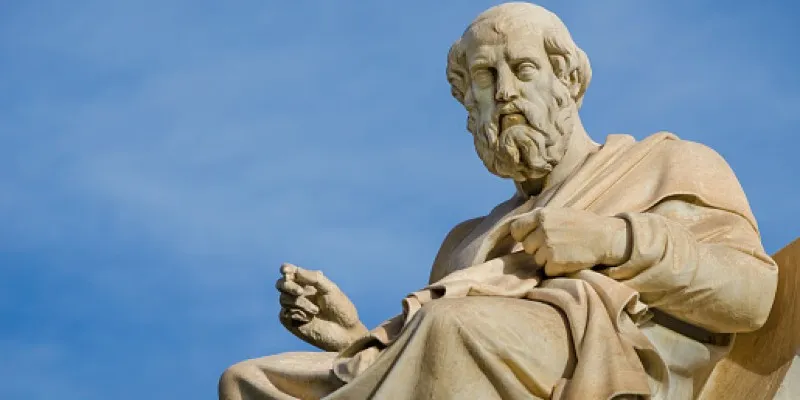
حين يُبسط الكلام على أفلاطون الآن، يتناهى للنّاظر أنّه تلقاء مفارقةٍ غير مألوفةٍ: سوف يبدو له كما لو أنّ استرجاع هذا الحكيم، وجعله قضيّةً راهنةً هو أدنى إلى عودٍ على بَدءٍ لا طائل منه. والحجّة إذ ذاك، أنّ بسطَ القولِ فيه وعليه، هو ضربٌ من تكرارٍ مسبوقٍ بما أنشأه محقّقوه وشارحوه من قبل..
لكن استرجاعنا لأفلاطون اليوم، تسوِّغه فرضيِّتان:
الأولى:
لأجل ابتعاث تفلسف مستأنف يدور مدار التساؤل عن إمكان قيام ميتافيزيقا تجاوز ما ترسخ من يقينيات منذ الإغريق إلى يومنا الحاضر.
والثانية:
لأجل التذكير بما غزاه النسيان من الأفلاطونيّة، سواء لجهة نقد مبانيها قديماً وحديثاً، أو لجهة ما يختزنه ميراثها من مفارقات تراكمت عليه الظّنون وسوءات الفهم.
ولمَّا كانت غايتنا المحورية تحرِّي الأثر الأفلاطوني في ما أفضى إليه من معاثر اقترفتها الحداثات المتعاقبة سحابة خمسة قرونٍ خلت، فإنّ من شأن هذه الاستعادة أن تنبِّه إلى الصّدع الكبير الذي ألمَّ بأبنيتها الأنطولوجيّة والمعرفيّة. فعلى الرغم من تحيُّز الحداثة إلى القدماء الذين خالفوا أفلاطون أو انقلبوا عليه، إلا أنها ستتخذ من “ثنائياته” في تفسير العالم ذريعة لإحداث القطيعة بين الطبيعة وأصل وجودها. ولنا هنا شاهدٌ على تلك الذريعة، لمّا ذهب الفيلسوف الألماني مارتن هايدغر إلى اختزال معضلة الحداثة بما أسماه “نسيان الكينونة”. أي غفلة الحداثة عن حقيقة الوجود، واستغراقها بظواهر العالم الطبيعي وأعراضه. وهذه المقولة التي عُدَّت نقطة الجاذبية في فكر هايدغر النّقدي، وأعربت عن المأزق الميتافيزيقي للفلسفة الحديثة، إلا أنها لم تفارق جوهر الثنوية الأفلاطونية. فالكينونة الهايدغرية كانت أقرب إلى الموجود الأول منها إلى الله الموجد للكون.
ومع أن الثنائي سقراط وأفلاطون قد اتَّخذا من الخيريَّة والعدالة والمجتمع الفاضل سياقاً مفارقاً للسابقين واللاَّحقين من حكماء اليونان، إلا أنهما لم يفلحا في بلوغ التوحيد الخالص كما أظهرته الديانات الإبراهيمية. ولو كان لنا من توصيف لهذه المنزلة من المعرفة عند الحكيمين لجاز القول انها إعرابٌ بيِّنٌ عن التوحيد الناقص. ربما لهذا الداعي سيغلب على كتاب المحاورات سمة التساؤل الحائر من دون النفاذ إلى المحل الذي يفصح عن إجابات يقينية عن الوحدانية الإلهية.
* * *
خلاصة ما فعله فيلسوف الجمهورية
ولم يستطع سقراط أن يكمله، تجلَّت في تظهيره لفكرة الخير الكلِّي كمصدرٍ لتحصيل المعرفة. ولقد أراد أن يحلّ هذه المسألة، تأسيسًا على نظريّة المُثُل بما هي الدفاع الأعلى عن الأخلاق الموضوعيّة. غير أن الحريَّ بالاعتناء والنّظر هنا، هو سَرَيان المنظومة الأفلاطونيّة في الأحقاب التالية وإن بأوجهٍ ومساراتٍ متباينةٍ. وعلى سبيل التذكير ـ نشير إلى منزلته المرجعية في مسيحيّة القرون الوسطى، وخصوصاً لجهة توظيفها لفكرة العناية الإلهيّة في نظامها الفلسفي. غير أن هذا التوظيف سيكون له نتائج عكسية لما ذهب آباء الكنيسة من فلاسفة العصر الوسيط إلى استلهام لاهوته الطبيعي الوارد في كتابه القوانين (Laws)، وأخرج فيه معادلته الشهيرة: أ- إنّ هناك آلهة، وهي تعتني بشؤون البشر، ومن المستحيل رشوتها أو شراء إرادتها الخيّرة”… والنتيجة أن هؤلاء سيقعون في التناقض بين إيمانهم الديني ونظامهم الفلسفي بسبب الأثر الذي تركته فكرة تعدد الآلهة عند أفلاطون.
من البيِّن بسببٍ من ذلك، أنّ فلاسفة الحداثة الذين أخذوا دُربتهم عن الإغريق، وتحرَّروا من الميتافيزيقا الأفلاطونية، ما لبثوا ان اقترفوا جناية «الفصل الإكراهي» بين اللّه والعالم. وهذا الفصل لم يكن مجرد حادثٍ عارضٍ في بنية الفلسفة الحديثة، وإنما هو حاصل إرث إغريقي له امتدادُه وسريانُه الجوهري في ثنايا العقل الكلِّي لحضارة الغرب بهذه الدلالة. لم يكن لمكوث أفلاطون بين ضفتّيْ الشرك والتوحيد سوى مؤشِّر على الإضطراب الميتافيزيقي الذي سيورثه إلى العالم الغربي في ما بعد. حتى لقد غدا كلُّ سؤالٍ تُعلنه الحداثة على الملأ مثقلاً بحوامل السَلَف اليوناني: من الثنوية الأفلاطونية إلى النسبيّة والشكوكية ناهيك بمجمل ما يمكث من آثار وتداعيات ترتَّبت على حصريّة التفكير الحداثي في دنيا المقولات الأرسطية العشر.
* * *
لا نبتغي من وراء قصدنا، المفاضلة بين أفلاطون وأرسطو.
ولا كذلك، الانتصار لأفلاطون بدلاً من شُرعة الحداثة ومبادئها.. وإنما للإضاءة على البَدءِ الذي منه صار أفلاطون فيلسوفًا، ثم جرى الانقلاب عليه مع أوّل ظهورٍ لمملكة العقل الأدنى. فما نعنيه بالبَدء الأفلاطوني على وجه التعيين، قوله بأصالة عالم المُثُل باعتباره الوجود الحقيقي. وبقطع النظر عما يحتمله هذا القول من اعتراضات. وما انهمر عليه من مؤاخذات القدماء والمحدثين، إلا أنه جاء في حينه كردٍّ صريح على مادية السوفسطائيّة ولاأَدريَّتِها الصمَّاء.
بل هو في حصيلته جاء تنبيهاً للعقل على وجوب مساءلة الوجود الحقيقي أنّى استعصت قضاياه على الفهم والإدراك. مثلما أعاد فتح كوة جديدة في الجدار الإسمنتي الذي أقامته الطبيعيات اليونانية أمام الإلهيات. لقد سار أفلاطون على هَدْيِ سقراط حين اتّخذ السّؤال بابًا إلى صراط المعرفة. لم يَغِبْ عنه ـ مثلما غاب عن أهل الحداثة بعد عشرات القرون ـ أنّ السّؤال السّقراطي كانت له غاية ومهمّة. ولم يكن مجرّد استفهامٍ عن أشياء الكون وكفى.. فالحكمة السّقراطيّة التي أخذ بها أفلاطون. وإن اعتنت بأرض الإنسان. إلّا أنّ اعتناءها ظلّ موصولاً بشغف العثور على حضوره السعيد في الوجوةد. كان يرى إلى الإنسان بوصفه كائناً أخلاقياً وميتافيزيقياً، لا مجرد حيوان ناطق. وهذا خلاف حالِ السوفسطائيين وفلاسفة الطبيعة، كما هو خلاف ما صَنَعه أرسطو لمَّا أخضع الكائن الإنساني لأحكام العقل الأدنى ومعاييره.
حين أخرج أفلاطون نظريّة المُثل، فقد أراد إثبات عقيدته المفارقة بأن العالم المادي ليس سوى أشباح للعالم الحقيقي. وأنّ المثال الأعظم الذي يفضي إليه عالم المُثُل هو الخيريّة التامَّة، وأنّ الخير المطلق هو المقام الأرفع للمعرفة. وهو مبعث الوجود والكمال. مع ذلك بقيت نظرية الخير المطلق ضرباً من التأملات والاختبارات الذاتية. ولم تصل إلى الدرجة التي توصلُ فيه الخيرية بمصدرها الأول. ما يعني أن اقصى ما بلغته الرؤية الأفلاطونية هو التعبير عن ألوهية أرضية. سوف توظَّف في ما بعد بـما سمِيَ “الدين الطبيعي”.
في “المحاورات” و”الجمهوريّة” وفي سائر تأمّلاته الميتافيزيقيّة والسياسية. حرص أفلاطون على الوصل الوطيد بين عالم المُثُل ودنيا الإنسان: أوّلاً، عن طريق التساؤل كسبيل قويم للمعرفة الحكمية. وثانياً، في انْهِمامه بإرسال شرارة الفهم إلى السامعين. “تلك التي تولد فجأةً في الرّوح مثلما يومض الضّوء حين توقد نارٌ وتتغذّى بذاته من ذاتها” كما يورد في رسالته السابعة.. وأما ثالثاً، ففي حكمته السياسيّة القاصدة سعادة الإنسان في الجمهوريّة الفاضلة.
* * *
كانت رغبة أفلاطون في بداية حياته..
أن ينخرط في العمل السياسي، وكان متَّبعًا بذلك تقاليد أسرته. غير أنّ تبدُّلاً سيطرأ على خطّته. لمّا خسرت الديمقراطيّة الأثينيّة الحرب ضدّ إسبارطة، وأمسك “الطغاة الثلاثون” بالسلطة التي حكمت على سقراط بالموت عام (399ق.م). ذلك سيجعله على حذرٍ مقيمٍ من السياسة الأثينيّة وظلاماتها. ثم كان عليه أن يقيم السياسة على نشأة أخرى، بحيث لا تنفصل الحياة السياسيّة عن عالم المثل. ربّما لهذا الداعي سيواصل أفلاطون دحض الفكر النّسبي للسوفسطائيّة، وينظر إليه بوصفه تعبيرًا صارخًا عن الانحطاط السياسي.
حاول أفلاطون- وإن لم يسعفه القدر – أن ينقل مشروعه السياسي إلى دنيا الواقع في غير مناسبة: منها، لقاؤه الطاغية ديونيسيوس (Dionysius) الأوّل حاکم مدينة سرقوسة (Syracuse) في جزيرة صقليّة. ومنها. لمَّا ذهب إلى جنوب إيطاليا ليلتقي الفلاسفة الفيثاغوريّين، ويشاركهم تصوّراتهم في أربعة مرتكزاتٍ تأسيسيّة: – اعتبار الرياضيات جوهر الأشياء جميعها. ـ النّظرة الثنائيّة إلى الكون ـ (عالم الوجود الفعلي (المُثل) وعالم الظلال المادي) ـ هجرة الروح وخلودها ـ والتصوّف الديني والأخلاق النسكيّة…
* * *
صحيح أنّ أفلاطون انكفأ مع غزوة العقل الأدنى التي امتدّت من السوفسطائيّة إلى أرسطو. ومن بعد ذلك إلى ديكارت وكانط وسائر السلالة الحديثة. سوى أنّ مقصده الأعلى ظلّ كامنًا في تضاعيف الحضارة الحديثة. وخصوصًا في التوجهات النقدية لعدد من فلاسفتها من أمثال هنري برغسون وبول تيليتش وهنري كوربان وولتر ستيس وسواهم. وللدلالة على الأثر الأفلاطوني الساري في تاريخ الفلسفة أن الفلسفة المسيحيّة. دارت مدار اتّجاهين رئيسيين: الاتّجاه الأفلاطوني عبر القدّيس أوغسطين. والاتّجاه الأرسطي عبر توما الأكويني. سار الاتّجاه الأوّل مع الأفلاطونيّة حين جعل الموضوع الطبيعي للعقل إدراك المُثُل.
أمّا الاتجاه الثاني
الذي بقي على تماس ما مع المتعاليات الأفلاطونيّة. فقد رأى على لسان الأكويني استحالة البرهنة على الإيمان عن طريق البرهان المنطقي. لأنّ الإيمان لا يرتكز على المنطق، بل على كلمة الله.. في حين لا يمكن الاستدلال على حقيقةٍ فلسفيّةٍ باللّجوء إلى كلمة اللّه. لأنّ الفلسفة لا ترتكز على الوحي بل على العقل المحض. ورغم أنّ الأكويني كان أرسطيًّا متشدّدًا فقد حرص على التمييز بين العقل والوحي. من قبيل حفظ موقعيّة كلّ منهما في إنتاج المعرفة الصحيحة.
فإذا كان اللاَّهوت هو العلم بالأشياء عن طريق تلقّيها من الوحي الإلهي. فالفلسفة هي المعرفة بالأشياء التي تفيض من مبادئ العقل الطبيعي. ولأنّ المصدر المشترك للفلسفة واللاَّهوت هو الله خالق العقل والوحي، فإنّ هذين العِلمين يسيران ـ حسب الأكويني ـ إلى التوافق.
ومع أنّ التجربة التاريخيّة للحداثة أنجزت تقليدًا نقديًّا طاول مجمل مواريثها الفكريّة وأنماط حياتها. إلّا أنّ هذا التقليد على وزنه في تنشيط الفكر وبثِّ الحيويّة في أوصاله، فإنّه لم يتعدَّ الخطوط الكبرى لميتافيزيقا الإغريق. هذه الفرضيّة تفترض تساؤلاً بديهيًّا وأساسيًّا لم يُعطَ حقُّه من الاعتناء سحابة قرونٍ مديدةٍ من تاريخ الفكر الغربي. مُؤدّى هذا التّساؤل: استكشاف الأثر العميق للعقل الإغريقي في تكوين المبادئ الكبرى للعقل الحديث.. وتحرِّي الكيفيّات التي حملت فلاسفة الحداثة على مخاصمة الأفلاطونية، ثم راحوا يصوغون منظومتهم الفلسفيّة تبعًا لما ورثوه من السوفسطائيّة والأرسطيّة من معطيات العقل الأداتي وأحكامه.
سوف تستأنف الحداثة ـ كما فعل الأسلاف من قبل ـ الانقلاب على الأفلاطونيّة عبر سيرورة من التصوّرات والمفاهيم أفضت مع ما سمّي بالتنوير إلى “دنيوة” صمَّاء للعالم:
– آمنت الحداثة بالعالم الطبيعي على أساس أنّه العالم الحقيقي، – وبالإنسان باعتباره الكائن المنفرد في الوجود، وبالعقل العلمي الذي به يحقّق إنسانها تفرُّده وتفوّقه. ثم وآمنت أخيرًا وليس آخرًا، بالماديّة التّاريخيّة كأداةٍ وحيدةٍ لتفسير تطوّر المجتمعات البشريّة.
لم يقتصر ميراث الحداثة على استلهام ما جاءت به أضلاع المنظومة الإغريقيّة الكبرى (سقراط- أفلاطون – أرسطو)، بل ستكون حقبة ما قبل السقراطيّة ذات أثرٍ عميقٍ في تكوين العقل الحديث أنطولوجيًّا وأبستمولوجيًّا. لكأنّما قصدت الحداثة في الإعراض عن الخيريّة السّقراطيّة والأخلاقيّة الأفلاطونيّة أن تعود القهقري، إلى قيم السوفسطائيّة في اختصامها مع المطلق، وإلى أرسطو ومقولاته في تشكيل العقل الأدنى، ثم تمضي في غفلتها على غير هدًى لتكون أطروحتها حول نهاية التاريخ هي نفسها نهاية الإنسان الأخير.





