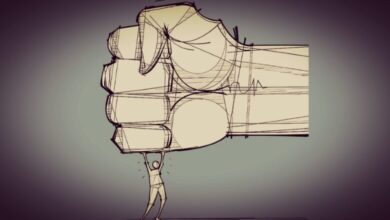مع ساعات الصباح الباكرة، تستعد حنين، وأكرم، وبشرى، وإسلام للمشاركة في الأنشطة التي تقيمها مؤسسة دربزين للتنمية البشرية، حاملين معهم آمالهم وأحلامهم في بناء مجتمعٍ مزدهرٍ ومتنوع.
تأتي حنين الكرمي على كرسيها المتحرك للمشاركة في التدريب، وتُبدي سعادتها بالتجربة الإيجابية الدامجة التي شهدتها في دربزين، وحرص المؤسسة على تلبية كافة احتياجاتها الخصوصية، وتوفير سبل الحصول على فرصة مساوية للآخرين. تقول الكرمي: “شعرت أنهم اختاروني لأني أنا، وليس لأنني من الأشخاص ذوي الإعاقة”.
في المقعد المجاور لها داخل القاعة، يجلس أكرم كامل، الذي جاء من العراق عام 2016، ولاحظ في البداية تساؤلات حول كيفية انخراط شاب عراقي في قضايا تهم المجتمع الأردني، لكنه سرعان ما وجد ترحيبًا بالشباب من مختلف الانتماءات في دربزين.
من مخيم الزعتري في محافظة المفرق، تأتي بشرى علقوفي للمشاركة في تدريبات مؤسسة دربزين. وعلى الرغم من تعب المسافة الطويلة، لا تُخفي إعجابها بمنهجية عمل دربزين، التي تعمل على تطوير مهارات المشاركين، وتعزيز روح التعاون بين مختلف الثقافات والمكونات المشاركة.
بعد دقائق قليلة، يلتحق بهم إسلام الشاذلي، الذي يُنهي عمله في ساعات متأخرة من الليل، ويستيقظ مبكرًا للالتحاق بتدريبات مؤسسات دربزين. وُلد إسلام لأم أردنية وأب مصري، وقد شجعته بيئة التنوع والتكافل في دربزين على الاستمرار في المشاركة، حتى أصبح الآن متطوعًا في قسم الإعلام داخل دربزين، وعضوًا في المنصة العالمية للشباب.
تأسست مؤسسة دربزين للتنمية البشرية عام 2012 كمؤسسة شبابية مستقلة، أطلقها مجموعة من الشابات والشباب الأردنيين، بهدف تمكين الشباب، وتعزيز مشاركتهم في الحياة العامة والسياسية والمجتمعية، من خلال خلق مساحاتٍ آمنةٍ للتعبير، والتعلُّم، والعمل المشترك.
تقول المديرة العامة لمؤسسة دربزين، روند الدسة، إن دربزين تؤمن، في صميم فلسفتها، بأن التماسك المجتمعي والتنوع هما أساس أي عملية تنموية عادلة ومستدامة، وتعمل على دمج هذه القيم في جميع مراحل عملها، من خلال ضمان تمثيل عادل وشامل داخل الفريق والفئة المستهدفة، وتعتمد سياسات شمولية تضمن احترام مختلف الهويات الجندرية، والخلفيات الاجتماعية، والدينية، والجغرافية.
وترى الدسة أن مشاركة حنين، وأكرم، وبشرى، وإسلام في أنشطة دربزين، قد منح المؤسسة تنوعًا وفهمًا أعمق لاحتياجات فئات غالبًا ما تكون مهمشة، وساعد على تصميم تدخلات مجتمعية أكثر عدالةً واستجابةً.
تُعدّ مؤسسة “دربزين” واحدة من آلاف الجمعيات النشطة في الأردن، التي تسهم في تمكين فئات مختلفة من المجتمع. وتشير ورقة موقف صادرة عن التحالف الوطني الأردني للمنظمات غير الحكومية (جوناف) إلى أن عدد مؤسسات المجتمع المدني في الأردن يبلغ حوالي 6612 جمعية، إضافةً إلى 1500 جمعية تعاونية، و1400 شركة غير ربحية، و250 فرعًا لمنظمات أجنبية.
عدد مؤسسات المجتمع المدني في الأردن
دربزين: الحوار وبناء جسور التفاهم
أطلقت دربزين عام 2021 مشروع المساحة الشبابية الدامجة “مساحة شدة”، وبحسب الدسة، فإن المشروع هدف إلى توفير مساحةٍ يقودها الشباب، وتعمل على توفير بيئةٍ آمنةٍ وشاملة لمختلف الشرائح المجتمعية، وتُقدَّم فيها حوارات وفعاليات فنية وثقافية، مع التركيز على دعم الحركات الشبابية والمبادرات المجتمعية.
مقر مساحة شدة
وفي إطار جهودها في بناء السلم المجتمعي، نفذت دربزين مشروع “نحكي عنا”، وتشير الدسة إلى أن المشروع عمل على تنفيذ حوارات مفتوحة يقودها الشباب داخل المناطق المهمشة، لمناقشة قضايا الهوية والانتماء والتعدد الثقافي والديني، باستخدام منهجية تُشجّع على احترام الآراء المختلفة، وتعزّز من روح التماسك والانفتاح.
أدّى التنوع داخل دربزين إلى ابتكار مشاريع إبداعية تستجيب لقضايا الشباب واهتماماتهم، وهذا ما كان في مشروع الإعلام والتعبير الفني للشباب، الذي مكّنهم من التعبير عن تجاربهم وقضاياهم من خلال إنتاج أفلامٍ قصيرة، بهدف استخدام هذه الإنتاجات لتعزيز التفاهم والتضامن في المجتمعات المحلية، بحسب الدسة.
برامج مجتمعية لتعزيز التماسك وتمثيل التنوع
ضمن الجهود المتواصلة لتعزيز التماسك الاجتماعي، تعمل شبكة “نايا” المجتمعية على تصميم وتنفيذ برامج تُركّز على الحوار والمشاركة الفاعلة، لا سيما في المناطق المهمشة. وتوضح المديرة التنفيذية، آيات شاويش، أن الشبكة تعتمد نهجًا تشاركيًا يُتيح للشباب والنساء التعبير عن أنفسهم في بيئاتٍ آمنة، مع التأكيد على دمج مبادئ التعددية واحترام التنوع في جميع مراحل العمل.
وفي السياق ذاته، تشير شاويش إلى أن مشروع “مسارات بديلة”، الذي نفذته “نايا” مؤخرًا بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية ومحكمة الأحداث، سعى إلى حماية الأطفال المعرّضين للخطر عبر ربطهم بخدمات الدعم المجتمعي، في إطار التزام الشبكة بتعزيز الشمولية والتماسك.
جانب من الفعاليات التي تنفذها شبكة نايا المجتمعية
من جهته، يؤكد المدير التنفيذي لمؤسسة النسيج للتنمية المستدامة، رفعت فريحات، أن المؤسسة تعمل على تمثيل مختلف مكونات المجتمع في مشاريعها، عبر أنشطة تُعنى بالتنوع والحوار. ويبرز من بين هذه المبادرات مشروع “ثقافتي حواري”، الذي درّب الشباب على مهارات الاتصال والحوار، وربطهم بجذورهم الثقافية من خلال زيارات تراثية وفواصل حوارية، وثقت لاحقًا في فيديوهات تسلط الضوء على ثراء الموروث الثقافي في المجتمع الأردني.
فعاليات مشروع “ثقافتي حواري” في مؤسسة نسيج
من خلال مشاركتها في مشروع “سفراء الحوار”، تصف سوسن مطر تجربتها في العمل الميداني مع المؤسسات وزيارة مختلف المكونات المجتمعية بأنها محطة تحوُّل عميقة في رؤيتها للمجتمع. تقول سوسن: “تعلّمت أن أرى الإنسان قبل هويته، وأن أستمع إلى القصة قبل إطلاق الأحكام”، مشيرةً إلى أن هذا التمرين العملي على فهم الآخر قد رسّخ في داخلها مفاهيم التنوع والاختلاف كقيمة إنسانية.
تفتخر سوسن بمشاركتها في مبادرة “الحوار مع الأديان”، التي أتاحت لها تدريب شباب من خلفيات دينية متعددة، وتسرد قصة شابة شاركت في المبادرة بعد أن عانت من الإقصاء بسبب هويتها الدينية. في البداية، كانت الفتاة تشعر بالعزلة وتفتقر إلى الحافز للتفاعل، لكن الدعم الذي تلقّته عبر الجلسات الحوارية، ومهارات التواصل والمناصرة، ساعدها على استعادة ثقتها. لاحقًا، أصبحت مسؤولة مشاريع في إحدى المنظمات الدولية، وتروي تجربتها اليوم باعتبارها نقطة تحوُّل في حياتها.
الجلسات الحوارية التي قدّمتها سوسن في مشروع “سفراء الحوار”
الأمن الرقمي والمجتمع المدني
منذ تأسيسه عام 2018، اختار مركز “نحن ننهض للتنمية المستدامة” أن يُركّز جهوده في ميدان الإعلام الرقمي، بهدف تعزيز الحقوق الرقمية لجميع مستخدمي الإنترنت في الأردن، وضمان وصولهم إلى فضاءٍ رقميٍّ آمنٍ ومستدام. ويؤكد المدير العام للمركز، عامر أبو دلو، أن جوهر هذا التوجّه يكمن في تمكين الأفراد من التعبير عن أنفسهم بحرية، مع حماية خصوصيتهم الرقمية.
ويشير أبو دلو إلى أن أحد أبرز التحديات التي تواجه المجتمع الأردني اليوم يتمثل في تصاعد خطاب الكراهية على المنصات الرقمية، والذي لا يقتصر تأثيره على العالم الافتراضي فحسب، بل يمتد ليأخذ أشكالًا من العنف والتمييز على أرض الواقع، مهددًا بذلك التماسك المجتمعي واحترام التعددية والتنوع.
في مواجهة هذه الظاهرة، أنشأ المركز قسمًا متخصصًا لرصد ومتابعة خطاب الكراهية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتضمين النتائج في دراسات اجتماعية دورية تُرفع إلى الجهات المعنية وصنّاع القرار. كما أطلق المركز عددًا من المشاريع الهادفة إلى رفع الوعي المجتمعي حول آثار هذا الخطاب، إلى جانب بناء قدرات مؤسسات المجتمع المدني لتطوير وتنفيذ برامج تدعم الحوار والتسامح، وتُسهم في خلق بيئةٍ أكثر أمنًا وشمولًا في الفضاء الرقمي.
تنفيذ مركز “نحن ننهض” لمشروع شبكة “أصوات السلام”
آفاق واعدة: المجتمع المدني كقوة دافعة للتماسك والعدالة
بين المبادرات الميدانية، وشهادات الشباب، وأصوات العاملين في مؤسسات المجتمع المدني، تتضح ملامح مشهد اجتماعي يتشكّل على أسس أكثر شمولًا وعدالة. تؤكد الدكتورة في علم الاجتماع، فادية الإبراهيم، أن مؤسسات المجتمع المدني أسهمت بفاعلية في بناء جسور الثقة بين الأفراد، وفي الحد من التمييز والعنصرية، لا سيما في أوساط الفئات المهمشة مثل الأشخاص ذوي الإعاقة، والنساء، والأطفال في المناطق المحرومة من الفرص.
وتُرجع الإبراهيم نجاح هذه المؤسسات في تعزيز التماسك الاجتماعي إلى تركيزها على القضايا الإنسانية، وسعيها لتوفير فرص متكافئة في التعليم، والتدريب، والرعاية، ما أسهم في ترسيخ شعور الأفراد بقيمتهم، وخلق حالة من الانتماء المتبادل، انعكست على مستوى التفاعل المجتمعي.
من جهته، يرى الباحث في الفلسفة الاجتماعية، يزن الحراحشة، أن عمل مؤسسات المجتمع المدني يتجاوز الحدود الضيقة للانتماءات العرقية أو العائلية، حيث يقوم على قضايا وقيم مشتركة، ويُنتج علاقات اجتماعية جديدة، أكثر انفتاحًا وتعددًا. ويشير إلى أن هذه المؤسسات ساهمت في تفكيك رواسب التعصّب والجهل، وأرست ثقافة الحوار والتعايش بين مكونات المجتمع المختلفة.
أما المستشار في حقوق الإنسان، الدكتور رياض صبح، فيسلّط الضوء على الدور الوقائي الذي لعبته المؤسسات في مواجهة تصاعد خطاب الكراهية، مشيرًا إلى أن الكثير من المبادرات ساهمت في حماية المجتمع من الانزلاق نحو حالة من الانقسام العنيف، خصوصًا في ظل تفاقم الخطابات الطائفية والعنصرية على المنصات الرقمية.
وفي السياق ذاته، يشير المدير العام لمركز التمكين المجتمعي، الدكتور زياد النجار، إلى أن المؤسسات ساهمت بشكل ملموس في تعزيز ثقافة المواطنة وحقوق الإنسان، لا سيما في المناطق المهمشة والمتنوعة ديموغرافيًا. ويرى النجار أن هذه الجهود ساعدت في ترسيخ قيم التعددية والمساواة، من خلال برامج استهدفت التمييز القائم على النوع الاجتماعي أو الأصول الثقافية، إلى جانب تمكين الشباب من الانخراط في العمل العام والمشاركة في صنع القرار، ما خلق شعورًا بالمسؤولية والانتماء الجماعي.
التنوّع كركيزة للهوية الوطنية
وسط كل هذه المبادرات والتجارب الفردية والمؤسسية، يبقى السياق الأوسع للتعددية في الأردن حاضرًا في خلفية المشهد. يؤكد الباحث والمدرّب في التمكين السياسي، فارس شديفات، أن المجتمع الأردني يقوم على نسيجٍ متداخلٍ ومتجذّرٍ من القوى الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية، جعل من التنوّع عنصر قوة لا تهديد، وركيزةً أساسيةً في تكوين الهوية الوطنية.
ويشير شديفات إلى أن قدرة الأردن على استيعاب التنوّع، وتحويله إلى مصدر تماسك وطني، لم تأتِ من فراغ، بل من تاريخ طويل من التعايش، بدأ منذ القرن الثامن عشر مع موجات الهجرة الأولى من الشركس والشيشان والأرمن، وصولًا إلى موجات الهجرة العربية في بدايات القرن العشرين، ثم اللجوء الفلسطيني على مراحل متعددة، وتوافد مجموعات من التركمان، والسريان، والكلدان، والأقباط، والأفغان، والبخاريين، والإيرانيين، والأكراد، والأفارقة.
ويشكّل هذا الخليط، الذي يضم مسلمين سُنّة وشيعة، وخمس عشرة طائفة مسيحية، إلى جانب الدروز والبهائيين، صورة حيّة لتعدّدية متجذّرة في المجتمع الأردني، ومرجعًا مهمًا لفهم قدرة مؤسسات المجتمع المدني على مخاطبة كل هذه الفئات ضمن برامجها، والعمل على تعزيز التماسك، رغم الفروقات الدينية والثقافية والاجتماعية.
(مكونات المجتمع الأردني، الباحث: فارس شديفات)
التعددية والتماسك في المشروع الوطني
في موازاة جهود مؤسسات المجتمع المدني، تلعب الحكومة الأردنية دورًا محوريًا في تعزيز التماسك الاجتماعي واحترام التعددية، من خلال شراكاتٍ استراتيجيةٍ مع هذه المؤسسات، ودعم البرامج والمشاريع التي تستهدف تعزيز السلم المجتمعي والمشاركة السياسية والمدنية لكافة مكونات المجتمع.
وتنص الأوراق النقاشية الملكية بوضوح على أهمية التعايش والتكافل الاجتماعي، حيث أشار جلالة الملك عبد الله الثاني في الورقة النقاشية السادسة إلى أن المجتمعات العربية تتكوّن من “منظومة معقّدة من الانتماءات الدينية والمذهبية والعرقية والقبلية”، معتبرًا أن هذا التنوع يجب أن يكون “مصدرًا للازدهار الثقافي والاجتماعي، والتعدد السياسي، ورافدًا للاقتصاد”.
على الصعيد الدستوري، يُلزم الدستور الأردني الدولة بالحفاظ على السلم الاجتماعي، ويدعو إلى تعزيز قيم المواطنة والتسامح وسيادة القانون، وحماية الحريات الدينية، بما يرسّخ أسس الدولة المدنية ويؤكّد المساواة بين المواطنين.
من جهة أخرى، تلعب المؤسسات الرسمية دورًا تنفيذيًا في دعم هذه المبادئ؛ إذ أُنشئت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عام 1956 (التنمية الاجتماعية حاليًا) بهدف تنسيق الخدمات الاجتماعية وتعزيز ثقافة التكافل، ونص قانونها المعدّل لعام 2024 على الدور المحوري للوزارة في نشر الممارسات الاجتماعية الفضلى، والحد من الظواهر السلبية.
وفي مجال حماية التراث والتنوع الثقافي، أنشأت وزارة الثقافة مديرية خاصة بالتراث غير المادي، تُعنى بتوثيق الممارسات الثقافية والطقوس والعادات المجتمعية. كما التزم الأردن بسلسلة من الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية لاهاي لحماية الملكية الثقافية في حالة النزاع المسلح (1954)، واتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي (2006)، واتفاقية حماية وتعزيز أشكال التعبير الثقافي (2007)، إلى جانب الاتفاقية العربية لحماية المأثورات الشعبية (2010).
الاتفاقيات الدولية والعربية التي وقع عليها الأردن لتعزيز التنوع والتعددية
تحديات مستمرة وقيود مؤسسية
رغم الجهود المبذولة من مؤسسات المجتمع المدني والدولة في تعزيز التماسك المجتمعي واحترام التعددية، إلا أن الطريق لا يخلو من التحديات. دراسة أعدّتها الدكتورة في الإعلام مرسيل الجوينات بعنوان “التنوع وأثره على النسيج الاجتماعي والمواطنة في الأردن”، خلُصت إلى وجود بعض المنابر المتعصّبة والتصورات السلبية التي تنظر إلى الآخر كـ”دخيل”، وهو ما ينعكس سلبًا على الانسجام المجتمعي ويعزّز الانقسام بدلًا من التقارب.
وتوصي الدراسة بأهمية الحوار بين الأديان والطوائف داخل الأردن، إضافةً إلى حوار داخلي بين مكونات المجتمع المختلفة، بهدف ترسيخ قيم التفاهم والشراكة وتعزيز ثقافة الاختلاف الإيجابي.
في السياق ذاته، يحذّر صبح من تنامي بعض السلوكيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تتحول اختلافات الرأي في أحيان كثيرة إلى تخوين وازدراء وهجوم، تُمارَس أحيانًا تحت شعارات مثل “الوحدة الوطنية” أو “الدفاع عن الفضيلة”، ما يعكس هشاشة في تقبّل الآخر لدى فئة محدودة داخل المجتمع.
أما شديفات، فيلفت إلى وجود تحدياتٍ قانونيةٍ وبنيويةٍ تعيق التمثيل المتوازن للأقليات الثقافية والعرقية، خاصةً فيما يتعلّق بتطبيق القوانين على أرض الواقع، وتأثيرها على المشاركة السياسية وصياغة السياسات العامة.
على مستوى المؤسسات، تشير منظمة النهضة العربية “أرض” إلى أن 78% من مؤسسات المجتمع المدني تعاني من قيود مالية تحول دون تنفيذ برامجها بفاعلية، في المناطق التي تعاني من تهميش جغرافي، وضعف الوعي بقضايا التماسك والوقاية من التطرف.
من جهته، أعرب تحالف “جوناف” عن قلقه من التضييق المتزايد على عمل مؤسسات المجتمع المدني، لا سيما ما يتعلق بتغيّر آليات الموافقة على التمويل الأجنبي، وتبدّل الجهات المختصة بمتابعة الطلبات، ما يعرقل الاستقرار المؤسسي ويضعف قدرة المنظمات على الاستجابة للاحتياجات المجتمعية المتزايدة.
ولمواجهة هذه التحديات المتنامية التي تعرقل جهود مؤسسات المجتمع المدني في دعم التماسك والتعددية، يوصي الحراحشة بضرورة وجود تخصصية في المؤسسات، وفهم عميق للمشاريع التي تنفذها، وتوسيع شرائح الفئة المستهدفة في المشاريع. وتدعو الإبراهيم إلى تكثيف الأنشطة والفعاليات التي تسلط الضوء على التنوع الثقافي، وتعزيز فهم وتقدير الآخر وتقبله، والعمل على نشر التسامح من خلال التوعية بمخاطر التمييز على المجتمع.
التحديات والقيود التي تواجه مؤسسات المجتمع المدني
نحو الطريق
تُنهي مؤسسة دربزين فعاليات برامجها التدريبية مع حلول ساعات المساء، لا يغادر المشاركين بشكل مباشر، بل يفضلون قضاء بعض الوقت في “مساحة شدة”، حيث تبدأ رحلة من الحوارات والأحاديث الممتعة والمتنوعة، والتي تستمر حتى وقتٍ متأخرٍ.
مع اقتراب غروب الشمس تبدأ حركة المغادرة الهادئة، تتجه أنظار حنين وأكرم وبشرى وإسلام نحو رحلة البحث عن أقرب حافلة تقِلُّهُم إلى منازلهم، تفرقهم وسائل النقل عامة، لكنها لا تفرق إيمانهم بمهمتهم الرائدة في إثراء مجتمعنا، وسعيهم الدؤوب لصون تنوعنا وتعددنا، حتى لا نضطر لرفع الراية البيضاء في القريب العاجل!