فلسفة “الفقيه الأعلى”؛ دراسة في ماهية العارف الواصل عند محمود حيدر
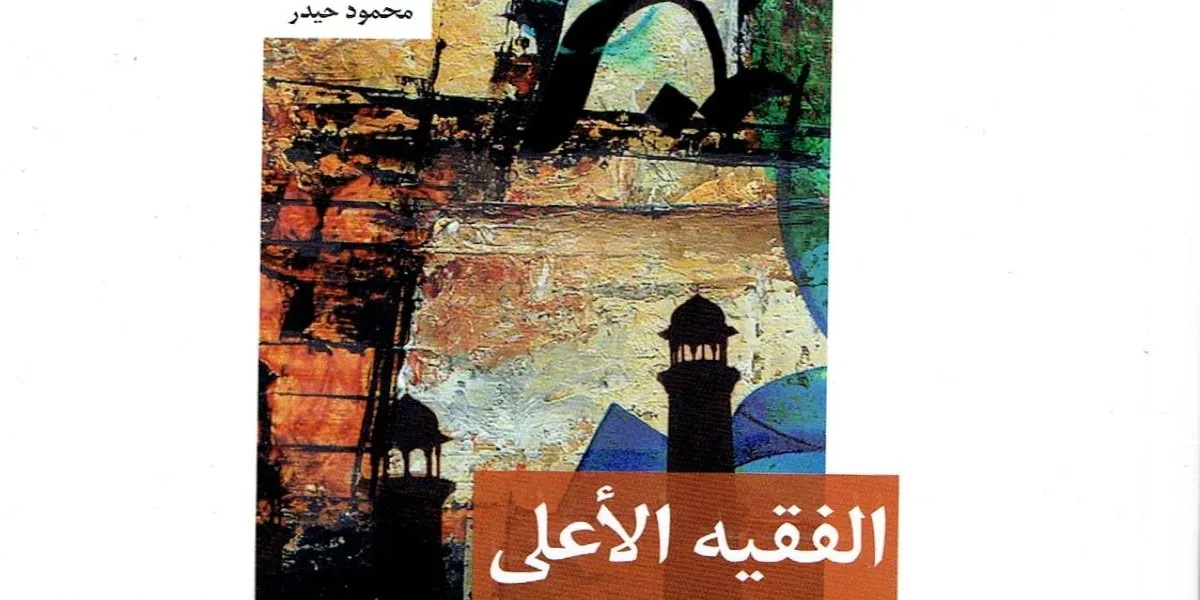
الحديث عن “الذاتي والموضوعي في التجربة الصوفية” يشكل محطة معرفية وإشكالية في مباحث الإلهيات المعاصرة. ولعل أول ما يتبادر إلى التصور في هذا المجال، هو تمييز الحدود بين التصوف كظاهرة سوسيو-تاريخية، والتجربة الشخصية بما هي اختبار روحي للفرد. وقد ارتأيت في هذا المجال أن أقارب الاختبار الفردي كتجربة ذاتية في سيرة الأولياء، والموضوعي كما يظهر في الاجتماع الإنساني والحضاري. من أجل ذلك تأتي هذه الدراسة لتضيء على صلات الوصل بين مقام الولي بوصفه الذات العارفة بالله، وعالم الإنسان بوصفه حقلًا يختبر فيه الولي رسالته الإلهية. وتأسيسًا على هذه الفرضية سيكون محور دراستي محاولة استقرائية لأطروحات المفكر العربي من لبنان محمود حيدر، والتي وردت في عدد من أعماله الفلسفية والعرفانية، ومنها على الأخص في كتابه: “الفقيه الأعلى – واحدية الشرع والكشف في مهمة العارف الخاتم”. ومخطوطته التي هي قيد النشر “العرفان في مقام التدبير السياسي”، فضلًا عن عدد من المحاضرات التي ألقاها في هذا الشأن.
في كتابه “الفقيه الأعلى” نرانا أمام أطروحة نادرة في بحوث العرفان النظري، حيث سعى المؤلف إلى بيان المنزلة التي يتبوأها الولي كوسيط إلهي لتدبير الاجتماع الإنساني وإصلاح عيوبه. إذ أن مهمة الولي هي القيام بدورٍ خلاصي وحضاري بعد أن يتهيّأ إلى هذه المهمة بتزكية نفسه والسلوك في معارج المعرفة.
في إطار اشتغاله على ، يعيد البروفسور حيدر سبك ما اختَطَّه العرفاء الكبار حول مفهوم ختم الـولايـة الخاتمة، فيعالج هذا المفهوم الدقيق والشاق متنقلًا بقارئه إلى حيث تسكن النفس مع العارف القابض على الحقيقة، فتنظر من مكانك إلـى كيفية التحول والترقِّي في المقامات الموصلة إلى معرفة الله. وكل ذلك من أجل تظهير مبدأ التكامل الخلّاق بين الشريعة الظاهرة حقائقها الداخلية المستترة. وعلى هذا التأسيس سنكون مع أطروحة “الفقيه الأعلى” أمام تأصيل معمّق لجدلية الوصل الوطيد بين غاية الولي العارف والعالم الموضوعي بوصفه حقلًا فسيحًا لأداء مهمته الكبرى. يفتتح المؤلف كتابه بتعريف الولي العارف بأنه العبد السالك في مقامات العبدانية والمتدرِّج في العرفان من معرفة دين الله إلى معرفة الله. وهو بذلك يحقق الشرط الأساس للعروج والترّقي إلى مقام الولاية. فالولي الخاتم بحسب الرؤية التأويلية للمؤلف هو حلقة الوصل بين الحق والخلق، في سياق تكليفه الإلهي بعد اختتام النبوة التشريعية.
ولأجل بيان الأركان الأساسية في أطروحته حول الفقيه الأعلى وماهيته ودوره وغايته ارتأينا أن نقارب الموضوع ضمن الترتيبات المنهجية التالية:
أولًا: في تعريف العرفان والتصوف
من أجل الدخول إلى تأهيل نظرية معرفة حول الفقيه الأعلى ودوره في فضاء التصوف على المستويين النظري والعملي، سنلاحظ أن أعمال حيدر العرفانية أدخلت مقاربات مستحدثة حول المصطلح الصوفي. وخصوصًا لجهة التمييز الدقيق بين التصوف والعرفان. فالعرفان يدل – حسب تعريف المؤلف- على اعتراف العارف وإقراره بجميل ما جاء به الحقّ على الخلق. إذ لا يمكن – تعريفًا أو اصطلاحًا ومفهومًا – لمن لم يُقِرَّ ظاهرًا وباطنًا بجميل الحقّ أن يكون عارفًا. وهذا الإقرار هو إقرارٌ معرفيّ وقلبي، تحصّل له من بعد سيرٍ وسلوكٍ وقولٍ وعمل. أما التصوّف فهو – كما يقول حيدر – مبتدأ السير نحو الألوهيّة. أو كما يقال في الأثر الصوفي، هو سيرورة من الصفة بالصفة إلى الاسم. وهذه الجدليّة التي قام عليها التصوّف هي في جوهرها مرتبة عليا من مراتب العرفان، بحيث تستقيم هذه الواحديّة على قاعدة أن كلّ عارفٍ متصوّف، وليس بالضرورة أن يكون كل متصوِّفٍ عارفاً[1]. ولقد بيَّن ابن سبعين[2] هذه الواحدية بين المتصوف والعارف لمَّا قدَّم وصفًا للصوفي الجامع بين المعرفة بالله والعمل في سبيله، فرأى أن الصوفي الكامل هو الذي يحيط بالمنقول، والمعقول، والأحوال، والمواهب، والاتصاف، والإدراك الروحاني بجميع أنواعه، والجسماني بجميع أنواعه، وكذلك ما هو مشترك بين الروحاني والجسماني. والصوفي الكامل الطبيعي الذي يطلق عليه صوفي، هو الذي يرد عليه التصوف بمجرد الرحمة والموهبة والفيض حتى لا يكون عنده من عالم الشهادة بما ينزل إليه؛ وهذا هو الذي يستحق اسم المتصوِّف لا غير[3].
وعليه، فإنا لو وجدنا تداخلًا بينهما في مكان من الأمكنة، فالسبب يعود إلى التشابه الواقع بينهما من ناحية المصطلح. فمفردتا “التصوف” و”العرفان” في النصوص التاريخية العرفانية والصوفية، إما أن تأتيا مترادفتين وتؤدّيان معنى واحدًا – كما يذكر المؤلف- وإما أن يكون بينهما تباين واختلاف. وخلافًا لما جرت عليه التعريفات المجملة لماهية التصوف فقد توسع البروفسور حيدر في تفصيل ماهية العرفان ومبانيه المعرفية. ولذا راح يقيمه ضمن حقلين معرفيين: عملي ونظري.
1. العرفان العملي: هو عبارة عن ذلك القسم الذي يوضح ويبين ارتباط الإنسان ووظائفه وعلاقته بنفسه وبالعالم وبالله. والعرفان في هذا القسم يشبه الأخلاق، أي هو “علم” عملي ولكن بتفاوت سنتحدث عنه فيما بعد. وهذا القسم من العرفان يعرف ويسمّى بعلم “السير والسلوك” كيفية الوصول إلى القمة المنيعة للإنسانية، وهي التوحيد، ومن أين يجب عليه البدء، وما هي المنازل والمراحل التي يجب عليه العمل بها على الترتيب. فالتوحيد الغاية القصوى لسير العارف وسلوكه، ومثل هذا التوحيد يبعد – عن توحيد العوام، وحتى عن توحيد الفلاسفة، الذي يعني أن واجب الوجود واحد لا أكثر. ذلك بأن توحيد العارف يعني أن الموجود الحقيقي منحصر بالله عز وجل، فكل ما هو موجود – سوى الله – ليس إلا “دليلًا” لا “وجودًا”. وفي نظر العرفاء أن الوصول إلى هذه المرحلة، ليس من عمل العقل والفكر، بل هو المجاهدة، والسير والسلوك، وتصفية النفس وتهذيبها. من هذه الرؤية يشبه العرفان علم الأخلاق الذي يبحث في “ما يجب عمله” مع ملاحظة جملة من التفاوتات يوردها المحققون على النحو التالي:
أ . العرفان يبحث في مجال علاقة الإنسان بنفسه وبالعالم وبالله، وعمدة نظره مركوزة في علاقة الإنسان بالله، في حين أن الأنظمة الأخلاقية كافة لا ترى ضرورة للبحث في مسألة علاقة الإنسان بالله، ووحدها فقط الأنظمة الأخلاقية الدينية تجعل من هذا الأمر موضع توجهها وعنايتها.
ب. السير والسلوك العرفاني – كما يبدو من مفهوم هاتين الكلمتين – جار ومتحرك، على خلاف الأخلاق فهي ساكنة، مستقرة.
ج. العناصر الروحية في علم الأخلاق محددة بالمعاني والمفاهيم التي توضحها غالبًا، أما العناصر الروحية العرفانية فهي أوسع بكثير وأشمل[4].
إلى ما تقدم يرى المحقِّقون أن العرفان العملي هو كناية عن “مجموعة من القواعد والقوانين المرتبطة بأعمال القلب التي يؤدي اتباعها للحصول على الكمال النهائي للإنسان (التوحيد أو مقام الفناء ومشاهدة الحق)”. وبناء على هذا التعريف يكون موضوع علم العرفان العملي هو أعمال القلب وحالاته، بما هي موصلة الإنسان إلى الكمال النهائي، وغاية هذا العلم هي الوصول إلى الكمال النهائي للإنسان[5]. ولما كان محور الاهتمام في العرفان العملي، هو الأعمال القلبية والباطنية، كان للقلب، باعتباره أهم ما في الوجود الإنساني، حالات وملكاتُ تأثيرٍ وتأثرٍ وفعلٍ وانفعالٍ مع سائرِ عالم الوجود. وعليه كان الهدف الأساس للعرفان العملي، هداية هذا الفعل والانفعال وتطهير القلب من الأمور التي يُطلق عليها المهلِكات، وتزيينه بحالات وملكات أخرى يُطلق عليها المنجيات، والغاية من ذلك كله هي الوصول بالإنسان الى كماله النهائي. وإذن، فالأساس الذي يقوم عليه العرفان العملي هو كيفية مراقبة القلب لأجل الابتعاد به عن المهلكات وتزيينه بالمنجيات والغرض من ذلك كله وِصالُ الإنسان بالحق تعالى. وذلك يحيلنا إلى ما يطلق عليه في الشريعة (الشرك الخفيِّ)؛ وهو أمر يرتبط بباطن الإنسان وقلبه. لهذا الداعي كان لتعبير القلب ونحوه، كالفؤاد والصدر في الكتاب والسُّنة أهميته الأساسية، إلى جانب مفاهيم نظير الإيمان، والتقوى، والخشوع، والسكينة، والاطمئنان… إلخ. وهي من الحالات والملكات المرتبطة بالأعمال القلبية، وذلك خلافًا لما ذكره بعضهم من أن الإيمان ليس هو المعرفة فقط، بل المعرفة مع التصديق القلبي[6]. أما تسمية العرفان العملي بعلم منازل الآخرة فتعود إلى أن الإنسان متى تبع ما ورد فيه من قوانين، ومشى في طريق السير والسلوك المعنوي، فإنه سوف يتمكن من طيِّ مراتب الآخرة ومنازلها، ومن الصعود إلى مراتب القرب ليصل إلى جنة الرضوان[7].
2. العرفان النظري: ومؤدى تعريفه- بحسب المحقِّقين هو “التعبير عن الحقائق والمعارف التوحيدية، أي الوحدة الشخصية للوجود ولوزمها، التي يصل إليها العارف عن طريق الشهود في آخر مراحله، والتي تحصل بسبب الرياضة والعشق”.ومن خلال هذا التعريف يمكن تحديد نقاط التمايز بين العرفان النظري كعلم من العلوم وبين سائر العلوم، وهي[8]:
أ. موضوع هذا العلم هو التوحيد والحقائق التوحيدية (الوحدة الشخصية للوجود)، ونُعرض هنا عن الدخول في بيان هذا المفهوم تفصيلًا لأننا سوف نُفرد بحثًا مستقلًّا عن الوحدة الشخصية للوجود لاحقًا.
ب. العرفان النظري من حيث المنهج هو من العلوم التي تعتمد منهج (الكشف والشهود). والمنهج الشهودي هو عبارة عن منهج العرفان النظري بشكل عام. ولكن، وكما يظهر من خلال ملاحظة التعريف، فإن المقصود من الشهود هنا هو الشهود العرفاني- بشكل خاص – أي مقام حق اليقين، الذي يؤدي للوصول إلى أعمق ساحات الوجود.
ج. العرفان النظري كعلم هو تعبير عن تلك الحقائق، وليس هو تلك الحقائق نفسها. ولذا تكرر التحذير من الخلط بين الحقيقة التي نصل إليها عن طريق التجربة المعرفية – الشهودية كحقائق عينية مشاهدة من قبل العارف، وبين العرفان النظري كعلم ينقل تلك الحقائق ويعبّر عنها[9].
د. العرفان النظري من وجهة نظر الميتافيزيقا يُعنى بتفسير الوجود، ويبحث في وجود الله والعالم والإنسان، العرفان في هذا القسم أشبه بالفلسفة الإلهية التي تُعنى بتفسير الكون وتوضيحه، وكما للفلسفة الإلهية موضوع ومبادئ ومسائل تقوم بتعريفها، فللعرفان أيضًا موضوع ومسائل ومبادئ يقوم بتعريفها، ولكن الفلسفة في استدلالاتها تعتمد بالطبع على المبادئ والأصول العقلية فحسب، بينما يتخذ العرفان من المبادئ والأصول الكشفية أساسًا في الاستدلال، ثم عند ذلك يوضحها بلسان العقل[10].
ثانيًا: معنى الفقيه الأعلى ودلالاته الاصطلاحية
من المهم القول بداية أن مصطلح الفقيه الأعلى هو مصطلح مبتكر نحته المؤلف ليضاف إلى قاموس المفردات الصوفية. على هذا الأساس سنكون أمام مفهوم مستحدث ينبغي التعامل معه إبستمولوجيًّا في سياق مقارباتنا للنص العرفاني المعاصر. وسنلاحظ أن ما قصد إليه المؤلف من معنى الفقيه الأعلى هو العارف الجامع بين أحكام الشريعة الظاهرة والحقائق التي تنطوي عليها. ذاك يعني أن المؤلف أراد أن يميز العارف عن الفقيه أو المتكلم الذي يعتني بظاهر النصب الديني، لينتهي إلى القول: إن الفقيه الأعلى هو العارف الجامع بين الشريعة والحقيقة في مقابل الفقيه الأدنى الذي يكتفي بالأحكام الظاهرية للشريعة[11].
في مفتتح كتاب “الفقيه الأعلى” يفصح صاحب الأطروحة عما قصده من مسعاه التأويلي فيقول: “ما وجدت من قول وأنا في محضر البحث عن ماهية وهوية ومهمة الولي الخاتم، غير قولي فيه، إنه الفقيه الأعلى. وما رأيت إلى الولاية، بما هي المندرج الثالث في هرم الوجود بعد التوحيد والنبوة إلا أنها الفقه الأعلى. فلقد تراءى له أن لا إثنينية، ولا تضاد، ولا تناظر سلبي بين شريعة وحقيقة وطريقة، بل ثمة وصل لا يقبل الانفصال بين أضلاع وما ذاك إلا لأن الولي العارف بالله يدرك أن مقاصد الوحي مبدؤها واحد وختامُها واحد. كما يدرك أن التكثُّر في طرائق الإيمان والعرفان، أو في سبل الوصول إلى الله، إنما هو عين التوّحد في حكمة الاختلاف. لكن الإنسان الذي استحق الخلافة في الأرض – كما يلاحظ المؤلف- ليس كل من تعرفنا إليه بهيئته العنصرية من سلالة آدم، وإنما المستحقُّ هو الآدمي المفرد الذي عُلِّم الأسماء كلها ليكون بالعلم الملقى إليه من عند الغيب ونعني به الإنسان الكامل. ومن أجل ألّا يبلغ اليأس مبلغه عند سائر الناس في استحالة الوصول إلى الكمال فإن التأويلية “الحيدرية” ستمضي إلى النقطة التي تفسح المجال لكل إنسان أن يتلقى النفحات الربانية ويسير في طريق العرفاء بالله. فها هو يشير إلى أن اللطف الإلهي أودع في كل مخلوق آدمي قابلية العروج إلى الكمال والتعرُّف إليه. وإذا كان تحقق الإنسان الكامل هو بحكم الانتخاب الإلهي لخلفائه من الأنبياء والأوصياء والصديقين والأولياء، فإن عدل الحق ولطفه قد خاطب العالمين بالتكريم، ووعدهم بشرف القربى والهداية. ذلك بأن هداية الوحي شاملة جميع أفراد النوع الإنساني، فلو شاء من شاء من الناس الأخذ بصراط الاستقامة لإجابه الحق وهداه إلى سبيل الكمال[12].
يبيِّن المؤلف في هذا الخصوص أن صفة الإنسان الكامل هي تلك المخصوصة بالولي، وهذا يعني أن الولاية هي حاصل قصد إلهي في التاريخ البشري. وعليه فإنها تتأتى من علم جاد الحق به على الولي ليعلّم الناس ما حظي به من عطاءات الحكمة الإلهية. ولعل أول تلك العطاءات تعليم الأسماء. كما في قوله تعالى: ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاء كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلاَئِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاء هَؤُلاء إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾[البقرة- 31]. والمعني بالأسماء عند العرفاء، لم ينحصر في بيان واحد. بعضهم قال إن المراد بالأسماء هو أسماء الله الحسنى. وبعضهم رأى أنها أسماء الأشياء وحقائقها، وهو ما يعرف بـ “الأعيان الثابتة”، وآخرون قالوا ما لا حصر له في فضاء التأويل. ومهما قيل فإن المآل واحد، إذ العلم التام بحقائق الأسماء المقدسة، لا يُتصور من دون العلم بحقائق المخلوقات ومظاهرها، وذلك فضل من الله يؤتيه. ذلك بأن الولي على هذا الوجه هو المحرك الأساسي لتوصيل معارف الوحي ومقاصد الشريعة إلى أفهام الخلق في الأزمنة المتعاقبة بعد الأنبياء والمرسلين.
في سياق تأصيله لتاريخية مصطلح الولاية الذي يقصده يستحضر المؤلف ما ذهب إليه الرواد الأوائل لفقه التصوف ابتداءً من الحكيم الترمذي وصولًا إلى ابن عربي واللاحقين عليهما. والولي الخاتم في اللغة الصوفية يعود بدءًا إلى الحكيم الترمذي، فهو أول صوفي بيّن معالم الولاية، وقام بإرساء نظرية معرفية تُميّز بين طريقتين لتحصيل مقام الولاية، أولهما طريق الصدق والجهد والعبادة، وثانيهما طريق المنّة والوهب والعبودية، والطريقان يشيران إلى مرتبتين من مراتب الولاية أو مرتبة “ولي حق الله”، وتلك المرتبة يحصّلها بالصدق والتنفيذ الكامل لكل الفروض الداخلية المترتبة عن العهود الإلهية، ومرتبة “ولي الله حقًّا” وينالها المؤمن بالوهب والمنة الإلهية”[13].
وتبعًا لتوصيفه مقام الولاية بأنها الفقه الأعلى، ومقام الولي بـ “الفقيه الأعلى يدخل المؤلف إلى فضاء تأويلي يرتكز إلى ما ورد في الكتاب الإلهي من آيات تسدد ما ذهب إليه.
فالولي بالمعنى الاصطلاحي- كما يورده حيدر في تعيينه لصفات الفقيه الأعلى- هو: هو الذي يصدِّق ما جاء في أم الكتاب. أي الذي آمن وصدَّق كلام الله بالقول والعمل. وهو يدل على الحاكم والمدبر والقائم بالأمر والناصر.
وقد ورد في القرآن الكريم العديد من الآيات التي تشير إلى الأولياء، أولياء الرحمن، منها:
﴿أَلاَ إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ*الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾ (يونس:63-62). ﴿إنَّ وَلِيِّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ﴾ (الأعراف: 196 ). ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ )البقرة:257(.
أما في السنّة النبوية فنجد في الحديث ربطًا موثوقًا بين الأنبياء والأولياء. يقول الرسول الأكرم (ص): “إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ لأُنَاسًا مَا هُمْ بِأَنْبِيَاءَ وَلاَ شُهَدَاءَ يَغْبِطُهُمُ الأَنْبِيَاءُ وَالشُّهَدَاءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِمَكَانِهِمْ مِنَ اللَّهِ، قالوا يا رسول الله من هم، فقال: هم قوم تحابُّوا بروح الله، بغير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها، فوالله إن وجوههم لنور، وإنهم لعلى نور، لا يخافون إذا خاف الناس، ولا يحزنون إذا حزن الناس، وقرأ الآية: ﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّـهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ (يونس:62)”.
يعقِّب الجنيد وهو العارف الكبير على هذه الآية فيقول: “إن من صفة الولي أن لا يكون له خوف، لأن الخوف ترقب مكروه يحل في المستقبل، أو انتظار محبوب يفوت في المستأنف، والولي ابن وقته، ليس له مستقبل فيخاف شيئًا. وكما لا خوف له، لا رجاء له، لأن الرجاء انتظار محبوب يحصل، أو مكروه يكشف، وذلك في الثاني من الوقت. كذلك فإن الولي لا يحزن، لأن الحزن من حزونة الوقت. فمن كان في ضياء الرضا وروضة الموافقة أين يكون له حزن”[14].
وفي سياق تأصيله للمفهوم يورد البروفسور حيدر ما جاء في بعض كتب الصوفية وعرفاء المسلمين، تعريفات للفقيه الأعلى، فيبيِّن أنه المحفوظ من الله. أي الذي يتولى الله أمره وحفظه من العصيان، ولم يخله ونفسه بالخذلان حتى يبلغه في الكمال مبلغ الرجال، قال تعالى: ﴿وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ﴾ (الأعراف: 199)”[15].
وعند الشيخ الأكبر ابن عربي: “هم الذين تولاهم الله بنصرته في مقام مجاهدتهم الأعداء الأربعة الهوى والنفس والدنيا والشيطان”[16]. وهو أيضًا: “قيام العبد بالحق عند الفناء عن نفسه، وذلك بتولي الحق إياه حتى يبلغه غاية القرب والتمكن”[17].
على هذا الوجه من صفات الولي العارف يتشكّل فَهْمُنا للحثِّ الإلهي على ضرورة تغيير الواقع والقيام بمراجعة معرفية يؤسسها بالضرورة العارف الواصل. أي الذي يستأنف العمل النبوي لجهة تبليغ الأحكام من خلال ربطها بمكارم الأخلاق.
فإذا كانت مهمة الأنبياء تتمثل في تبليغ القانون الإلهي مباشرة إلى الخلق فإن مهمة العارف الولي الشرح والتفصيل، وبهذا يكون كل نبي ولي ولا يكون كل ولي نبي، وعلى هذا النحو يصبح الولي العارف حاملًا للأمانة الملقاة على النبي الخاتم، الأمانة المتمثلة في تدبير شؤون الناس وإخراجهم من الجاهلية إلى المعرفة، فيعلم الناس ما حضي به من جود الأسماء، تأسيًا بقوله صلى الله عليه وسلم “يجعل الله على رأس كل قرن وليًّا يجدّد به دينه”؛ بمعنى يتكلف بتعليم الأمة وترتيبها وهدايتها إلى الحضرة الإلهية.
ثالثًا: الأركان المؤسِّسة للمفهوم
تبعًا لما ذُكر تكون الولاية – بحسب البروفسور حيدر – عنصرًا ذاتيًّا من عناصر ختم النبوة. فالولي هو خليفة النبي، ومبيّن الشريعة من بعده، وهو الذي يتولّى صيرورة الدين الخاتم بعد ارتحال نبيّه إلى غاياته ومقاصده. بل إنه يؤكد بتبنِّيه لأحكام الدين، استمرار الصلة بعالم الغيب في عهد انقضاء النبوة. ولأجل ذلك تحظى الوراثة النبوية التي للولي الخاتم بدور حلقة الوصل بين الحق والخلق، ولذا فمن الضروري أن تدخل مهمته مقام الخاتمية من حيث تفرُّعها إلى ثلاثة أركان:
1. ركن القيادة: مثلما النبي يتولى الإمساك بزمام الأمور وقيادة الأمة في حياته، فإن الولي يخلفه في تحمل أعباء ذلك كله إما ظاهرًا وإما باطنًا.
2 . ركن التبيين: النبي مُتلقٍّ للوحي، ومبلّغ للرسالة ومفسر لها في آن واحد؛ ومع ختم النبوة ينقطع التبليغ الوحياني. فالولي إثر انقطاع التبليغ هو من يتولى مهمة تفسير الوحي وتبيينه، فيعمل باعتباره الشخص الذي يمتلك علمًا ربانيًّا على تلبية متطلبات الإنسانية من خلال تبيينه لأحكام الدين.
3 . ركن الولاية: الولي العارف الكامل الذي نال باللَّمح الباطني الذاتي إجازة الخاتمية، وبلغ من العلم الإلهي قدر سعته وهمَّته واستعداده، وبات يملك نحوًا من الولاية على القلوب والنفوس والأشياء، هو الدليل على عدم انقطاع اتصال الإنسان بعالم الغيب بعد النبي[18].
والتأسيس الرحماني للولي بعامة، والولي الخاتم بصفة مخصوصة، حاضر بالمجمل في الخطاب الإلهي: ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ﴾2. في التفسير أن الولاية هي لله بالأصالة، وللرسول وللمؤمنين بالتبع. فيكون التقدير كما في التفسير: ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ﴾. ليكون في الكلام أصل وتبع. ولا يخفى على المتأمل أن المآل واحد”3.
ولما كانت الولاية واحدة ذات مراتب وفقًا لمبدأ التراتب الطولي القرآني، فلسوف تكتسب منازلها المتعددة صفة الأصالة المُفاضة عليها من لدن الولي الأعظم تعالى4.
وتبعًا للإخبار الإلهي في ما جاءت به آية الولاية، سنكون أمام هرم وجودي يتوقف على فهمه وإدراك معانيه، عرفان جميل صنع الله ولطفه بخلقه. ومن هذا النحو تتمظهر منازل الولاية على ثلاث مراتب وجودية هي: ولاية الله – ولاية النبي – ولاية الولي.
المرتبة الأولى: ولاية الله: وهي الولاية الحقيقية المطلقة، وتكون بالأصالة للولي الواحد الأحد على العالمين. وفي القرآن المجيد من الآيات البيّنات ما يشير إلى الأصالة الإلهية لولاية الله. وأن الله تعالى سمّى ذاته المقدسة بالولي لأنه المهيمن بأسمائه وصفاته على كل شيء كما في قوله تعالى: ﴿مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا﴾5.
المرتبة الثانية: ولاية النبي: وهي من الله. أي أنها امتداد لولايته تعالى ومن أمره. ولأن ولايته تعالى محيطة بكل شيء، ومدبّرة لنظام الخلق، وبسُنَنِها تنتظم هندسة الكون، فولاية النبي الخاتم (ص) المستمدة من الرحمانية هي – بهذه الصفة الاستمدادية – ولاية للعالمين. ولكونها كذلك، فهي ظهورٌ لمشيئة الله وإرادته في عالم الإنسان: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾1. فهي إذن رسالة لجميع الناس وولاية الرسول حاكمة على العالمين، ومظهرِةٌ للدين القيّم. كما في قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾2.
وقد جاء في أعمال العرفاء من الصوفية تأصيل3 للصلة الامتدادية الطولية بين ولايته تعالى، وولاية رسوله. منها: أن أولى المراتب الذاتية مرتبة (الإطلاق واللاّتعيّن). وهي مرتبة غيبُ غيبِ ذات الذات الإلهية أي(الصمدية). وثانية المراتب، مرتبة التعيّن الأول الذاتي الأحدي الجمعي الذي به تعيّنت العين لعينها، وتحققت الحقيقة الذاتية لذاتها، وحقيقتها التي هي عين الذاتية. وتسمّى حقيقة الحقائق الكبرى عندنا. ولهذا يكون التعين الأول على (ثلاثة أوجه): الأحدية من وجه، والوترية من وجه. والشفعية من وجه4:
-أما شفعيته تعالى فلأنه ـ حسب الشيخ الأكبر – شفع مرتبة الغيب الذاتي الإطلاقي بتعينه وتميزه عن اللاَّتعين.
– وأما وتريتُه جل شأنه، فلأنه امتاز بنفس التعيّن عن اللاّتعيّن، الذي نسبته إلى العين كنسبة التعيّْن سواء.
-وأما أحديّتُه فلكون هذا التعين عين المتعين لا زائد عليه إلا في تعقلنا، فإنه تعيّن الذات بذاتية الذات، فلا إثنينية ولا كثرة، وإذن فإن لها الأحدية. فالأحدية والوترية والشفعية مستندها إلى هذا التعيّن الأول الذاتي العيني، وللعين الجمع بين التعين واللاَّتعيّن، وبين القيد والإطلاق، وللتعين الأول الجمع بين الشفعية والوترية والأحدية كما مرّ5.
وللأوجه الثلاثة التي مرَّت شرح إضافي يورده البروفسور حيدر على لسان ابن عربي:
يبيّن الشيخ الأكبر في هذا الصدد، أن الحقيقة المحمدية تظهر في مجموع هذه المراتب الثلاث لتتخذ تعيّنها البرزخي الجمعي بين المتناهي واللاّمتناهي، وبين الإطلاق والتعيّن. ثم إنها بما هي عليه من هذا التعيّن البرزخي، سيكون لهذه الحقيقة أن تحوز على الفردية الأولى؛ ومنها – بعدئذٍ – تتفرع الفرديات في جميع المراتب المعنوية والروحانية والإلهية والكونية وغيرها. ومن هنا كان إسناد هذه الحكمة للكلمة الكاملة المحمدية. ومقالة ابن عربي بيّنة في هذا التأويل كما يصرح في “الفصوص”: “إنما كانت حكمة فردية، لأنه (ص) أكمل موجود في هذا النوع الإنساني، ولهذا بُدِئ به الأمر وخُتم، فكان نبيًّا وآدم بين الماء والطين، ثم كان بنشأته العنصرية خاتم النبيين وأول الأفراد الثلاثة”1.
ولأن للحكمة المحمدية فرادتها من حيث منزلتها الإلهية في الابتداء والاختتام، يشير ابن عربي إلى أن الفردية له (أي للنبي محمد (ص) من كونه – كما مرّ – أكمل النوع الإنساني الكمالي، ذلك لأن الفردية مخصوصة بالإنسان الكامل. ولذلك فإن له الفردية الحقيقية الغيبية العينية المشار إليها من حيث حقيقته في عالم المعاني.. ثم كان بنشأته الروحانية نبيًّا مبعوثًا إلى كافة الأرواح النبوية، ثم بنشأته العنصرية كان خاتم النبيين، فحصلت الفردية الأولى، وكانت له الفردية الجامعة بين البدء والفاتح والختام الواضح، ونبوة روحانيته بالكمال الراجح2.
المرتبة الثالثة: ولاية الولي: فإنها متصلة بالولايتين الأولى والثانية. بها تتجلى الحقيقة المحمدية في عالمَيْ الغيب والواقع، ومن خلالها يكشف الحق عن عنايته بشؤون الخلق. ذلك بأن أولياءه هم المكلَّفون بالمعاينة والمتابعة وحفظ الكتاب. وولاية الولي مصرّح عنها في القرآن الكريم من خلال وجود شاهد على المسلمين يتلوه رسول الله: ﴿أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ﴾3.
ومعنى “يتلوه” أي يخلفه، ومعنى “منه” أي من نفسه وروحه، ومعنى خلافته له، قيامه مقامه في كل شيء ما خلا النبوة التي ختمت به(ص). ولقد عيَّن الله سبحانه هذا الشاهد بالإشارة والوصف، فوصفه تارة بأنه من رسول الله كما في الآية. ووصفه تارة أخرى، بأن عنده – من عند الله- علم الكتاب، كما في الآية: ﴿قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ﴾4. وبهذا التقدير الإلهي سنجد كيف يحدد القرآن الكريم الإطار المعرفي لحركة الإنسان في الزمان التاريخي. وهو ما تظهره الآية:
﴿يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾1.
وإذا كانت المعرفة البشرية قد وضعت فهم التاريخ وحركته ضمن جدالية الحرية والضرورة، فقد انطوت الآيات على قوانين مقدّرة في إطار السنن الإلهية الكلية التي لا تقبل التبديل والتحويل. من أجل ذلك لاحظنا كيف أن الآيات تختزن المقاصد الإلهية في البيان والبرهان والتعليم والتنبيه والتبشير والإنذار. وهذه المراتب كلها على الجملة تجتمع في المقصد الأعلى الذي هو الهداية. وبهذا نستطيع فهم مندرجات التدخل الإلهي في تاريخ الخلق. وهو تدخل يقوم على الدعوة إلى إدراك الواقع بما هو واقع، مثلما يتقوَّم بالحثِّ الإلهي على ضرورة تغيير هذا الواقع.
لعل الوجه الأكثر دلالة على التدخل الإلهي هو الاعتناء والتدبير واللطف. فالدعوة الإلهية إلى التغيير التاريخي غير مقصورة على توفير عامل القوة لدرء الفساد في الأرض، وإنما أساسًا على دعوة الإنسان إلى إجراء مراجعة معرفية في عالم المفاهيم والأفكار والثقافة التي يحملها. كما قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمْ﴾2. وما ذاك إلا لأن النقلة الحضارية من دائرة الفساد إلى فضاء العمران لا تبلغ غايتها من دون سياق تفكيري وسلوكي وأخلاقي يناسب ما قصدته الآية الكريمة: ﴿إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾3 .كما لو أن ثمة تقابلًا شرطيًا بين الانتصار لله من وجه والانتصار للنفس والغير من وجهٍ ثانٍ4.
ولما كان ذلك كذلك، فإن مقتضى هذا التقابل الشرطي لا مناص أن يكون في تحصيل التناسب بين إرادة الفاعل واستعداد القابل. ذاك لأن التناسب والقيام على الصراط هو الذي ينجز العروة الوثقى بين الرب والعبد. فلو تعقَّل العبدُ اجتماعه وقانون الزمن الذي هو فيه، وعمل وفقًا لأحكام الشريعة المقدسة، وكان من المتقين، لقابَلَه الشارع الأعظم بالاستجابة وسدد أعماله وأيده بالنصر5.
رابعًا: الفقيه الأعلى بين الواحد والكثير
يؤكد حيدر في معرض تأويله لمهمة الأولياء العارفين، أن أولياء الله والأفراد الذين ارتقوا إلى مقام الكمال الإنساني قد يتعددون في كل زمان، حيث يكون كل منهم لائقًا لهداية السالكين وإرشادهم، أما الولي الخاتم للحقيقة المحمدية فهو صاحب الولاية الكبرى، وهو عند أهل الولاية واحد في كل عصر يقتدون به ويمهدون السبيل لملاقاته ومن أجل أن يكونوا معه في كل أوان حتى لحظة ظهوره الأعظم وخلاص البشرية من معاثرها والشرور اللاحقة بها…. وهكذا ينتقل حيدر إلى تبيين التمايز بين الوحدة والكثرة في مفهوم الفقيه الأعلى. يرى في هذا المجال أن الكلام على جدلية الولي الواحد والأولياء الكثر يفسح الأفق التأويلي على طور تالٍ في استقراء نظرية الولاية وهوية الولي الخاتم على النحو الذي يجعل معنى الختم نهاية تكليف كل ولي في كل زمن أناط به الحق أمر العناية بالخلق. وفي هذا قال النبي الأعظم: “يجعل الله على رأس كل قرن وليًّا يجدد دينه”.. وما ذاك الإنباء النبوي سوى إشارة إلى مبدأ الوحدة والكثرة الذي عليه يستوي فهم الولاية وخاتمها1.
ما صفة هذا الولي الذي يظهر كل مئة عام ليحيي أمر الله في الناس..؟
لكي نتبيَّن تدرج المراتب بين الأختام المتكثرة والخاتم المفرد يتعيَّن تقسيم منازل السالكين وصفاتهم. فعلى سيرة ما ذهب إليه أكابر الصوفية سنقرأ كيف يميزون بين العلم والمعرفة. وبين العالم والعارف، وذلك لتأصيل نظرية الامتداد والانسجام بين الأختام الجزئية والخاتم المطلق. من هؤلاء من قدّم العلم على المعرفة، ومنهم من قالوا بتقديم العلم على المعرفة، وآخرون جمعوا بين المنزلتين ليظهروا صفة الولي المفرد والخاتم الوارث للحقيقة المحمدية.
يقرر العارف محمد بن عبد الجبار النفَّري، صاحب “المواقف والمخاطبات” (354هـ) أن العلم مرتبة “عبور” لا مرتبة “ثبات”. ولذلك فهو يقدم المعرفة على العلم ويدعو إلى امتياز الأخير إلى المعرفة، وبالتالي إلى الوصول والفناء الكامل عما سوى الله. وسنلاحظ هذا الامتياز في موقف “معرفة المعارف” من كتاب المواقف2 إذ يقول: “وقال لي لا يعبِّر عني إلا لسانان، لسان معرفة وآيته إثبات ما جاء به بلا حجة، ولسان علم آيته إثبات ما جاء به بحجة”3.
مؤدى هذا القول: إن العارف يستدل على الله بالله لا بخلقه. وذلك ما عرف في الفلسفة الإلهية بـ “برهان الصديقين” الذي يأخذ أصحابه بالقول المأثور: “عرفت ربي بربي ولولا ربي ما عرفت ربي”. أو “اعرف الله بالله..”؛ ذلك بأن العارف المتكلم بلسان المعرفة يهتدي إلى الأسماء بنور التجليات، وأنه شاهدٌ بنفسه لا يحتاج إلى إثبات حجة عليه. أما لسان العالم المتكلم بالعلم وهو “علم المنقول والمعقول” فخلاصته إثبات ما جاء به بحجة ودليل. والنفّري يرى أن العالم لا يستدل حقيقة على وجود الله، ذلك أنه – أي العالم – يعتمد على المبصرات والمعقولات. أي أن علمه ينحصر في دائرتين: الأولى: تمثل الإدراك الحسي.. والثانية: تمثل الإدراك العقلي. والله تعالى لا ينحصر في أي منهما فضلًا عن غير سواهما. فإنه تعالى يستَدل عليه بسواه من مخلوقاته. فهو دليل كل شيء لأنه الحق المطلق، من قصور النظر أن نطلب على الله برهانًا، وان نلتمس له الدليل من عالم البطلان.
في كتاب “المواقف” يبيِّن النفَّري شرف المعرفة على العلم بقوله: “وقال لي: المعرفة روح العلم والعلم روح الحياة”، و”قال لي : صاحب العلم إذا رأى صاحب المعرفة آمن ببداياته وكفر بنهاياته”1.
ذلك تأكيد منه على سمو المعرفة على العلم إذ من مبادئ المعرفة العمل الصالح، والعمل الصالح من العلم. وبالتالي فصاحب العلم يؤمن ببدايات صاحب المعرفة، إذ هي من مدركات عقله. وأما نهايات صاحب المعرفة فما هي في طور العلم، لأنها أمور غير العمل الذي يدل عليه العلم. وبالتالي فصاحب العلم يكفر بنهايات صاحب المعرفة2. وعلى هذا الاعتبار سوف نجد النفّري يصنِّف السالكين إلى الله تعالى إلى ثلاثة: “العبّاد والعلماء والعارفون”: “وقال لي الواقفون بين يدي ثلاثة: واقفٌ بعبادة أتعرف إليه بالكرم، واقفٌ بعلم أتعرف إليه بالعزّة، وواقف لمعرفة أتعرف إليه بالغلبة”. والنفّري هنا يصرح لنا كيف يتعرف الحق تعالى على كل طائفة من هذا المثلث بحسب مقامها منه.
– فالعبّاد هم الذين عرّفهم الله تعالى نفسه بأسباب فضله. أي أنهم يعبدونه راجين الظفر بجنته.
-والعلماء هم الذين عرَّفهم الله نفسه بأسباب عظمته. أي أنهم لا يستطيعون أن يدركوا الله العظيم الذي عنه يبحثون، ويؤكدون أن معرفة ذاته تعالى فوق طاقة الإدراك، فيكتفون من معرفته تعالى بهذا القدر. فقد تعرّف إليهم بالعزة من قولهم عزّ وجود الشيء إذا تعذر3. وأما العارفون، فهؤلاء يعرّفهم الله نفسه بأسباب الجذب، أي أن الشكر قد ملكهم، وأمسك بزمامهم. وهؤلاء سالكون بالله تعالى لا بأنفسهم وطريقهم الذكر لا الفكر، وهذا هو معنى قول النفري: “وواقف بمعرفة أتعرف إليه بالغلبة”. وعلى هذا فمرتبة العارف عند النفري تفضُلُ مرتبة “العالم”. وهو في هذا يختلف عما ذهب إليه بعض أقطاب التصوف مثل الجنيد (ت 295) وابن عربي (ت 638). لما قرروا في بعض مواقفهم أشرفية العالم على العارف، والعلم على المعرفة كما سنرى بعد قليل4…
وعلى أية حال، فإن الجدل في مساحة التمييز بين العلم والمعرفة لا ينحصر في دوائر الخطبة العرفانية والثقافة التاريخية للتصوف الإسلامي، وإنما يمتد ليحتل فضاء الفلسفة وعلوم الكلام والفقه والأصول. فلقد اختلف علماء الكلام في “حد العلم”، وعرّفه بعضهم بأنه “معرفة المعلوم على ما هو به”؛ وقسمه أهل السنة إلى علم قديم وحادث. وقسموا الحادث إلى ضروري وبديهي وكسبي، وعد أمام الحرمين أن “كل علم كسبي نظري”؛ لكننا إذا رجعنا إلى القرآن الكريم الذي استعمل فيه لفظ العلم كثيرًا نجد هذا الوصف مقترنًا بكل علم كسبي، فهناك آيات من القرآن تفيد أن عبادًا لله، أنبياء وغيرهم، علموا علومًا لا يتضمنها “النظر الصحيح في الدليل”. كما أن العلم بالسبب لا يوقف المسبب حتمًا، زد على ذلك أن الحد الأوسط في النظر القياسي كثيرًا ما يتأبى على العقل مهما بلغت صحة النظر في الدليل؛ وكأنما استشعر الإمام الجويني قصور تقريره عن الإحاطة بكل علم كسبي فعقب بقوله: “هذا ما استمرت به العادة، وفي المقدور إحداث علم وإحداث القدرة عليه من غير تقديم نظر”. أما الصوفية فإنهم حينما يريدون تعريف العلم أو الكلام عنه، فإنهم لا يجردونه من وظيفته (أو قيمته النفعية في الدين)، وإذا تناولنا على سبيل المثال، كلام الإمام الهجويري (ت 465هـ) عن “إثبات العلم” وجدناه يبدأ بالبحث في العلم من حيث هو فريضة على المسلم (حسب الحديث النبوي) لا من حيث حده وماهيته، ثم يقرر أن العلم ينبغي أن يكون مقرونًا بالعمل، وأنه لا يفضل أحدهما على الآخر لأن “العمل بلا علم لا يكون عملًا”، كما أن “العلم بلا عمل لا يكون علمًا”، وأن من الجهل الاكتفاء بأحدهما دون الآخر1.
ثم إن الهجويري يلاحظ على علماء الأصول (المتكلمين) أنهم سوّوا بين مصطلحي “العلم” و”المعرفة”، “غير أنهم جوّزوا أن يقال للحق تعالى عالمًا لا عارفًا لعدم التوافق”، في حين أن الصوفية يفرقون بين المصطلحين “فيسمون العلم المقرون بالمعاملة والحال… بـ “المعرفة”، ويسمون المجرد من المعنى والخالي من المعاملة “علمًا”… وأن الصوفية حين يصفون شخصًا بكونه عالمًا فإنهم لا يذمُّونه بتحصيل العلم، ولكن قد يذمونه بترك المعاملة (أي العمل بالعلم).
وإذا رجعنا إلى نصوص القرآن والحديث لا نجدها تتكلم عن العلم من حيث هو علم في ذاته، كما لم تفرضه بهذه الصفة، وإنما قرنته بمنفعته الدينية والدنيوية (المرتبطة بالدين) ورغبت فيه من أجل هذه المنافع؛ وقد افتتح الإمام الهجويري كلامه عن العلم بما أثنى الله به على العلماء في قوله تعالى: ﴿إنما يخشى الله من عباده العلماء﴾ (فاطر 28)، كما ضمن تحليله ذم الله وعز وجل الذين اشتغلوا بغير النافع من العلوم في قوله: ﴿وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنفَعُهُم﴾2، وكذلك تعوذ الرسول (ص) من ذلك بقوله: “أعوذ بك من علم لا ينفع3. فتبين لنا من هذا أن مصطلح الخطاب الصوفي بقي مرتبطًا في حده ومضمونه بالأصول الإسلامية الأساسية (القرآن والسنة) ومقاصدها العملية، ولم يجنح إلى التجريد النظري الذي مهد له علم الكلام، وبلغ أوجه في الفلسفة المتأثرة بما نقل عن اليونان4.
ومع أن مفهوم العارف يحتل مكانة تأسيسية في أعمال ابن عربي إلا أننا سنجده في مطارح شتى يقدم العالم على العارف. ومثل هذا الترجيح يضاعف من حرارة مساءلة واستنطاق نصوص ابن عربي نفسه للوقوف على السبب الذي حمله إلى ذلك. فلو عاينّا منظومته التأويلية لَظَهرَ لنا سياقان للرؤية، يبدوان متضادين في الشكل متصلين في المضمون. وعلى غالب الظن، أن ترجيح العالم على العارف عند الشيخ الأكبر ناتج من أمرين: أولهما، عائدٌ إلى الكيفية التي عولج فيها صاحب العلم في القرآن الكريم. وثانيهما، إلى تمييزه بين الخاتم الجزئي والخاتم المطلق. حيث إن الأول دون الثاني قربًا إلى الحق، بل يتلقى منه العلم والتسديد ويمهِّد لمهمته الكونية المنتظرة1.
ولدينا هنا شاهدان من أعماله:
الشاهد الأول: نطالعُه في كتابه الموسوم بـ “مواقع النجوم”، وفيه يقرر ابن عربي أن العارف هو دون العالم منزلة. ثم يسوِّغ تقريره المشار إليه بالإحالة إلى سورة الكهف، والمنزلة المخصوصة التي للعبد الصالح فيها. فالله تعالى يقول في صاحب موسى(ع):﴿وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا﴾2. فقد أعطي علمًا لَدُنّيًا لا توسط فيه لمرشد أو كتاب. وهذا ما يسمّى بالإلهام. وهو ضربٌ من الإخبار يسمو فوق طور العقل، ويتأتى من نفث روح القدس في الروع ويختص به النبي والولي كل بحسب رتبته ومقامه في عالم الألوهة.
وتأويل هذه الآية أن الحق تعالى لمّا أعطى عبده قسطًا من علم الغيب أصبح هذا العبد عالمًا. فهو إذن، عالم بالله. ولأنه كذلك فهو صاحب إلهامات وأسرار وخشية، ويعبّر عنه قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾3.
ذاك يعني أن العالم هو أيضًا صاحب خشية، وكذلك صاحب فهم وعلمكما في الآية: ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾4. أي أن العالم هو الراسخ الثابت الذي لا تزيله الشُّبَهُ ولا تزلزله الشكوك لتحقّقهِ بِما شاهد من الحقائق. وفي سياق كلامه على أشرفية العلم على المعرفة، يقول ابن عربي: “فما أشرفها من صفة (يقصد العلم) إذ حبانا الله بالحظ الوافر منها.. ثم يتساءل: وكيف لا يُفرح بهذه الصفة، ويُهجر من أجلها الكونان، ولها شرفان كبيران عظيمان:
أولهما: إن الله تعالى مدح بها نفسه.
وثانيهما: أنه تعالى مدح بها أهل خاصته من أنبيائه وملائكته، ثم منّ علينا سبحانه ولم يزل مانًّا، بأن جعلنا ورثة أنبيائه فيها لقوله(ص): “العلماء ورثة الأنبياء”. فلأي شيء يا قوم – والكلام للشيخ الأكبر – ننتقل من اسم سمّانا الله تعالى به ونبيه إلى غيره. ونرجحه عليه، وتقولون فيه هذا عارف وغير ذلك. والله ما ذاك إلا من المخالفة التي فيها طبع النفس، حتى لا نوافق الله تعالى فيما سمّاها1.
وحيث يتحدث ابن عربي عن صفة العالم على هذا النحو، فلن نلحظ أي مغايرة لأطروحته عن صفات العارف حيال المراتب التي يستحقها، ولا سيما منها مرتبة العارف الواصل المخصوصة بالولي الخاتم.
ولأن العالم الذي يصفه ابن عربي بهذه الصفات العليا، هو نفسه العارف للواصل الذي كُشفت له الأحجبة وطُويَت له الأرض، ورُزق من العلم اللدني بمقدار سعته واستعداده، فذلك يعني أن كلام ابن عربي حول أشرفية العالِمِ على العارِفِ إنما يدخل في مقام التخصيص. ولذا فمن أوَّليات التعرف إلى الولي عند ابن عربي أن العلم الاكتسابي الذي يختص به علماء الرسوم لا يرقى إلى مقام علم العالم العارف. بل هو عند درجة الاحتجاب والنقص ويحتاج معها إلى نصح العرفاء ورشادهم. وثمة في هذا الخصوص ما لا حصر له من الشواهد.
الشاهد الثاني: وفيه نشير إلى ما قرره ابن عربي في “الفتوحات المكية” بقوله: “وجاء هذا الفقيه إلى الحضرة الإلهية بميزانه ليزِنَ على الله، وما عرف أن الله تعالى ما أعطاه تلك الموازين إلا ليزِنَ بها لله لا على الله. فحُرِمَ الأدب، ومن حُرم الأدب عوقب بالجهل بالعلم اللدني الفتحي”2. يضيف: “ومع هذا الفضل المشهود لهم (الفقهاء والمتكلمون)، ينكرون على أهل الله إذا جاؤوا بشيء مما يغمض عن إدراكهم، وذلك لأنهم يعتقدون فيهم، أنهم ليسوا بعلماء، وأن العلم لا يحصل إلا بالقلم المعتاد في العرف، ولقد صدقوا، فإن أصحابنا ما حصل لهم ذلك العلم إلا بالتعلم، وهو الإعلام الرحماني الرباني”3.
يحضرنا في هذا المقام شاهد رفيع الدلالة يستجلي موقف الشيخ الأكبر من فلاسفة العقل المحض، ومن علماء النقل على السواء. وهو ما سنلاحظه في واحدة من أبرز النصوص النادرة في التراث الصوفي. قصدنا به رسالته إلى الإمام الفيلسوف الفخر الرازي4.
في هذه الرسالة يبتدئ الشيخ الأكبر بجميل العبارة وأحسنها معلنًا محبته للرازي، فيما يعكس لديه أدب المخاطبة مع أهل العلم، ثم يُتبِعُه بحديث نبوي و”إذا أحب احدكم أخاه فليعلِمْه إياه”؛ أي فليخبره بحبه.
ثم يتوجه إلى الرازي بالقول: “واعلم أن أهل الأفكار إذا بلغوا فيها الغاية القصوى أدّاهم فكرهم إلى حال المقلِّد المصمِّم، فإن الأمر أعظم من أن يقف فيه الفكر. فما دام الفكر موجودًا فمن المحال أن يطمئن ويسكن. فللعقول حد تقف عنده من حيث قوتها في التصرف الفكري، ولها صفة القبول لما يهبه الله تعالى، فإذن ينبغي للعاقل أن يتعرض لنفحات الجود، ولا يبقى مأسورًا في قيد نظره وكسبه، فإنه على شبهة من ذلك. ومن المحال على العارف بمرتبة العقل والفكر أن يسكن أو يستريح ولا سيما في معرفة الله تعالى. ومن المحال أن يعرف ماهيته بطريق النظر، فما لك يا أخي تبقى في هذه الورطة، ولا تدخل طريق الرياضات والمجاهدات والخلوات التي شرعها رسول الله(ص) فتنال ما نال من قال فيه سبحانه وتعالى: ﴿عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا﴾1، ومثلك من يتعرض لهذه الخطة الشريفة والمرتبة العظيمة الرفيعة”2.
حسب صاحب أطروحة الفقيه الأعلى أن ما قصده ابن عربي في هذا المقطع من رسالته إلى الفخر الرازي ينطوي على معانيَ وتنبيهاتٍ تفضي على الجملة إلى الحكم على العلم الكسبي بالتناهي والقصور ومحدودية النظر العقلي لأجل بلوغ المعارف الإلهية. وفي هذا المحل نشير إلى ملحوظتين:
الأولى: أن الفكر المقيد بالعقل المحض. أي العقل الذي يستدل بالمخلوقات على الخالق لن يبلغ المرتبة التي تمكنه من بلوغ معرفة الله. ذلك بأن العلم بالله، وهو طريق أهل الحق من العرفاء والأولياء، هو خلاف العلم بوجود الله، وهذا الأخير طريق أهل الأفكار الذي مهما بلغوا من التعلم فإنهم سينتهون إلى الوقوف عند التقليد.
والثانية: أن الحَيْرَة والقلق واضطراب النفس هي سجايا لمن يكتفي بقدرته الذاتية لإدراك الحقائق، وبسبب من هذا الاكتفاء لن يتسنى له إحراز شهادة التعرّف. وكما يبين ابن عربي في مقطع آخر من الرسالة. “أن النفس متى تغذَّت كسب يديها فإنها لا تجد حلاوة الجود والوهب وتكون ممن أكل من تحته3. كما قال تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُواْ التَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لأَكَلُواْ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم﴾4. وهذه إيماءة إلى حقيقة أن أهل الفؤاد إنما يتلقون العلم من أعلى، ومن يتلقى العلم من الوحي عن طريق الإرث المحمدي، أمكن له الإحاطة بمعارف الوجود والموجود. ولذلك أورد الشيخ الأكبر في الرسالة المذكورة ما حرفيته: “وليعلم ولييّ وفقه الله (ويقصد الإمام الرازي) أن الوراثة الكاملة هي التي تكون من كل الوجوه، لا من بعضها، و”العلماء ورثة الأنبياء” كما جاء في الحديث الشريف. فينبغي للعاقل أن يجتهد لأن يكون وارثًا من جميع الوجوه. ولا يكون ناقص الهمة”. أي همة السير إلى الله حتى يورثه علوم الأنبياء ومعارفهم. ذلك أن حُسنَ اللطيفة الإنسانية إنما يكون بما تحمله من المعارف الإلهية، وقبحها بضد ذلك، وينبغي للعالي الهمة أن لا يقطع عمله في المحدثات(الدنيا) وتفاصيلها، فيفوته حظّه من ربه، وينبغي له أيضًا أن يسرّح نفسه من سلطان فكره، فإن الفكر يُعلَمُ مأخذه. والحق المطلوب ليس ذلك، وإن العلم بالله خلاف العلم بوجود الله1.
من هذا المائز الجوهري بين العلم الوهبي والعلم الكسبي. أمكن لنا القول: إن منزلة الإنسان الكامل هي منزلة ذات مراتب متعددة تأخذ مسارها من الأدنى إلى الأعلى، فيكون لكل ولي منزلة على قدر علمه وعمله وفي الزمان الذي صرف عمره فيه، وأدى فيه تكاليفه الولائية وصولًا إلى خاتم الولاية المحمدية المطلقة، الذي سيظهر حجته على الخلق بالحق2.
خامسًا: حاضرية الفقيه الأعلى في التاريخ
قد يكون التساؤل الأكثر حيوية الذي يمكن استخلاصه مما ذهب إليه البروفسور حيدر في أطروحته، هو ما يتصل بحاضريَّة ودور العرفان ومكانتِهِ في التحديات الكبرى التي تواجهها الحضارةُ الإنسانيةُ المعاصرة. ولعل ما يضفي على القضية المطروحة سمة راهنة واستثنائية، هو اشتمالُها طائفة من المفاهيم المستحدثة يمكن أن تُصاغَ عن طريقها استراتيجية معرفية لإحياء حضاري ذي سمات مفارقة. ولمَّا كانت التأسيسات النظرية المتضمّنة في الدراسة، تتمحور على الإجمال حول فضاءين متلازمين، هما: العلم بالله والعلم بشؤون الخلق، فإن تسييل هذين الفضاءين، أمرٌ يندرج في مقدَّم الأولويات التي ينبغي أن تمهِّد لأفق جديد في فلسفة العرفان. فما ذهب إليه صاحب الفقيه الأعلى من تأصيلات بصدد العرفان في مقام التدبير السياسي، يعود أساسًا إلى مركزية الكائن الآدمي كمستخلفٍ إلهيٍّ في دنيا المخلوقات. وبوصف كون هذا الكائن نقطة الجاذبية في الكون الأكبر الحاوي للموجودات كلها، فقد وقع التكليف عليه بالرضى والقبول والإقبال، لينجز مهمته العظمى في التوحيد بركْنَيْه توحيد الخالق وتوحيد المخلوقات. فإذا كان مقتضى الأول توحيد الخالق بتنزيهه عن الثنائية والتركيب، فمقتضى الثاني توحيد الخَلق، وتدبير حاجاتهم على كثرتها وتنوعها واختلافها. وما من جدل أن هذه المهمة المركَّبة في السياسة العرفانية، استدعت مجاوزة منعطفين معرفيَّيّن لا يزالان موضع مكابدة في المباحث النظرية لعلم الوجود: الأول، يتصل بالأثر المترتِّبِ على الفصل الأنطولوجي والمعرفي بين الله والعالم؛ وهو ما ذهبت إليه الديانات غير الوحيانية، ومعظم المدارس المشائية، ناهيك عن الوارثين من مذاهب الميتافيزيقا المعاصرة. أما الثاني، فمتعلِّقٌ بما تستثيره نظرية وحدة الوجود من شُبُهات، ولا سيما تلك التي شاعت في الفضاء الجيو-إسلامي بدءًا من القرن الرابع الهجري، والقائلة بحلول الكل في الكل، والواحد بالكثرة، والله في العالم1.
ولأجل بيان هذين المنعطفين اللَّذين حَظِيَا بعناية مركَّزة في تنظيرات البروفسور حيدر، فإننا نلاحظ أنه حرص على تقديم مجموعة من الفَرَضيَّات التأسيسية التي تتاخم الأفقين الأنطولوجي والسياسي معًا، ثم ليخلُص إلى استنتاجات معمَّقة بشأنها:
الأولى: رفع التناقض في نظام الخلق، وإثبات اجتماع الأضداد وفق المبدأ المتقوِّم على زوجية الخلق.
الثانية: استحالة استقلال عالم الموجودات عن مشيئة التدبير والعناية الإلهية وتدبيراتها.
الثالثة: إقرار عناية الواجد بالموجود الحاوي للكثرة الوجودية. مع ما يترتب على هذا الإقرار من تنبيه المستخلف إلى تكليفه الإلهي والسير بسياسته الإحيائية إلى غايتها القصوى.
الرابعة: فهم صلة الكثرة مع الكثرة، على قاعدة توحيد العالم المتعدّد، على اختلاف مظاهره وتعدد أجناسه وأفراده.
الخامسة: فهم المنطقة المعرفيّة التي يتأسّس فيها تدبير الله لعالم الخلق، وبيان جدلية الانفصال والاتّصال الناظمة لعنايته تعالى بهذا العالم.
السادسة: نزول الموجود الأول في الحقل الميتافيزيقي كنظير أنطولوجي لعالم الممكنات، وبالتالي كناظمٍ لوحدته بحكم جمعه للكثرات الوجودية.
السابعة: إثبات حاضرية الإنسان ككائن محوري وفعَّال في دنيا الممكنات، وبيان قدرته – حال كماله وتجرُّده –على تعقُّل نظام الوجود على ما هو عليه، كذلك على انتهاضه بالعالم الإنساني وتمهيد سبيل سعادته على صراط العدل.
الفرضيات السبع التي مرَّ ذكرها، تستهدف حسب أطروحة حيدر وضع إطارٍ تنظيري لمنظومة إحيائية عرفانية تصل الغيب بالواقع العيني، كما تمهِّد السبيل إلى تصويب حالة التداعي والتهافت في بنية الحضارة المعاصرة2.
المسألة المحورية التي تتغيَّا أطروحات محمود حيدر[19] تسييلها في ميدان التفكير العربي الإسلامي المعاصر، هي استئناف الكلام على أطروحة الاستنهاض الحضاري، والمكانة التي تتبوَّأها المنظومة العرفانية في هذه الأطروحة. وعليه، فإن تنجيز هذه الغاية يستلزم برأيه مجموعة من الفرضيات التأسيسية نوردها في ما يلي:
الأولى: حاضرية العرفان كفضاء معرفي وسلوكي وأخلاقي، بما لهذه الحاضرية من مؤثِّرات حاسمة في تشكُّلات نظام القيم في التاريخ الاجتماعي والحضاري الإسلامي2.
الثانية: إيقان العرفاء بسيادة العدل الكوني كخاتمة حتمية في تاريخ الإنسان. واليقين بهذه الفرضية يدخل كمكوِّن أصيلٌ في منظومتهم، لأنه يستظهر ما أوجبوه على أنفسُّهم في تدبير شأن الخلق3.
الثالثة: إحاطة المنظومة المعرفية العرفانية بشؤون الإنسان الدنيوية والأخروية. وتبعًا لهذه الإحاطة تنسلك أطروحة التدبير ضمن مسرى اعتنائيِّ هادفٍ إلى بناء مجتمع إنساني مؤسَّسٍ على الخيرية الشاملة. وعلى خلاف ما شاع من أحكام عجولة في هذا الشأن، فإن معاينة متأنيِّة لاختبارات العرفان السياسي، تُظهر صلته الوطيدة بتحولات كبرى انخرط فيها كبار المتصوفة والعرفاء؛ وهو ما تدل عليه شواهد بيّنة في التاريخ الإسلامي، سنأتي على بسطها في هذه الدراسة، وعلى الأخص ضمن فصول الباب الثالث منها.
الرابعة: إن رؤية إجمالية لمواقف العرفاء ومناهجهم في مقام التدبير، تكشف عن وصل عميق بين التعرُّف على الحق، ورعاية شؤون الخلق. ومثل هذا الوصل- الذي يعرب عن فعليَّتِه وفق مبدأ الحكمة والموعظة الحسنة- يشكل ركنًا تأسيسيًّا في المنظومة المفترضة للفلسفة السياسية العرفانية.
الخامسة: أفضت اختبارات العرفاء إلى وحدة نظامهم المعرفي من حيث توفُّرِهِ على ركنين متلازمين: اعتقادي ويقوم على توحيد الحق، وحضاري غايته توحيد الخلق نحو اجتماعٍ رحماني قوامه الخيرية والعدل4.
سادسًا: الفقيه الأعلى وقضية الغيرية والاختلاف
تكاد قضية الغيرية والاختلاف في الاجتماع الحضاري تشكل واحدة من أدقّ الإشكاليات المعرفية وأكثرها حساسية وتعقيدًا. وذلك ما يشير إليه حيدر في موضوع آخر بحوثه ودراساته المتخصصة بفلسفة العرفان النظري. ولعل الوجه اللاَّفت في التنظير لهذه القضية هو ما ذهب إلى وضعه تحت عبارة “المواطنة الرحمانية”. وعلى غالب الاعتقاد فإن اختياره لهذه العبارة جاء موفقًا من أجل تظهير الدور الرسالي للفقيه الأعلى. وبالتحديد من أجل استجلاء ما حَظِيَت به منزلة الإنسان في المعارف الإلهية والحكم الربَّانية من اعتناء خاص في سياسة العرفاء. من هذا النحو يشكل مبنى “المواطنة الرحمانية” أحد أبرز الأركان المؤسِّسة في الهندسة المعرفية للتدبير العرفاني. ولعل ما يعرِبُ بجلاء عن هذا المبنى ما أورده المؤلف عن الإمام علي بن أبي طالب في قوله المأثور: “الناس صنفان، إما أخٌ لك في الدين، أو نظير لك في الخلق”. فالنظير في الخلق هو الأساس الذي يقوم عليه مفهوم التدبير في الفلسفة السياسية العرفانية. فهو مقام مبنيٌ على حاضرية الله وعدله في عالم الاختلاف والكثرة. ذاك بأن حاضرية الله في عالم الخلق تجعل النظير مخلوقًا مفارقًا لما تعارف الناس عليه. فالنظير العرفاني، ليس كائنًا عاديًّا شأنه شأن سائر البشر. أي أنه خلاف ذلك الكائن المسكون بالأنانية، النافي للآخَرية. بل ذاك الذي صادَقَ الألوهية حتى منحته صفاتها في العطاء والجود واللطف. ولذا جاءت حاضرية الله في النظير العرفاني على نشأة اللطف والتسديد لا منَّةَ فيها لأحد من الناس على أحد. أي أنها عين الرحمانية التي يستوي فيها النوع الآدمي بالعدل على نشأة النفس الواحدة. وعليه، فإن فهم النظير على مثل هذا النصاب المتعالي، هو فهمٌ لا يتحقق على التمام إلا إذا عاينّاه بعين الحق لا بعين ذاتنا. فلا تستقيم الرؤية التوحيدية مع رؤيتنا المكتظة بالفقر، والأنانية، ونكران الجميل. فقاعدة التناظر في الكثرة الخَلْقية هي قاعدة أصيلة ثابتة ينفرد بها الخالق وحده. والخلق المأمورون بتمثُّلها لا ينالونها بغير المجاهدة. ولهذه المجاهدة شرائط معرفية وسلوكية، هي من مقتضيات السفر المعرفي العميق في المباحث الإلهية المقرونة بحسن السير والسلوك1.
ولو كان لنا أن نعثر على مكانة النظير في المواطنة الرحمانية، لقلنا إنها الغاية التي يطلبها السالك إلى الحقّ في دنيا الخلق. فلو بلغ المطلوب أصبح مواطنًا إلهيًّا كاملًا. وسيكون عليه لكي يبلغ رشاده وكماله أن يقطع منازل التّطهر والصعود منزلًا بعد منزل بالإيثار والجود والسخاء. ولكنه يعرف أن مقتضى المهمة هو الأخذ بمشقّة الطريق أنّى كانت أثقالها. وإذا كانت الحقيقة المحمدية في ظهور من ظهوراتها هي سَرَيان الوحي في التاريخ، بَانَ لنا النظير كتجلٍّ من تجلياتها. ويمكن أن نشهد على هذا التبيُّن من ثلاث جهات:
-الجهة الأولى: بصفة كونه سلك الطريق وترقّى في معارجها حتى عرف نفسه فعرِف الله فعرَّفه الله على خلقه.
-الجهة الثانية: بوصف كونه عارفًا بغيره، معينًا لهذا الغير على التشبُّه بجميله وحسن فعاله، إلى الدرجة التي يصير فيها الغير نظيرًا له في الصفات والأفعال.
-الجهة الثالثة: بوصفه مظْهرًا للحق الأعلى في مقام الرحمانية1.
حين تجتمع الجهات الثلاث، حقَّ أن تتكامل صورة المدبِّر وماهيته. بذلك نجده ينتقل إلى طور العمل ليبدأ سفره في عالم الناس ساعيًا إلى إنجاز مهمته الموكولة إليه. وهكذا تبدو المهمة القصوى للنظير الرحماني في مفارقته سلطة الأنا على الغير، حتى وهي تقرُّ لهذا الغير بحقٌّ التناظر والاستواء. ولهذه المهمة بعدٌ جوهري يتوقف على تحقُّقِها تحصيل الرحمانية كصفة فعلية لحاكمية الحق الأعلى في ضبط التقابل بين الأنانية والغيرية. فالنظير الرحماني يبقى حتى وهو في مقام التحقق مفتقرًا إلى حاكمية الحق الأعلى وتسديده. فهو دائمًا على خوف مقيم من التقصير، كما في قوله تعالى: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾[آل عمران- 92]. والإنفاق من الحب هو العطاء الزائد عن الواجب. وهو الدرجة العليا من الجود التي تدخل في فضاء يتعدّى فائض التملُّك. إنه الإنفاق من ذات الأنا التي لا يقدر عليها إلا من نال شهادة العرفان بعدما جاهد نفسه حدّ التلاشي في حقيقة الشريعة. هكذا، لم يكن للنظير أن يحرز كماله، لولا أن بلغ ما بلغه في معراج التوحيد. فلئن استوت جدلية الأنا والغير على أرض الله، أفلح العارف في تظهير قوام النظير على حسن المقام. حيث لا يُكتب للنظير حظ اكتساب صفاته الفاضلة، ما لم يحرز مقام التوحيد كأساس لموقعيته في دنيا الاستخلاف الإلهي2. وفي إطار مسعاه لتظهير رؤية الفقيه الأعلى لمفهوم المواطنة الرحمانية، يبيِّن حيدر أن مَبْاني التعرُّف والتدبير والمواطنة الرحمانية التي مرَّ بسطُها، تفترض برأيه إنشاء منفَسَحٍ لتنظير العرفان في مقام التدبير السياسي. وهذا يوجب بدوره تفعيل مهمة التنظير بوصف كونها بَدءًا ضروريًّا لتنشيط دروب التفكير واستكشاف معاثرها، وتظهير الإجابات المتعلقة بقضاياها الكبرى.
وسعيًا إلى تأصيل هذا المبنى وواجبيته كمكوِّن أساسي في منظومة التدبير العرفانية، وجدنا أن نتاخمه من زوايا ثلاث:
الأولى: استكشاف حيويات التفكير في البيئة الحضارية العربية والإسلامية، وبيان مشكلاتها، والسعي إلى ترسيم هندسة عمل تسهم ولو بقسط يسير في إيقاظ مكامن المعرفة في أوساطها، وتوليد ما تختزنه من إمكانات ووعود.
الثانية: بلورة نظرية معرفة في التدبير السياسي من خلال التمهيد لمنفسحات تفكير تستحثّ على تظهير الأسئلة التي لم تُسأل بعد، أو تلك التي سُئِلت من قبل ولمّا يُجْبَ عليها. ما يعني أننا أمام مهمة تأسيسية تعاين الكوامن التاريخية للانسداد الحضاري بغية التعرُّف إليها، وفهمها، والعمل على ترتيب هندسة معرفية هادية إلى أفق إحيائي.
الثالثة: نقد الاستتباع الحضاري. وهذا جهد معرفي يراعي ضرورات التدافع بين الهويات الحضارية المختلفة والمتعددة، كما يتغيَّا فهم وتدبُّر أحوال الإنسان في مجتمعاتنا، ولا سيما لجهة الأثر الذي تتركه الغزوات الثقافية على تكوينه الثقافي والفكري وهويته الحضارية1.
ثامنًا: الفقيه الأعلى متعرِّفًا
يشكل مفهوم التعرُّف محورًا أساسيًّا في نظرية المعرفة العرفانية عند المفكر محمود حيدر. وقد نجد هذا الأمر بوضوح في عدد من أعماله. ففي محاضرة له ألقاها في جامعة باكو – أذربيجان رأى حيدر أن التعرُّف في نهج العارف يرقى إلى كونه واجبًا إيمانيًّا وضرورة سوسيو- تاريخية في آن2. أما واجبيتُه فمردُّها إلى تعرُّفه على الواجب تعالى، من أجل أن يتحقَّق من تكليفه بوصف كونه مُرسَلًا إلهيًّا إلى عالم الخلق. أما لجهة ضرورته السوسيو تاريخية، فهي ما تعرب عنها مهمته التدبيرية في عالم الاجتماع السياسي. ما يعني أن قضية كهذه تنطوي على بعدين متلازمين، إلهيٌ وبشري. ومثل هذا المقصد ينبني على النظر إلى التعرُّف الساري في عالم الأفكار والثقافات وبين الحضارات والأديان، على أنه فعلٌ مسبوق بالإيمان بحقانية التغاير المتأتِّي من مبدأ الاختلاف. حين يتخذ التعرُّف مثل هذا المسرى، يصير لدى المتعرَّف شأنًا متأصّلًا في ذاته سواءً كان فردًا أو جماعةً أو حيِّزًا حضاريًّا. فالمتعرِّف الذي تعقّل فضيلة المعرفة وتخلَّق بها، مدركٌ بأن ما يفعله إنما يدخل ضمن سَيْرِيَّة تحويل الجهل إلى علم، والبعيد إلى قريب، والآخر المختلف إلى نظير مساوٍ في الآدمية. وهذه السَيْرِيَّة لا تنهض وتنمو إلا باقتران جوهري بين الإيمان بمكانة الإنسان السامية في الوجود، والعمل على تصديق هذا الإيمان قولًا وعملًا في الآن عينه1.
إلى ذلك يدخل التعرُّف في أطروحة محمود حيدر كمكوِّن أصيل في المنظومة السياسية العرفانية. ذلك بأنه يحيط بثلاثة حقول تأسيسية يشير إليها بما يلي:
–الحقل الأول: ميتافيزيقي، يروم العارف من خلاله إعمال العقل النظري من أجل أن يصل بسؤاله إلى فهم الوجود بما هو موجود.. ثم يواصل مجاهداته إلى ما هو فوق ميتافيزيقي باحثًا عن سر الوجود في كل موجود. أي الوقوف على الأصل الذي ظهر بسببه كل كائن والإيمان به.
–الحقل الثاني: وفيه ينظر العارف إلى مبدأ التعرُّف على الخلق من حيث كونه أمرًا شرعيًّا أوجبته الأديان على مؤمنيها ليكون لهم سبيلًا للاهتداء إلى الخالق من خلال معرفة مخلوقاته.
–الحقل الثالث: وفيه يُنظر إلى التعرُّف كناظم لإدارة الاختلاف في عالم تتكثَّر فيه الأديان والهويات والأفكار2.
المتبصِّر بواجبية التعرُّف كما يقول حيدر لا ريب لديه في قانون الاختلاف الذي ينحكم إليه عالم الخلق. فهو على دراية من أن تعرُّفًا بهذه الخصائص لا يضادّ الولاء لقضية أو هوية أو دين. ذلك بأن الولاء بلا عصبية، هو ولاءٌ مشفوع بالرحمانية واللطف، ومُقِرُّ بحقَّانية التنوع والانتماء وحرية الاعتقاد. ولأن التعرّف من بديهيات الاجتماع البشري، فالذي نسعى إلى تأصيل مبانيه وشرائطه، قائم على الجمع المتأنِّي بين التسامي على التعصُّب، والانتماء الخلاَّق إلى اجتماع حضاري ينفتح الأفق فيه على تواصل خيِّرٍ بين الأديان والثقافات على تعددها واختلافها. بهذا يغدو التعرُّف جوهرًا أصيلًا في ذات المنتمي، يفيض من خلاله على الغير بما يختزنه من جميل، ثم ليستحثَّ هذا الغير الى إفاضة معاكسة هي أدنى إلى ردِّ الجميل بالجميل. في مقام التعرُّف بين الحضارات والأديان العالمية على العموم، وأديان الوحي على الخصوص، تتضاعف مكانة الوعي بفضائل الغيرية في بعديها الإيماني والمعرفي. فلو مضينا في تبيُّن هذين البُعدَين لوجدنا أن من لوازم التعرَّف اقتران الإيمان بالمعرفة. فلا يبلغ التعرّف حقّانيته، ما لم تتلازم هاتان القيمتان لتغدوا معًا أساس كل التقاء خلاّق بين الأديان. فإن أيًّا منهما تُسدِّد الأخرى وتؤيدها، أما النتائج المترتبة على مثل هذا الالتقاء، فهي في مدى ما يبديه المتلاقون من أخلاقيات عملية، ويقينيات دينية، تعزز معارفهم بنظائرهم على النحو الأكمل3.
مستهل تفعيل الأسس النظرية والسلوكية للمتعرِّف، إقراره بأن النظام الروحي والفكري الذي يحكم الشخص المتديِّن، لجهة ما يبذله من جهود من أجل تمتين ارتباطه بدينه، هو نفسه النظام الذي يحكم الشخص إيّاه، لكي يبذل الجهد اللاَّزم باتجاه التعرُّف على دين غيره. وفي هذه الحال، يدرك المتعرِّف بأن مثل هذه الأسس تستلزم سَيْريّة نشاط صادقة بالنية والعمل، ومدفوعة بالتبصُّر الخلقي والإيمان الديني في آن. وهو ما تنكشف آثاره من خلال النظر إلى الغير بما هو نظير في النوع الإنساني، وفهمه بوصفه شريكًا كاملًا في بناء الحضارة الإنسانية. أما العائدات التي يحصّلها المتعرِّف وهو يمضي في الغيرية والإيثار، فهي كثيرة وجليلة على الجملة منها1:
أ. سوف يساعده التعرُّف في معرفة دينِهِ ومعتقده على نحو أكثر عمقًا. فالحقائقُ تُدرك بنظائرها، و”الأشياء تعرف بأضدادها”.
ب. بالتعرُّف الرحماني يتوصل المتعرّف إلى إدراك معنًى آخَرَ للحرية، من خلال إدراكه أبعادها الإيمانية الإلهية والأخلاقية.
ج. من فضائل التعرُّف أنه يمنح المتعرِّف منفسحًا لتوسيع معارفك معارفه حيال معارف غيره، ويلتمس ما تنطوي عليه من محاسن وكمالات، قد تكون محتَجَبة لدواعٍ شتى في فضائه الثقافي والحضاري.
د. إمكان التوصل عبر التعرُّف إلى أرض مشتركة يمكِّن المتعرِّفين، وكلٌ من موقعيته وهويته وولائه من تظهير ودادٍ معرفي يفضي إلى الخير العام في ميادين الفكر والثقافة والاجتماع والسياسات الفاضلة.
السادسة: العارف في مقام التدبير هو فقيه وفيلسوف ومفكر وقائد سياسي. وعليه، ينظر إلى مهمته بوصف كونها تكليفًا إلهيًّا يتكامل فيه توحيد الخالق مع توحيد الخلق. وهذا مقام يعدل مقام “الجهاد الأعظم” الذي هو المحطة الأخيرة للولاية السياسية العرفانية2.
تاسعًا: منهجية حيدر في الفقيه الأعلى
من الوجهة المنهجية يمكن القول: إن البروفسور حيدر قارب موضعه الدقيق بمنهج تنضوي فيه طرائق متعددة في منهجيات البحث. وهو كما نعرفه في مجمل أعماله الفلسفية والفكرية ينحو منحًى عابرًا للمناهج ومتصالحًا معها في نفس الوقت. وهذا طبيعي لسببين:
السبب الأول: يعود إلى طبيعة مقاربته لعلم العرفان كعلم مفارق في حقل العلوم والمعارف الإنسانية. ذلك بأن العرفان علم يقوم على الاختبار الذاتي من خلال السير والسلوك.
السبب الثاني: فيعود إلى فرادة أسلوب حيدر الخاص في التعامل مع النص الصوفي. فهو لا يكتفي بالاقتراب من النص على طريقة الناظر إليه من مسافة بعيدة. بل الذي يمتلئ بالنص فكرًا وذوقًا، ثم ليعيد تشكيله على طريقة العارف بما تنطوي عليه الكلمات من دلالات وإشارات ومعان مستترة.
لقد أخذ حيدر بمنهج تتآزرُ فيه مجموعة من مناهج العلوم الإنسانية، كالفلسفة السياسية، وعلم الأخلاق، والنفس، وفلسفة الدين، وعلم اجتماع التديّن، فضلًا عن علم أصول الدين والفقه والتفسير بمجمل مكوِّناتها. وبناء على فَرَضيّة النظر إلى العرفان كمنظومة معرفية متَّسقة، يقدم لنا حيدر جملة من السمات والخصائص المنهجية ذات الصلة بمكونات هذه المنظومة1:
أولًا: إذا كان من نَسَبٍ علمي للعرفان، فنسبتُه عائدة إلى علم التوحيد. ومع أن تمام هذا العلم يكون بالنظر والعمل معًا، فإن الشطر النظري منه يفارقُ ما درجت عليه المباحث الفلسفية الكلاسيكية لجهة تعريف موضوعها بأنه “علم الوجود بما هو موجود”. أما مباحث العرفان فهي تقطع مسافة أبعد لتنظر في الوجود الحقيقي الجاعل لأصل الوجود. وهذا ما يؤول بها إلى متاخمة التوحيد الأقصى، أو إلى ما يصطلح عليه في العرفان النظري بـ “الوحدة الشخصية للوجود”. وهذا المقام من المعرفة هو ما يطلق عليه أيضًا “التوحيد الوجودي”، الذي لا يُحمل إلا على الله تعالى بنحو حقيقي وذاتي، بينما يُحمل على غيره على نحو المجاز والاعتبار.
ثانيًا: العرفانُ علمٌ عمليٌ جامع لأركان الشريعة، ومؤيّدَ بالسير والسلوك والمجاهدة بغية الوصول إلى مقام الولاية التدبيرية. وبوصف كونه علمًا دينيًّا جامعًا للنظر والعمل، وغايته التدبير السياسي والاجتماعي والحضاري، يدخل العرفان كمكوِّن تأسيسي في علم اجتماع التديُّن.
ثالثًا: إنه علمٌ مرتَّب على منهج التأويل.
رابعًا: إنه علم ربَّانيٌ يحصِّلهُ العارفُ بالإلهام والحدس والمجاهدات المعنوية والروحية.
خامسًا: إنه علمٌ سيّال يؤتَى العارفَ من جهات الوجود كلها، ويجري مجرى معرفة النفس ومعرفة العالم ومعرفة الله.
سادسًا: إنه علمٌ رسالي غايته إصلاح شأن الخلق، وإيصال البشرية إلى سعادتها.
وبسبب من حَواية العرفان على المعارف الإلهية والعلوم الإنسانية المكتسبة في آن، فبديهي أن يُتعاملَ وخاصِّيته الاحتوائية هذه، بمنهج مفارق، يتضافر مع المناهج الأخرى ويتعدَّاها في الآن عينه. هذه الجدلية المنهجية تتعدَّد آلياتُها تبعًا لما تفترضه طبيعة كل قضية من القضايا التي يجري تناولها. ولذلك افترضت السِيَرُ الذاتية للأولياء الذين عاشوا تجارب العرفان السياسي، أن تُقاربَ اختباراتهُم وفقًا لسيْرِيَّة الجمعِ والمؤالفة بين النقل والعقل والذوق والتأويل، فضلًا عن المنهج التجريبي. فالمنهج العرفاني وفق ما أظهرته الدراسة هو الذي تتضايف فيه الأضداد على نصاب الوحدة والتكامل، كما تتناظر فيه أسئلة الواقع مع أسئلة الغيب، والأسئلة الوجوديّة مع الإجابات الوحيانية. ومع أن لكلّ من الأسئلة والإجابات اتجاهات متغايرة ضمن دائرة التضايف، إلا أنها تلتئم ضمن مشترك واحد. ولئن كان تعبير “التضايف”، يستخدمُ بمعانٍ متعددة في مجال اللغة العلميّة، إلا أنّه يُفهم في هذا الموضع بالذات، على أنّه تقابُلُ عنصرين مستقلين عن بعضهما، إلا أنهما يتآخيان، ويحنوان على بعضهما البعض من أجل أن يؤدِّيا وظيفة واحدة1…
ولأجل أن يستدلَّ العرفاء على مشروعية منهجهم في لقاء الأضداد، راحوا يميزِّون بين مفردات متشابهة مثل الاختلاف والتفاوت والتنافي. فالفرق – مثلًا – بين الاختلاف والتفاوت، أن الأخير يدل على الاختلاف الواقع على غير سُنُنّ، أي على غير نظام. بينما يعني الاختلاف أن يكون “على سُنَنٍ واحدة”. ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ما ترى في خلق الرحمان من تفاوت﴾[الملك-3] وقوله: ﴿وله اختلاف الليل والنهار﴾[المؤمنون-80]. وأما الفرق بين التنافي والتضاد، أن الأول لا يكون إلا بين شيئين يجوز عليهما البقاء، بينما يكون الثاني، – أي التضاد – بين ما يبقى وما لا يبقى. وكذلك الحال بالنسبة إلى الفرق بين الضدِّ والترك؛ فإن كلُّ تركٍ هو ضدٌ، وليس كلُّ ضِّدٍ تركًا، لأن فعل غيري – كما يوضحُ علماء اللسان- قد يضاد فعلي ولا يكون تركًا له2.
ترتيبًا على ما تقدَّم، يجد المنهج الجَمْعي العرفاني المؤيّد بالتضايف، ما يُسوِّغه لدى جمعٍ من الحكماء لمّا واءَموا بين الفلسفة والعرفان وعلوم الشريعة، ورأوا أن الإنسان متأثرٌ بعوالم ثلاثة هي: العالم العقلي، والعالم المثالي، والعالم الطبيعي. وبناء على قولهم، أن عروة وثقى تربط هذه العوالم بعضها إلى بعض، يستطيع العارف، وبوساطة كمال القوة النظرية التي يحرزها بالمجاهدات العقلية والعبادية، أن يستبصر معنى الخير المتعالي، ويسلك سبيله في الحياة المادية ومنها على الأخص، الحياة السياسية. ومثلما فعل الفارابي- على سبيل المثال- في كتاب “آراء أهل المدينة الفاضلة”، وابن سينا في “كتاب الشفاء”، سيمضي كل من السهروردي وملا صدرا الشيرازي إلى ربط منهجهم الطبيعي – الفلسفي بمسائل الوحي والغيب والنبوة والإمامة. من هذا النحو يفتتح المنهج العرفاني دُربةَ الجمعِ المفارق بين الحقائق الغيبية، والتدبيرات الواقعية في المجتمع الإنساني. هذا ما يتجلى في عقل النبي، ومنه إلى آل بيته، فالتابعين بإحسانٍ من الأولياء، وصولًا إلى خاتم الولاية المحمدية المطلقة الذي سيقود الإنسانية إلى حضارتها العادلة.
على هذا المنهج التأويلي لمقامات “الفقيه الأعلى”، أو “الولي الخاتم” “بالعارف الواصل” يقدم لنا حيدر أطروحته القاصدة جلاء ماهية الولي الخاتم وعلاقته بالنبوة والجدلية ما بين الوحدة والكثرة في الخلافة وحاكمية الشرع على الكشف، وتبيانًا لمهمة العارف وهو “مقام الفقيه الأعلى” يرى حيدر أن هذا المقام هو حاصل الإيمان الأقصى. وهو علم مخصوص يحصِّله الفقيه الأعلى بالعلم والعمل. فالعلم نظير العمل حيث لا يكون علم يستهدي بلا عمل، كما لا يصلح العمل بلا معرفة. والنظرية التي يتبناها في هذا الخصوص هي: أن كل مسألة لا يُبنى عليها عمل فالخوض فيها غير مستحسن، لذا فإن العلم المعتبر هو العلم الباعث على العمل.
على هذا النحو من التحليل يؤطر المفكر محمود حيدر جدلية العارف والمعروف في الارتباط الجذري بين فقه العلم بالله، وفقه المعرفة بمقاصد الحق في عالم الخلق. فعلى الولي الخاتم العارف الجمع بين الشريعة والحقيقة والطريقة من خلال الإيمان والعلم والعمل، وإذا ما بلغ هذه الدرجة من الفضل والقرب وجب عليه الرجوع إلى عالم الناس يدعوهم إلى الرشاد ومما فاض الحق عليه من الشريعة ومكارم الأخلاق عليهم من كرامات الحق بأوامره ونواهيه.
[1] محمود حيدر، العرفان في مقام التدبير السياسي، دراسة لم تنشر بعد، الصفحة 95.
[2] فيلسوف ومتصوف أندلسي (614هـ- 669هـ/1217م- 1269م)، اشتهر برسالته المعروفة بـ “المسائل الصقلية”، والتي كانت عبارة عن أجوبة لأسئلة أرسلها الإمبراطور فريدريك الثاني إلى الدولة الموحدِّية. كما ذاع صيته في أوروبا، وتعتبر فلسفته من المنعطفات الفكرية الكبرى في الفكر الفلسفي الإسلامي لجهة الجمع بين الفلسفة والعرفان وفتح الطريق على البحث الفلسفي في الحقل الديني.
[3] إبن سبعين، عبد الحق، بُدُّ العارف، تحقيق وتقديم: د. جورج كتورة، (بيروت: دار الأندلس ودار الكندي، الطبعة الأولى، 1978)، الصفحة 243.
[4] محمود حيدر نقلًا عن يد الله يزدان بناه، العرفان النظري، مبادؤه وأصوله، ترجمة: علي عباس الموسوي، (بيروت: مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي، 2014)، الصفحة 82.
[5] المصدر نفسه، الصفحة 84.
[6] يد الله يزدان بناه، العرفان النظري، مبادؤه وأصوله، مصدر سابق، الصفحة 84.
[7] المصدر نفسه، الصفحة 72.
[8] محمود حيدر، العرفان في مقام التدبير السياسي، مصدر سابق، الصفحة 98.
[9] المصدر نفسه، الصفحة 105.
[10] محمود حيدر، العرفان في مقام التدبير السياسي، مصدر سابق، الصفحة 106.
[11] أنظر: محمود حيدر، الفقيه الأعلى – واحدية الشرع والكشف في مهمة العارف الخاتم، (بيروت: دار المعارف الحكمية، 2015)، الصفحة 13.
[12] محمود حيدر، الفقيه الأعلى – واحدية الشرع والكشف في مهمة العارف الخاتم، مصدر سابق، الصفحة 15.
[13] المصدر نفسه، الصفحة 16.
[14] محمود حيدر، الفقيه الأعلى – واحدية الشرع والكشف في مهمة العارف الخاتم، مصدر سابق، نقلًا عنالهُجويري، كشف المحجوب، الجزء2، 451، 22. فالولي ابن وقته أي ليس له ماض يحزن عليه ولا مستقبل يخاف منه، راجع القشيري، لطائف الإشارات، مجلد3.
[15] محمود حيدر، المصدر نفسه، نقلًا عن القاشاني، اصطلاحات الصوفية، تحقيق: محمد كمال إبراهيم جعفر، الهيئة المصرية للكتاب، 2008، الصفحة 54. انظر كذلك الرسالة القشيرية، الجزء2، الصفحة 334.
[16] الفتوحات، طبعة صادر، الجزء2، الصفحة 53. وهو المفهوم نفسه عند القشيري، حيث يقول: إن الولي هو: “من يتولى الله سبحانه أمره، فلا يكله إلى نفسه لحظة، أو هو الذي يتولى عبادة الله وطاعته. أي هو الذي توالت طاعاته لربه، وارتفعت درجات قربه”، الرسالة القشيرية، الجزء 2، سبق ذكره، الصفحة 737.
ولابن عربي شرح خاص لمفهوم الولاية بمعنى النصرة من أن النصرة هنا تشمل المؤمنين كافة ﴿اللّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُواْ﴾ (البقرة: 257)، ليس المؤمنين الموحدين فقط، إنما تشمل حتى الكافرين والمشركين، يمكن الرجوع إلى شرح هذه الفكرة إلى شودكوفيتش، الصفحات 81- 83.
[17] القاشاني، اصطلاحات الصوفية، الصفحة 54. من المعاني الشائعة للولي القرب وهو مستوحى من القرآن الكريم ﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ﴾ (الواقعة:10-11).
[18] محمود حيدر، الفقيه الأعلى، مصدر سابق، الصفحة 37.
2 سورة المائدة، الآية 54.
3 الألوسي، روح المعاني، الجزء السادس، الصفحة 149.
4 محمود حيدر، الفقيه الأعلى، مصدر سابق، الصفحة 38
5 سورة الكهف، الآية 26.
1 سورة الأنبياء، الآية 107.
2 سورة سبأ، الآية 28.
3 شرح “فصوص الحكم”، مؤيد الدين الجندي، صححه وعلق عليه: جلال الدين الآشيتاني، ( قم: الطبعة الثانية، 1423هـ)، الصفحة 708.
4 محمود حيدر، الفقيه الأعلى، مصدر سابق، الصفحة 39.
5 شرح فصوص الحكم، فص حكمة فردية في كلمة محمدية، مصدر سابق، الصفحة 708.
1 شرح فصوص الحكم، فص حكمة فردية في كلمة محمدية، مصدر سابق، الصفحة 708.
2 المصدر نفسه، الصفحة 708.
3 سورة هود، الآية 17.
4 سورة الرعد، الآية 43.
1 سورة النساء، الآية 26.
2 سورة الرعد، الآية 11.
3 سورة محمد، الآية 7.
4 محمود حيدر، الفقيه الأعلى، مصدر سابق، الصفحة 40.
5 المصدر نفسه، الصفحة 41.
1 محمود حيدر، الفقيه الأعلى، مصدر سابق، الصفحة 85.
2 النفري، المواقف والمخاطبات، تحقيق: آرثر حنا آبري، (القاهرة: دار الكتب العربية، 1934)، الصفحة 81.
3 جمال أحمد سعيد المرزوقي، فلسفة التصوف، (بيروت: دار التنوير، 2007)، الصفحة 157.
1 “المواقف”، الصفحتان 12 و 88.
2 شرح المواقف، الصفحة 125.
3 “مختار الصحاح”، (الهيئة المصرية العامة للكتاب)، باب “عز”، الصفحة 429.
4 المصدر نفسه، الصفحة 86.
1 مختار الصحاح، مصدر سابق، الصفحة 86.
2 سورة البقرة، الآية 102.
3 جمال أحمد المرزوقي – فلسفة التصوف – المصدر نفسه ص 203.
4 المرزوقي، فلسفة التصوف – الصفحة 225.
1 محمود حيدر، الفقيه الأعلى، مصدر سابق، الصفحة 88.
2 سورة الكهف، الآية 65.
3 سورة فاطر، الآية 28.
4 سورة آل عمران، الآية 7.
1 ابن عربي، مواقع النجوم، (القاهرة: مطبعة السعادة، الطبعة1، 1335هـ)، الصفحة 25.
2 ابن عربي، الفتوحات المكية، (بيروت: دار صادر)، الجزء الأول، الصفحة 645.
3 المصدر نفسه، الصفحة 279.
4 رسائل ابن عربي، القطب والنقباء وعقلة المستوفز، رسالة ابن عربي إلى الفخر الرازي، تحقيق وتقديم: سعيد عبد الفتاح، (بيروت: دار الانتشار العربي، الطبعة1، 2002)، المجلد الثاني، الصفحة 207.
1 سورة الكهف، الآية 65.
2 رسائل ابن عربي، مصدر سابق، الصفحة 208.
3 محمود حيدر، الفقيه الأعلى، مصدر سابق، الصفحة 93.
4 سورة المائدة، الآية 66.
1 رسائل ابن عربي، مصدر سابق- ص 209.
2 محمود حيدر، الفقيه الأعلى، مصدر سابق، الصفحة 94.
1 راجع: محمود حيدر، العرفان في مقام التدبير السياسي، مصدر سابق، الصفحة 380.
2 محمود حيدر، العرفان في مقام التدبير السياسي، مصدر سابق، الصفحة 381.
[19] من محاضرة له تحت عنوان: “العرفان ودوره في إعادة تشكيل منظومة القيم” في إطار مؤتمر دولي انعقد في بيروت بتاريخ 3-4-2018.
2 المصدر نفسه.
3 المصدر نفسه.
4 من محاضرة له تحت عنوان: “العرفان ودوره في إعادة تشكيل منظومة القيم” في إطار مؤتمر دولي انعقد في بيروت بتاريخ 3-4-2018.
1 راجع: محمود حيدر، المواطنة الرحمانية، بحث قدِّم إلى الدورة الحادية عشرة للمؤتمر الدولي حول طرق الإيمان في مدينة قسنطينة – الجزائر تحت عنوان: “مدينة الله”، 19-20-21 ديسمبر (كانون الأول) 2015.
1 المواطنة الرحمانية، المصدر نفسه.
2 محمود حيدر، العرفان في مقام التدبير السياسي، مصدر سبق ذكره، الصفحة 450.
1 محمود حيدر، العرفان في مقام التدبير السياسي، مصدر سابق.
2 محمود حيدر، واجبية التعرف بين الحضارات والأديان، محاضرة في إطار المؤتمر الدولي الذي انعقد في جامعة باكو في جمهورية آذربيجان – بتاريخ 17-11-2016.
1 محمود حيدر، واجبية التعرف بين الحضارات والأديان، محاضرة في إطار المؤتمر الدولي الذي انعقد في جامعة باكو في جمهورية آذربيجان – بتاريخ 17-11-2016.
2 واجبية التعرف – المصدر نفسه.
3 المصدر نفسه.
1 محمود حيدر، واجبية التعرف بين الحضارات والأديان، المصدر نفسه.
2 المصدر نفسه.
1 محمود حيدر، واجبية التعرف – المصدر نفسه.
1 محمود حيدر، واجبية التعرف – المصدر نفسه.
2 المصدر نفسه.
_____________
د. ثريا بن مسمية*
* أستاذة فلسفة الفن والتصوف المقارن في جامعة الزيتونة – تونس.
بحث مقدم إلى الندوة الدولية التي أقيمت في بيت الحكمة في تونس تحت عنوان: “الذاتي والموضوعي في التجربة الصوفية”، بتاريخ 10 أفريل 2019.
*المصدر: التنويري.





