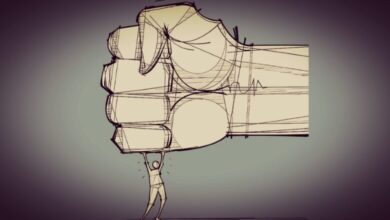مهاد إشكالي:
تعرضت المدرسة في الربع الأخير من القرن العشرين 20م، للكثير من النقد والهدم والدحض والتفنيد وإعادة النظر في قيمتها وحدودها وفائدتها أيضًا، ونخص بالذكر هنا منذ مطلع سنة 1970م وهو بالمناسبة تاريخ نشر كتاب Ivan Ilitch, Une société sans école أي كتاب “مجتمع بلا مدارس” لصاحبه إيفان إيليتش، ومن غريب الصدف وسخرية القدر أنه في نفس التاريخ، أي سنة 1970م سينشر لوي ألتوسير مقاله النقدي الشهير: Louis Althusser, L’État et les appareils idéologiques de l’État. هذا المقال الذي تجرأنا عليه اليوم وهو بالمناسبة يحتوي على 58 صفحة تقريباً، وذلك عبر قراءته وإعادة قراءته والنظر الفلسفي فيه، ذلك أننا بمجرد ما نحاول البحث عنه في مؤشرات البحث باللغة العربية، لا نجد ولو معلومة بسيطة عنه، لأنه للأسف الشديد لم يترجم بعد إلى لغة الضاد، لهذا فضلنا قراءته باللغة الفرنسية وهي بالمناسبة لغته الأصلية، وحاولنا البحث فيه عن ما يعالج إشكالنا الذي وضعناه كفرضية أولى قبل قراءة المقال، وعن إشكالنا بالمناسبة الذي نبحث عن جواب له نستشفه من مقال لوي ألتوسير هو كالآتي:
ما هي وجهة نظر لوي ألتوسير عن المدرسة ؟
أو ما هو النقد الذي وجهه لوي ألتوسير للمدرسة؟ إن لم نقل نقوداً بصيغة الجمع لا بصيغة الفرد، وبالتالي يصبح لدينا هنا نبش عن مكانة ومنزلة وقيمة ومرتبة المدرسة في صرح أو مقال لوي ألتوسير الشهير، والذي انطلاقا من عنوانه: الدولة والأجهزة الأيديولوجية للدولة يحيل على أنه بصدد الحديث عن نظرية للدولة وأجهزتها، أو كما عبر عنها هو الأجهزة الأيديولوجية للدولة Appareil idéologique de l’État. وفي حقيقة الأمر، هذا هو توجه المقال، وسيتضح لنا أكثر من خلال فهرس المحتويات الذي يتطرق إلى الموضوعات الكبرى التي يثيرها المقال، وهي كالآتي:
“فهرس المحتويات:
حول إعادة إنتاج شروط الإنتاج.
إعادة إنتاج وسائط الإنتاج.
إعادة إنتاج قوة العمل.
البنية التحتية والبنية الفوقية.
الدولة.
من النظرية الوصفية إلى النظرية العامة.
أساسيات النظرية الماركسية للدولة.
أجهزة الدولة الأيديولوجية ( AEI ).
حول إعادة إنتاج علاقات الإنتاج.
عن الأيديولوجية.
الأيديولوجية ليس لها تاريخ.
الأيديولوجيا هي “تمثيل” للعلاقة الخيالية بين الأفراد وظروف وجودهم الحقيقية.
الأطروحة الأولى: تمثل الأيديولوجيا العلاقة الخيالية بين الأفراد وبينهم.
ظروف وجودهم الحقيقية.
الأطروحة الثانية: الأيديولوجيا لها وجود مادي.
الأيديولوجية تتحدى الأفراد كمواضيع.
مثال: الأيديولوجية الدينية المسيحية.
أجهزة الدولة الأيديولوجية.” [1]
انطلاقاً من فهرس المحتويات أو فهرس الموضوعات، يتبين لنا أن المقال غَنِيٌّ ومُكَثَّفٌ بالمواضيع والموضوعات والأطروحات كذلك، فهو يتطرق لمواضيع ومفاهيم ومحتويات ومضامين مختلفة ومتنوعة ومتعددة لكنها تصب في حقل واحد، حيث يتطرق في أوله إلى مفهوم إعادة إنتاج شروط الإنتاج أو ظروف الإنتاج، ولا يخفى علينا أن هذه المفاهيم ذي صِبْغَةٍ وطبيعة ماركسية محضة، بل ليس هذا المفهوم الوحيد المتضمن في المقال والذي ينتمي لمصوغة الفكر الماركسي، بل كل تلك المفاهيم ( إعادة الإنتاج، شروط الإنتاج، ظروف الإنتاج، وسائط الإنتاج، قوة العمل، البنية التحتية والبنية الفوقية، أساسيات النظرية الماركسية، مفهوم الدولة، أجهزة الدولة الأيديولوجية،…إلى آخره) تصب كما قلنا في اتجاه ومعنى وحقل واحد هو حقل ماركس Champ de Marx ولدينا هنا وقفة طفيفة مع كارل ماركس من خلال التعرف أولاً على من يكون لوي ألتوسير بالمناسبة؟
لوي ألتوسير ( Louis Althusser ) (1918م – 1990م) هو فيلسوف فرنسي معاصر، أعاد النَّظَرَ في التُّرَاثَ الفلسفي الذي خَلَّدَهُ كارل ماركس، ويعد من القُرَّاءُ الكِبَارُ والْأَفْذَاذُ لماركس، بل نعده هنا من كِبَارِ المَاركسِيِينَ الشَّبَابِ والْجُدُدِ، وذلك من خلال استلهام معظم أفكاره وطروحاته من البِنْيَوِيَّةِ والتحليل النفسي العميق جداً، من بعض مؤلفاته التي خلفت أثاراً هائلة لدى الباحثين المتخصصين في الفكر الماركسي، نجد:
-دفاعاً عن ماركس (1965م)
– قراءة الرأسمال (1965م)
نشير هنا إلى أنه منذ سنة 1965م إلى سنة 1970م هي سنوات حاسمة جداً في فكر لوي ألتوسير، حيث سيشتهر فرنسيا ويذاع صيته، بوصفه من كبار القراء المعاصرين، والذين يمتلكون حِساً وروُحاً نَقْدِيَّةً عَمِيقَةً جِداً في القراءة والتعامل مع النصوص الماركسية، حيث أَنْطَقَهَا ما لَمْ تَكُنْ تُصَرِّحُ به لعموم القراء، وهذا ما يحسب له صراحة، خاصة كتاب كارل ماركس العمدة “رأسمال” والذي لم يكن يزعم أحد من القراء من الاقتراب منه ومحاولة نقده وفحصه وتمحيصه، نظراً لضخامته وتخصصه الفلسفي والاقتصادي والاجتماعي المحض، والذي يحتاج إلى غَوَّاصٍ ومتبحر في الفلسفة والعلوم الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية بصفة عامة، وما كان هذا الغواص والسباح المنقذ سوى لوي ألتوسير. ولديه كتاب ثالث عنوانه:
-<< عناصر النقد الذاتي >> (1975م) وهو أيضاً من الكتب التي نجد أنها تحتوي على نوع من العناصر والتركيبات والمكونات النقدية الأساسية التي تَنُمُّ عن المنهج الألتوسوري البنيوي النفسي.
انطلاقا إذن من بطاقته التعريفية وسيرته الذاتية، تكونت لدينا هنا نظرة أولية عن لوي ألتوسير حيث جعلنا منه ماركسيا جديدا، وفي حقيقة الأمر، أثناء قراءتك للمقال لا تستطيع حتى التمييز بين من يكتب هل لوي ألتوسير أم كارل ماركس، نقول عنه هنا، أنه ابتلع أفكار كارل ماركس ولم يستطع أن يتقيأ غيرها، روح كارل ماركس سَكَنَتْهُ سُكُوناً لا فراق منه.
لكن ليس هذا هو موضوع مقالنا، وليس أفكار ماركس ولا لوي ألتوسير ونظريته عن الدولة والمجتمع والصراع الطبقي والأيديولوجيا ونمط الإنتاج وعلاقات الإنتاج وشروط أو ظروف الإنتاج أو حتى إعادة الإنتاج … إلى آخره من المفاهيم والأفكار، لن نتطرق لكل هذا، فقط سنحاول العودة إلى إشكالنا المتعلق بنقده [ألتوسير دائماً] للمدرسة الرأسمالية، وهذا كما لاحظتم هو العنوان الذي اخترناه لمقالنا، وليس التطرق إلى نظرية الدولة لديه، أو علاقته بكارل ماركس، لكن مع ذلك، لا يمكن التعرف على نقد لوي ألتوسير للمدرسة دون التعرف على نقده للدولة والأجهزة الأيديولوجية للدولة، وللتعرف على كل هذا، المطلوب منا الآن أن نحدد لكم أولاً مجموع الإشكالات والالتباسات التي أثيرت في متن المقال، وحاول لوي ألتوسير الإجابة عنها بنفسه، لكن لن نركز على الجواب هنا، بقدر ما يهمنا الإشكال المعبر عنه بمجموعة من الأسئلة المنظمة الموجهة للتحليل والمناقشة النقدية وكيف طرح، وهو [أي الإشكال] كالآتي:
إشكالات الكتاب:
فما هو إذًا إعادة إنتاج ظروف الإنتاج؟
كيف يتم ضمان إعادة إنتاج القوى العاملة؟
الملاحظة الثانية هي أنه لكي نقوم بهذا المنعطف، علينا أن نطرح سؤالنا القديم مرة أخرى: ما هو المجتمع؟
ما هي أجهزة الدولة الإيديولوجية (AEI) ؟
ونحن نقول: لا ينبغي الخلط بين الهيئات المستقلة وجهاز الدولة (القمعي). ما هو الفرق بينهما؟
لكن إذا كان الأمر كذلك، فلا يسعنا إلا أن نسأل أنفسنا السؤال التالي، حتى في الحالة الموجزة لمؤشراتنا:
ما هو بالضبط مدى دور أجهزة الدولة الأيديولوجية؟
ماذا يمكن أن يكون أساس أهميتها؟ بمعنى آخر: ما الذي تتوافق معه “وظيفة” أجهزة الدولة الأيديولوجية هذه، التي لا تعمل على القمع، بل على الأيديولوجية؟
يمكننا بعد ذلك الإجابة على سؤالنا المركزي الذي ظل بلا إجابة لصفحات طويلة:
كيف يتم ضمان إعادة إنتاج علاقات الإنتاج؟
لماذا يعتبر الجهاز التعليمي في الواقع جهاز الدولة الإيديولوجي المسيطر في التشكيلات الاجتماعية الرأسمالية؟
وكيف يعمل؟
ما الأيديولوجيا ؟
هل للأيديولوجيا تاريخ ؟
لسوء الحظ، يترك هذا التفسير مشكلة صغيرة دون إجابة: لماذا “يحتاج” الناس إلى هذا النقل الخيالي لظروف وجودهم الحقيقية، “لتمثيل” ظروف وجودهم الحقيقية؟
إذا كان الأمر كذلك، فإن سؤال «سبب» التشويه الخيالي للعلاقات الحقيقية في الأيديولوجيا يسقط، ويجب استبداله بسؤال آخر: لماذا التمثيل المعطى للأفراد لعلاقتهم (الفردية) بالعلاقات التي تحكم ظروفهم؟ الوجود وحياتهم الجماعية والفردية، هل هو بالضرورة خيالي؟ وما طبيعة هذا الخيال؟
ملاحظة هامة: تجذر الإشارة هنا إلى أن هاته الإشكالات أو هذه الأسئلة المنظمة الموجهة للتحليل والمناقشة النقدية هي ليست من صنيعي، بل هي من صنيع لوي ألتوسير في مقاله، طرحها هكذا مشتتة في مقاله، وتشكل الخيط الناظم له، وحاولت تجريدها وجمعها، بغرض أن يتبين للقارئ الإشكال الذي هو بمثابة مُحَرِّكٍ للفيلسوف، ذلك أن هذا الأخير همه الوحيد هو إبراز وإثارة الإشكال وتحديد المشكلات لا حلها والجواب عنها !
والآن ننتقل مباشرة، بعد التعرف على الإشكالات التي وَتَّرَتْ مقاله النقدي، إلى عرض المعالم الكبرى لنظريته عن الدولة فقط من أجل فهم تصوره النقدي عن المدرسة، وتجذر الإشارة هنا إلى أننا سنستشهد بنصوص مطولة نوعاً ما، ذلك أننا ارتأينا أن النص المستشهد به كاملاً، يعبر عن روح فكرة ألتوسير، وبالتالي لا يمكن تجزيئه أو قسمه إلى إثنين، لأنه يفي غرضه عند الاستشهاد به كاملا لا ناقصا أو مجزئاً.
أما عن نظرية لوي ألتوسير للدولة، فيعرضها بالمناسبة بشكل متوافق تماماً مع تصور كارل ماركس لها، فيصرح قائلا: “”إن التقليد الماركسي شكلي: فقد تم تصور الدولة بشكل واضح من البيان الشيوعي والثامن عشر من برومير (وفي جميع النصوص الكلاسيكية اللاحقة، وخاصة من ماركس عن كومونة باريس، ومن لينين عن الدولة والثورة) كجهاز قمعي. الدولة هي “آلة” للقمع، تسمح للطبقات المهيمنة (في القرن التاسع عشر، الطبقة البرجوازية و”طبقة” كبار ملاك الأراضي) بضمان سيطرتها على الطبقة العاملة من أجل إخضاعها للمحاكمة ابتزاز فائض القيمة (أي الاستغلال الرأسمالي).” [2]. ونلحظ هنا، أن لوي ألتوسير يعرض لنا تصور الدولة من خلال النصوص الكلاسيكية الماركسية، كيف لا وهو من أفضل القراء النقديين المعاصرين لكارل ماركس، ويضيف إليه لينين، وهذا دليل على أن ألتوسير كان مهتما بقراءة التراث الماركسي واللينيني، وذلك بغرض تمييز مفهوم الدولة عن ما غيره، حيث أنه يحاول ما أمكن استخراج تصور الدولة من التراث الماركسي، ليضيف كذلك في نفس السياق: “فالدولة إذن هي قبل كل شيء ما أسْمَتْهُ كلاسيكيات الماركسية جهاز الدولة. تحت هذا المصطلح نفهم: ليس فقط الجهاز المتخصص (بالمعنى الضَّيِقِ) الذي أدركنا وجوده وضرورته بناءً على المتطلبات. الممارسة القانونية، أي الشرطة والمحاكم والسجون؛ ولكن أيضًا الجيش، الذي (دفعت البروليتاريا دمها ثمنًا لهذه التجربة) يتدخل مباشرة كقُوَّةٍ قَمْعِيَّةٍ إضافية في الحالة الأخيرة عندما “تطغى الأحداث” على الشرطة وأجهزتها المساعدة المتخصصة؛ وفوق هذا كله رئيس الدولة والحكومة والإدارة. ” [3].
نلمح لديه هنا، محاولته الجادة في التمييز بين مفهوم الدولة المكون من أجهزة، وسيشير هنا إلى الجيش بوصفه قُوَّةً قَمْعِيَّةً يتدخل عندما تطغى الأحداث وتخرج عن السيطرة، وذلك بغرض خدمة وضمان ديمومة الدولة نفسها، أو من أجل الدولة وفقط، ويشير أيضاً إلى قوى قمعية إضافية كرئيس الدولة والحكومة والإدارة والشرطة والمحاكم والسجون… إلى آخره. وكتدليل آخر، على أن لوي ألتوسير يقدم نظريته للدولة من خلال طروحات ماركس ولينين، نجد له إضافة أخرى، يعبر من خلالها على ” أن “نظرية” الدولة الماركسية اللِّينِينِيَّةِ، المقدمة بهذا الشكل، تمس الجوهر، وليس هناك مجال للحظة واحدة لعدم إدراك أن هذا هو الجوهر بالفعل. إن جهاز الدولة، الذي يعرف الدولة كقوة تنفيذ وتدخل قمعي، “في خدمة الطبقات المهيمنة”، في الصراع الطبقي الذي تقوده البرجوازية وحلفاؤها ضد البروليتاريا، هو في الواقع الدولة، ويحدد بالفعل “وظيفتها” الأساسية. ” [4]. وهذه إشارة صريحة على أن لوي ألتوسير تَشَرَّبَ هذه النزعة الماركسية واللينينية التي تعرف الدولة بإعتبارها قوة تنفيذ وتدخل قمعي يعمل في خدمة الطبقات المهيمنة، التي هي الطبقة البرجوازية وحلفاؤها ضد الطبقة البروليتاريا الفقيرة والمهمشة والتي تفتقر لوسائل الإنتاج، بل يركز على أن هذه هي المهمة المنوطة والوظيفة الأساسية للدولة، أما عن إضافاته الأخرى، حيث يُقِرُّ قائلا: ” دعونا نوضح أولاً نقطة مهمة: الدولة (ووجودها في أجهزتها) ليس لها معنى إلا باعتبارها وظيفة لسلطة الدولة.
إن صراع الطبقة السياسية برمته يدور حول الدولة. دعونا نفهم: حول الاعتقال ، أي الاستيلاء على سلطة الدولة والاحتفاظ بها، من قبل طبقة معينة، أو من خلال تحالف الطبقات أو أجزاء من الطبقات. ولذلك فإن هذا التوضيح الأول يلزمنا بالتمييز بين سلطة الدولة (الحفاظ على سلطة الدولة أو الاستيلاء على سلطة الدولة)، وهدف الصراع الطبقي السياسي من جهة، وجهاز الدولة في مكان آخر. ” [5]. ما يثيره هنا بشكل صريح هو إشكالية الصراع بين الطبقات حول السلطة السياسية وتملكها والاحتفاظ بها واحتكارها واحتلالها من طرف طبقة معينة بغرض السيطرة على موازين الدولة، لكنه سرعان ما سيعمل على التمييز بين الدولة كجهاز والسلطة كمفهوم، أثناء قوله: “يمكننا القول أن هذا التمييز بين سلطة الدولة وجهاز الدولة هو جزء من “النظرية الماركسية” عن الدولة، وبشكل واضح منذ 18 برومير وكتاب ماركس ” الصراع الطبقي في فرنسا” . ولتلخيص “النظرية الماركسية للدولة” حول هذه النقطة، يمكننا القول إن كلاسيكيات الماركسية أكدت دائما على ما يلي:
1) الدولة هي جهاز الدولة القمعي؛
2) من الضروري التمييز بين سلطة الدولة وجهاز الدولة؛
3) يتعلق هدف الصراع الطبقي بسلطة الدولة، وبالتالي، باستخدام الطبقات (أو تحالف الطبقات، أو الفصائل الطبقية) التي تملك سلطة الدولة، جهاز الدولة وفقًا لأهدافها الطبقية؛
4) يجب على البروليتاريا أن تستولي على سلطة الدولة لتدمير جهاز الدولة البرجوازي القائم، وأن تستبدله، في المرحلة الأولى، بجهاز دولة بروليتاري مختلف تماما، ثم في مراحل لاحقة تطبق عملية جذرية، وهي عملية تدمير الدولة. الدولة (نهاية سلطة الدولة وكل أجهزة الدولة).” [6]. وفي هذه الفقرة بالضبط نجده يقر بالأطروحة الماركسية الداعية إلى أنه في نهاية المطاف، أي بعد وصول الطبقة البروليتاريا للسلطة والسيطرة عليها، يجب عليها أن تعمل فيما بعد على تدمير الدولة، وبالتالي إعلانه بصريح العبارة الماركسية التي تدعوا إلى رفض الدولة، ونهاية السلطة، والقضاء على كل أجهزة الدولة، وهي كما نلحظ أطروحة ثورية تثور ضد الدولة والسلطة وأجهزتها وترفضها بالإجماع والإجمال، ليأتي فيما بعد ليعرض تصوره هو من خلال “لتعزيز نظرية الدولة، من الضروري أن نأخذ في الاعتبار ليس فقط التمييز بين سلطة الدولة وجهاز الدولة، ولكن أيضًا واقعًا آخر يقف بوضوح إلى جانب جهاز (القمع) للدولة، ولكن لا ينبغي يكون الخلط معها. وسنسمي هذا الواقع بمفهومه: أجهزة الدولة الأيديولوجية.
ما هي أجهزة الدولة الأيديولوجية (AIE)؟
ولا ينبغي الخلط بينه وبين جهاز الدولة (القمعي). تذكروا أن جهاز الدولة في النظرية الماركسية يشمل: الحكومة، الإدارة، الجيش، الشرطة، المحاكم، السجون، إلخ، والتي تشكل ما سنسميه من الآن فصاعدا جهاز الدولة القمعي. ويشير القمع إلى أن جهاز الدولة المعني “يعمل بالعنف”، على الأقل في حدوده (لأن القمع، الإداري على سبيل المثال، يمكن أن يتخذ أشكالا غير مادية).” [7] وسنحاول أيضاً أن نضيف الفقرة التي تلت هذه كما هي نظراً لأهميتها، لأنه في هاتين الفقرتين بالضبط يعرض تصوره لمفهوم الدولة وأجهزة الدولة الأيديولوجية، فيضيف “نحن نحدد من خلال جهاز الدولة الأيديولوجي عددًا معينًا من الحقائق […] ، يمكننا في الوقت الحالي اعتبار المؤسسات التالية بمثابة أجهزة الدولة الأيديولوجية (الترتيب الذي ندرجها به هنا ليس له معنى خاص):
– AIE الجهاز الديني (نظام الكنائس المختلفة)؛
– الجهاز المدرسي AIE (نظام “المدارس” المختلفة، العامة والخاصة)؛
– الجهاز العائلي AIE ;
– AIE الجهاز القانوني ;
– AIE الجهاز السياسي (النظام السياسي، بما في ذلك الأحزاب المختلفة)،
– النقابات AIE؛ AIE الجهاز الإعلامي (الصحافة والإذاعة والتلفزيون، وما إلى ذلك)؛
– AIE الجهاز الثقافي (الرسائل والفنون الجميلة والرياضة وما إلى ذلك). ” [8].
كإشارة هنا أن “القانون” ينتمي إلى كل من جهاز الدولة (القمعي) ونظام جهاز الدولة الأيديولوجي AIE.
أما عن خلاصات هذه الفقرة، فيمكن القول هنا، أن الدولة -حسب ألتوسير- يمكن اعتبارها مجموعة من الأجهزة:
1-جهاز قمعي يتكون من:
حكومة، إدارة، جيش، شرطة، سجون، … إلى آخره. (جهاز ذي طبيعة عنيفة).
2-جهاز أيديولوجي يتكون من: المدرسة، العائلة، الإعلام، النقابة، الأحزاب السياسية، الكنائس، الجمعيات الثقافية، … إلى آخره. (جهاز لطيف وليس ذي طبيعة عنيفة، بل يمارس عنفا رمزيا على متلقيه، بالمعنى البورديوي من بيير بورديو لمفهوم العنف الرمزي).
ومن هنا نفهم إدراج لوي ألتوسير لمؤسسة المدرسة أو الجهاز المدرسي بوصفه جهاز أيديولوجي يعمل لصالح الدولة، بل تعمل الدولة من خلاله على ترسيخ أيديولوجيتها وتوجهاتها في أذهان المتعلمين وبهذا يصبح المتعلم مُؤَدْلَجاً حاملاً لمجموعة من الأفكار والتمثلات والمعتقدات والقيم، ليست أفكاره بل هي أفكار غُرِسَتْ فيه بواسطة المدرسة والتعليم.
وتجذر الإشارة إلى أن مفهومي الجهاز والأيديولوجيا يشيران إلى:
الجهاز: تعني كلمة جهاز مؤسسة أو هيئة ذات كيان مستقل، مثل جهاز أو مؤسسة أو هيئة الحكومة.
الإيديولوجيا: منظومة من الأفكار والتمثلات والمعتقدات التي تتراوح بين الوعي واللاوعي، والتي تعبر عن وضع ومطامح وتصورات ومصالح مجموعة اجتماعية أو عرقية أو مهنية معينة أو ذات خصوصية ما .
أما عن دور كل جهاز من أجهزة الدولة، فنقرأ عنده أن “كل جهاز من أجهزة الدولة، سواء كان قمعيا أم أيديولوجيا، يشتغل ويؤدي وظيفته بالعنف [سواء كان عنفاً ماديا فيزيائياً أو عنفاً رمزياً كما أخبرنا بذلك بيير بورديو] وبالأيديولوجيا في نفس الوقت، لكن مع فارق هام جدا هو عدم ضرورة الخلط بين الأجهزة الأيديولوجية للدولة والجهاز (القمعي) للدولة.” [9]. وسنقف هنا في آخر ما ورد، حيث ينصحنا لوي ألتوسير بالتمييز وضرورة عدم الخلط بين الأجهزة الأيديولوجية للدولة والجهاز القمعي للدولة، وكنا قد ميزنا سابقاً بينهما.
كما نجد لدى لوي ألتوسير تمييزاً آخر هو ذلك المتمثل في التمييز بين المجال العام Domaine public والمجال الخاص Domaine privé فالأول هو مجال الدولة العام، بينما الثاني هو مجال المؤسسات الخصوصية والخاصة، هذا التمييز في حقيقة الأمر يحسب له، ذلك أننا لم نكن من قبل نتحدث بهذه الدقة عن هذا التمييز بين هذين المجالين، وإن كنا نميز، فلا نشير بهذه الدقة إلى تخصيص كل من الدولة وأجهزتها كل بمجالاته الخاصة، حيث عبر عنها بأنه ” في لحظة ثانية، يمكننا أن نلاحظ أنه في حين أن جهاز الدولة الموحد (القمعي) ينتمي بالكامل إلى المجال العام، فإن غالبية جهاز الدولة الأيديولوجي (في تشتته الظاهري) يقع على عكس المجال الخاص. القطاع الخاص هو الكنائس، والأحزاب، والنقابات، والأسر، وبعض المدارس، ومعظم الصحف، والمؤسسات الثقافية، وما إلى ذلك،” [10].
سيحاول لوي ألتوسير أن يعمل على التمييز بشكل أكثر حدة ودقة بين طريقة عمل كل من أجهزة الدولة القمعية وأجهزة الدولة الأيديولوجية، ذلك أنه في حقيقة الأمر ما يرغب فيه ويريده هو أن يحصل التمييز لدى المتلقي، كي لا يعيد الخلط بين المفاهيم ولا يساء أيضاً فهم ما أراد هو التعبير عنه، لهذا تجده يميز ويفرق بين طريقة عمل كل مفهوم أورده في مقاله تجنبا لوقوع طروحاته للاختزال وسوء الفهم أو الحكم عليها بأنها مجرد اجترار لأفكار كارل ماركس، ذلك أن جهد ألتوسير كان أكثر دقة، فهو لديه معجم مفاهيمي تقني خاص به، واستعمال تقني فيه نوع من الابداع والابتكار والجدة لأفكار ماركس، حيث أن هذا الأخير طرح أفكاره وعرضها بشكل تلقائي في عمله الشهير ” رأسمال “، ليأتي فيما بعد قارئه وشارحه وناقده لوي ألتوسير ليعيد ترتيب وتنظيم وتنسيق هذه المفاهيم من جديد ، ويضفي عليها إستعمالا جديداً أكثر دقة وصرامة وتأصيلا، لهذا نجده يحث علينا بقوله: “ولكن دعونا نصل إلى هذه النقطة. ما يميز الكيانات المستقلة عن جهاز الدولة (القمعي) هو الفرق الأساسي التالي:
جهاز الدولة القمعي “يعمل بالعنف”،
في حين أن أجهزة الدولة الأيديولوجية تعمل “بأيديولوجية” العنف.[…] وذلك لأن جهاز الدولة (القمعي) يعمل بطريقة تهيمن بشكل كبير على القمع (بما في ذلك القمع الجسدي)، بينما يعمل بشكل ثانوي في الأيديولوجية. (لا يوجد جهاز قمعي بحت). أمثلة: يعمل الجيش والشرطة أيضًا على أساس أيديولوجي، سواء لضمان تماسكهما وتكاثرهما، أو من خلال “القيم” التي يقدمانها للعالم الخارجي.
وبنفس الطريقة، ولكن على العكس من ذلك، يجب أن نقول إن أجهزة الدولة الأيديولوجية، على حسابها الخاص، تعمل بطريقة سائدة على نطاق واسع للأيديولوجية ، ولكنها تعمل بشكل ثانوي بالنسبة للقمع، حتى لو كان ذلك هو الحد الأقصى، ولكن فقط عند الحد الأقصى. ، مخففة جدًا، مخفية، وحتى رمزية. (لا يوجد جهاز أيديولوجي بحت.) وهكذا فإن المدرسة والكنائس “تدرب” بواسطة الأساليب المناسبة للعقوبات والاستبعاد والاختيار، وما إلى ذلك، ليس فقط مسؤوليها، ولكن أيضًا المنتمين. إذن الأسرة …، والجهاز الثقافي [يُمَارِسَانِ نَوْعاً من] (الرَّقَابَةِ، على سبيل المثال لا الحصر)، وما إلى ذلك. ” [11]. ونقف هنا إلى آخر ما انتهى إليه، أثناء قوله أن كلا من الأسرة والمدرسة والجهاز الثقافي، …إلى آخره يمارسان نوعاً من الرقابة على سبيل المثال، ذلك أن المتعلم في مؤسسة المدرسة يخضع للكثير من القيود والرقابة والمراقبة المستمرة على سلوكياته وتصرفاته وأفعاله وأقواله وآرائه، مما يجعله ذلك وكأنه مسجون داخل تلك المؤسسة المدرسية، فيفقد أهم شيء هي حريته وَحَرَكِيَّتَهُ، نسقط نفس الأمر على المؤسسات الثقافية أو الجمعيات، التي هي بدورها تعمل على ممارسة نوع من الرقابة على المنخرط للجمعية خاصة الأطفال، وبهذا يتم سجن الطفل داخل هذا النوع من الجمعيات الثقافية وتقييده وتقويض حريته، أي حركيته التي هي خاصية جوهرية في الطفل، حيث أن من التعريفات الشهيرة للطفل بأنه كائن حركي، إلا أن المؤسسات تعمل على تثبيته لا على تحريره!
لينتقل فيما بعد مباشرة إلى الحديث عن أشكال عمل أجهزة الدولة سواء القمعية أو الأيديولوجية، ونحن هنا نريد التركيز فقط على شكل عمل جهاز الدولة الأيديولوجي المتمثل في جهاز المدرسة، حيث أن هذا الأخير يعمل بطريقة سائدة متعارف عليها ومتفق عنها بين جميع أفراد المجتمع، كما أن المدرسة ليست بذلك الفضاء الذي يحتوي الصراعات الطبقية بين الطبقة البرجوازية والطبقة البروليتاريا، فالمدرسة هي فضاء ناعم جدا وخصب وثري له قواعده الخاصة، يخلوا من الصراع الطبقي، وحتى إن كان هناك صراع طبقي داخله [أي داخل جهاز المدرسة] فهو صراع خفي ومضمر وغير ظاهر للعيان، أو قد يظهر في بعض الأحيان لكن بحدة قليلة ومتشظية عما هو موجود في المجتمع، فالصراع الحقيقي مكانه هو حلبة المجتمع والتاريخ والاقتصاد والسياسة، وليس المدرسة، أما عن جهاز الدولة القمعي للدولة فهو الشكل الوحيد الذي يلعب على ضمان التنظيم المركزي، وتحقيق نوع من النظام والرتابة Monotonie داخل جسم المجتمع، ونترككم الآن عن أشكال عمل أجهزة الدولة كما عبر عنها لوي ألتوسير وهي كالتالي:
“1. تعمل جميع أجهزة الدولة في نفس الوقت على القمع وعلى الأيديولوجية، مع هذا الاختلاف المتمثل في أن جهاز الدولة (القمعي) يعمل بشكل طاغٍ على القمع، في حين أن الأجهزة الأيديولوجية في الدولة تعمل بطريقة سائدة على نطاق واسع للأيديولوجية.
2. في حين يشكل جهاز الدولة (القمعي) كلاً منظماً يتمركز أعضاؤه المختلفون تحت وحدة القيادة، فإن
سياسة الصراع الطبقي التي يطبقها الممثلون السياسيون للطبقات المهيمنة الذين يملكون سلطة الدولة، أجهزة الدولة الأيديولوجية متعددة ومتميزة و”مستقلة نسبيا” وقادرة على توفير مجال موضوعي للتناقضات التي تعبر، بأشكال محدودة أحيانا وأحيانا متطرفة، عن آثار الصدامات بين الصراع الطبقي الرأسمالي والصراع الطبقي البروليتاري، فضلا عن أشكالهما التابعة.
3. في حين يتم ضمان وحدة جهاز الدولة (القمعي) من خلال تنظيمه المركزي الموحد تحت قيادة ممثلي الطبقات الحاكمة، وتنفيذ سياسة الصراع الطبقي للطبقات الحاكمة، فإنه يتم ضمان الوحدة بين أجهزة الدولة الأيديولوجية المختلفة. ، في أغلب الأحيان بأشكال متناقضة، من قبل الأيديولوجية السائدة، أي أيديولوجية الطبقة الحاكمة.” [12].
لكن ما يميز موقف لوي ألتوسير هو أنه موقف ركز كثيراً على نظرية الدولة وأجهزتها، حيث من خلال هذه الأجهزة سيتطرق للمدرسة كجهاز أيديولوجي، لكن ما نود هنا الإشارة إليه، هو أن جهاز الدولة القمعي هو المسؤول الأول والوحيد عن ضمان الشروط السياسية إما من خلال قوته القمعية أو من خلال أيديولوجيته الناعمة المتمثلة في ذلك العنف الرمزي اللطيف الذي يمارسه، وبهذا فجهاز الدولة القمعي هو المسؤول حتما عن إعادة إنتاج علاقات الإنتاج التي هي علاقات الاستغلال الرأسمالي، والتي هي مسؤولة عن الصراع الطبقي الحادم بين الطبقة البرجوازية والطبقة البروليتاريا، كما أنه توجد في جذور الدولة الرأسمالية سلالات من السياسيين ورجال الأعمال والاقتصاد وقياد عسكريين هم المسؤولين عن التحكم في مجريات سفينة الدولة، يصعب اقتلاعهم لأنهم متأصلين في الجذور، ولهذا يعملون على قمع وردع كل محاولة لانتشالهم وانتصالهم، ومن هنا تلعب الأيديولوجية السائدة أو المهمينة المتمثلة في الطبقة البرجوازية دوراً هاما في هذا الجهاز، أي جهاز الدولة القمعي، حسب لوي ألتوسير دائماً، وعبر عن فكرته على الشكل الآتي:
“يتمثل دور جهاز الدولة القمعي بشكل أساسي، كجهاز قمعي، في ضمان الظروف السياسية بالقوة (المادية أو غير المادية) لإعادة إنتاج علاقات الإنتاج التي هي في نهاية المطاف علاقات استغلال. لا يساهم جهاز الدولة بجزء كبير جدًا في إعادة إنتاج نفسه فحسب (توجد في الدولة الرأسمالية سلالات من السياسيين، وسلالات عسكرية، وما إلى ذلك)، ولكن أيضًا، وقبل كل شيء، يضمن جهاز الدولة من خلال القمع (من القوة الجسدية الأكثر وحشية للأوامر والمحظورات الإدارية البسيطة، والرقابة المفتوحة أو الضمنية، وما إلى ذلك)، والشروط السياسية لممارسة جهاز الدولة الأيديولوجي.
إنهم هم الذين يضمنون، إلى حد كبير، إعادة إنتاج علاقات الإنتاج، تحت “درع” جهاز الدولة القمعي. وهنا يلعب دور الأيديولوجية المهيمنة، أي دور الطبقة الحاكمة، التي تملك سلطة الدولة، دورًا هائلاً.” [13].
ولم يكتفي لوي ألتوسير، بالعودة إلى مفهوم الدولة الآني والمعاصر وتصورات أجهزته الأيديولوجية الحالية، بل يضرب لنا مثالاً من التاريخ العميق لهذا التصور، حيث نجد جذوراً له منذ العصور الوسطى القروسطوية الذي عرف بسلطة الكنيسة وهيمنة البابا، ذلك أن الكنيسة في شخص البابا هي من كانت تمتلك طبيعة السلطة الدينية، مما أتاح لها السيطرة على باقي أنواع السلط الأخرى (القانونية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية… إلى آخره من أنواع السلط)، هذا الجمع بين السلط، جعل من الكنيسة تشكل روح وجوهر الدولة، وهكذا بعد استقلال الدولة عن سلطة الكنيسة، المتمثل في فصل الدين عن الدولة كما تجلى عبر التاريخ، وبهذا استقلت وفصلت سلطة الدولة عن سلطة الكنيسة، وثم تهميش هذه الأخيرة، ووضع حدود لسطوتها مع نهاية القرن الثامن عشر 18م، وبنفس منطق الكنيسة ستعمل الدولة عبر مجموعة من الأجهزة التي اعتبرها ألتوسير أجهزة أيديولوجية على مد سيطرتها وهيمنتها على السلطة وبسط النفوذ عليها، وهكذا نفهم كيف تمت هذه العملية، حيث أخذت الدولة مكان الكنيسة، وأصبحت محتكرة للسلطة والعنف، ويعبر عن كل هذا ألتوسير قائلاً: ” لقد أدرجنا في الواقع، في التشكيلات الاجتماعية الرأسمالية المعاصرة، عددًا كبيرًا نسبيًا من أجهزة الدولة الأيديولوجية: الجهاز التعليمي، الجهاز الديني، جهاز الأسرة، الجهاز السياسي، جهاز النقابات، جهاز المعلومات، الجهاز الثقافي. ، إلخ. ومع ذلك، في التشكيلات الاجتماعية لنمط الإنتاج “العمالي” (المعروف عمومًا بالإقطاعية)، نلاحظ أنه إذا كان هناك جهاز دولة قمعي واحد، فهو متشابه جدًا من الناحية الرسمية، ليس فقط منذ الملكية المطلقة، ولكن أيضًا منذ أول نظام معروف. أما الدول القديمة، التي نعرفها، فإن عدد أجهزة الدولة الأيديولوجية أقل وتختلف فرديتها. نلاحظ على سبيل المثال أنه في العصور الوسطى، جمعت الكنيسة (الجهاز الأيديولوجي للدولة الدينية) عددًا من الوظائف التي آلت اليوم إلى العديد من الأجهزة الأيديولوجية المتميزة للدولة، وعلاقات جديدة بالماضي نستحضرها، ولا سيما الوظائف التعليمية والثقافية. ” [14].
وتجذر الإشارة هنا إلى أن لوي ألتوسير ركز كثيراً على هذه اللحاظ التاريخي العظيم، أقصد تلك الفترة الانتقالية لأوروبا من القرن الرابع عشر ميلادي إلى القرن الثامن عشر ميلادي، والتي شكلت لحظات عصر النهضة وحركة الإصلاح الديني بزعامة مارتن لوثر والفترة الحديثة وعصر الأنوار، كل هذه الثورات دخلت في حوار مع العصر الوسيط وبالضبط سلطة الكنيسة التي كان الطموح الأول هو تقويضها وتقييدها والحد منها، والتحرر ليس فقط من سلطة رجال الدين، بل من الدين نفسه! وهكذا عبر عن ذلك لوي ألتوسير حين نقرأ له: ” ومع ذلك، في الفترة التاريخية ما قبل الرأسمالية التي ندرسها بعبارات واسعة جدًا، من الواضح تمامًا أنه كان هناك جهاز دولة أيديولوجي مهيمن، الكنيسة، التي ركزت في نفسها ليس فقط على الوظائف الدينية، ولكن أيضًا على الوظائف التعليمية جزء كبير من وظائف الاتصال و”الثقافة”. إذا كان الصراع الأيديولوجي برمته من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر، منذ الانتفاضة الأولى للإصلاح، يتركز في صراع مناهض لرجال الدين ومناهض للدين، فهذا ليس من قبيل الصدفة، بل هو نتيجة للموقف المهيمن للحركة الإصلاحية. هو جهاز أيديولوجي للدولة الدينية. ” [15]
والآن سنفرد فقرة طويلة نوعا ما، لكنها غنية ومتنوعة ومتعددة تساعدنا في شرح كل تلك التحولات التوترية التي وقعت بعد الثورة الفرنسية الشهيرة سنة 1789م، حيث يقر فيها: ” كان للثورة الفرنسية، قبل كل شيء، هدف ونتيجة ليس فقط نقل سلطة الدولة من الأرستقراطية الإقطاعية إلى البرجوازية الرأسمالية التجارية، بل تفكيك جهاز الدولة القمعي القديم جزئيًا واستبداله بجهاز جديد (مثل الحزب الوطني الشعبي، الجيش)، ولكن أيضًا لمهاجمة الجهاز الأيديولوجي للدولة رقم 1: الكنيسة. ومن هنا جاء الدستور المدني لرجال الدين، ومصادرة ممتلكات الكنيسة، وإنشاء أجهزة دولة أيديولوجية جديدة لتحل محل جهاز الدولة الديني الأيديولوجي في دوره المهيمن.
وبطبيعة الحال، لم تحدث الأمور من تلقاء نفسها: كما يتضح من المعاهدة، وعودة الملكية، والصراع الطبقي الطويل بين الطبقة الأرستقراطية المالكة للأراضي والبرجوازية الصناعية طوال القرن التاسع عشر، من أجل إرساء الهيمنة البرجوازية على الوظائف التي كانت تؤديها في السابق الكنيسة: قبل كل شيء بالمدرسة. يمكننا القول إن البرجوازية اعتمدت على الجهاز الأيديولوجي الجديد للدولة السياسية الديمقراطية البرلمانية، الذي تم وضعه في السنوات الأولى للثورة، ثم تم استعادته بعد صراعات عنيفة طويلة، بعد بضعة أشهر في عام 1848م ، وخلال عقود بعد الثورة. سقوط الإمبراطورية الثانية، من أجل قيادة المعركة ضد الكنيسة والاستيلاء على وظائفها الأيديولوجية، أي باختصار ضمان ليس فقط هيمنتها السياسية، ولكن أيضًا هيمنتها الأيديولوجية الضرورية لإعادة إنتاج علاقات الإنتاج الرأسمالية. ” [16].
كل هذه التحولات في حقيقة الأمر لم تحدث صدفة، بل كان الغاية منها في نهاية المطاف هو استقلال مفهوم الدولة عن هيمنة الكنيسة والسلطة البابوية، وذلك بغرض تَشَكُّلِ مفهوم جديد أو رؤية جديدة للدولة والأجهزة الأيديولوجية لها !
والآن بعد أن اتضحت معالم وأسس ومرتكزات نظرية الدولة والأجهزة الأيديولوجية للدولة لدى لوي ألتوسير، سننتقل بشكل مباشر الآن وصريح للتطرق إلى مجمل النقود الموجهة للمدرسة الرأسمالية، دائما من خلال مقاله النقدي، وهي كالآتي: “ولهذا السبب نعتقد أنه يحق لنا تقديم الأطروحة التالية، مع كل المخاطر التي ينطوي عليها ذلك. ونعتقد أن جهاز الدولة الأيديولوجي الذي وُضع في موقع الهيمنة في التشكيلات الرأسمالية الناضجة، نتيجة صراع طبقي سياسي وأيديولوجي عنيف ضد جهاز الدولة الأيديولوجي القديم المسيطر، هو جهاز الأيديولوجية المدرسية.” [17]. وهذا اعتراف خطير جداً من ألتوسير على أن المدرسة هي الجهاز الأيديولوجي الأول للدولة الذي حل محل الكنيسة، وله مبرراته في ذلك، حيث يضيف أيضًا “ولذلك نعتقد أن لدينا أسبابًا قوية للاعتقاد بأنه، خلف ألعاب جهاز الدولة الأيديولوجي السياسي، الذي احتل مقدمة المسرح، ما وضعته البرجوازية كجهاز الدولة الأيديولوجي رقم 1، وبالتالي المهيمن، هو الجهاز التعليمي، الذي حل في الواقع محل جهاز الدولة الأيديولوجي القديم المهيمن، أي الكنيسة. يمكننا أيضًا أن نضيف: لقد حل الزوجان من المدرسة والعائلة محل الزوجين من الكنيسة والعائلة.” [18]، وهذا إقرار آخر على أن المدرسة والعائلة حلت محل الكنيسة والعائلة، بما يفيد أن العائلة بقيت محلها، وحلت محل الكنيسة المدرسة ! خطير جدا هذا التعبير.
وهنا أيضًا سننتقل إلى أحد الإشكالات التي أثارها لوي ألتوسير بنفسه في متنه، وجشم من عناء نفسه في الرد عليها مباشرة، بثلاثة ردود اكتفينا بذكر إثنين منهما فقط رأينا أنهما مهمين كثيراً، وتجذر الإشارة هنا أنه عندما تلمح من فيلسوف معين في متنه أنه طرح سؤالا إشكاليا معينا، وأردف الإجابة عنه مباشرة وبشكل صريح دون لف ودوران، اعرف حينها، أنه سبق وأن كتب هذا السؤال في مسودته، وكان هاجسه قبل كتابة المقال أن يجب عنه، وها قد سنحت له الفرصة ذلك، لنقف عند السؤال ونرى طريقة الجواب عنه.
“لماذا يعتبر الجهاز التعليمي في الواقع جهاز الدولة الإيديولوجي المسيطر في التشكيلات الاجتماعية الرأسمالية وكيف يعمل؟
ويكفي الآن أن نقول:
1. جميع أجهزة الدولة الإيديولوجية، مهما كانت، تساهم جميعها في النتيجة نفسها: إعادة إنتاج علاقات الإنتاج، أي علاقات الاستغلال الرأسمالي.
2. كل واحد منهم يساهم في هذه النتيجة الفريدة بطريقته الخاصة. الجهاز السياسي من خلال إخضاع الأفراد للأيديولوجية السياسية للدولة، أي الإيديولوجية “الديمقراطية” أو “غير المباشرة” (البرلمانية) أو “المباشرة” (الاستفتائية أو الفاشية). يقوم جهاز المعلومات بتغذية جميع “المواطنين” بجرعات يومية من القومية والشوفينية والليبرالية والأخلاق وما إلى ذلك من خلال الصحافة والإذاعة والتلفزيون. الأمر نفسه ينطبق على الجهاز الثقافي (دور الرياضة في الشوفينية هو من الدرجة الأولى)، الخ. الجهاز الديني من خلال التذكير في الخطب وغيرها من الاحتفالات الكبرى بذكرى ميلاد المسيح والزواج والوفاة بأن الإنسان ليس سوى رماد، ما لم يعرف كيف يحب إخوته إلى درجة إدارة الخد الآخر لمن يصفع أولاً. جهاز العائلة… دعونا لا نصر[…]. ” [19].
وينتقل بنا لوي ألتوسير فيما بعد، ليقوم بعملية وصف خطيرة جداً ودقيقة ومنظمة أيضاً عن طريقة عمل المدرسة بوصفها جهازاً أيديولوجياً رقم 1 بإمتياز، حيث تلعب دوراً أساسياً جداً في ضمان إعادة الإنتاج، فتعمل على أَدْلَجَةِ وغسل دماغ الطفل منذ نعومة أظافره إلى بلوغ السنة السادسة عشرة تقريبًا من عمره، هذه المدة الزمنية ليست بالسهلة أو الهينة، ذلك أنها من الممكن من خلالها أن ننتج إما جيشا من الثوار الذين يرفضون الوضعية القائمة والحالية ويتطلعون نحو تحسين الأوضاع نحو الأفضل، أو جيشا من العبيد الخاضعين للنظام، وليس في مستطاعهم القيام بأي شيء، يكتفون بالقول سمعنا وأطاعنا غفرانك سيدنا الرأسمالي وإليك المصير، وهذا في حقيقة الأمر ما ترغب فيه الرأسمالية المتوحشة وتصبوا إليه، والآن نترككم مع النص ينطق بما في داخله من نقود على المدرسة الرأسمالية المتوحشة، حيث يقول: “ومع ذلك، في هذا الحفل، يلعب جهاز الدولة الأيديولوجي بالفعل الدور المهيمن، على الرغم من أننا بالكاد نستمع إلى موسيقاه: إنه صامت للغاية! هذه هي المدرسة، تأخذ الأطفال من جميع الطبقات الاجتماعية من روض الأطفال، بالطرق الجديدة والقديمة، وتغرس فيهم، لسنوات، السنوات التي يكون فيها الطفل هو الأكثر “ضعفًا”، عالقًا بين جهاز الدولة العائلي وجهاز الدولة المدرسي، “المعرفة” المُغَلَّفَةُ بالأيديولوجية السائدة (اللغة الفرنسية، الحساب، التاريخ الطبيعي، العلوم، الأدب)، أو بكل بساطة الأيديولوجية السائدة في حالتها النقية (الأخلاق، التربية المدنية، الفلسفة). في مكان ما [يقصد الفصل الدراسي] إلى السنة السادسة عشرة تقريبًا، ينضم عدد هائل من الأطفال “إلى الإنتاج”: هؤلاء هم العمال أو صغار المزارعين. يستمر جزء آخر من الشباب في سن المدرسة: ومهما كان الأمر، فإنه يقطع شوطًا طويلًا للسير على الطريق وشغل مناصب المديرين التنفيذيين الصغار والمتوسطين، والموظفين، وموظفي الخدمة المدنية الصغيرة والمتوسطة الحجم، والبرجوازيين الصغار. جميع الأنواع. وجزء أخير يصل إلى القمة، إما للوقوع في شبه البطالة الفكرية، أو لتوفير، بالإضافة إلى “مثقفي العمال الجماعيين”، عملاء الاستغلال (الرأسماليين، المديرين)، عملاء القمع (الجيش والشرطة). (الضباط، والسياسيون، والإداريون، وما إلى ذلك) والمهنيون الأيديولوجيون (الكهنة من جميع الأنواع، وغالبيتهم “علمانيون” مقتنعون).” [20]. وهذا دليل على خطورة المدرسة الرأسمالية والتكوين فيها، ذلك أنها مدرسة الغاية منها هي إنتاج العمال والمزارعين والعبيد لا إنتاج العلماء والمفكرين والفلاسفة والثوار!!
وسيقدم لنا تصوراً جدليا في الفقرة الموالية، حيث يعرض لنا تصوره للمدرسة الرأسمالية بكونها جهاز من الأجهزة الأيديولوجية المتميزة للدولة، تعمل على تعليم بعض المهارات المتضمنة في الغرس الهائل لأيديولوجية الطبقة البرجوازية وضمان إعادة إنتاج علاقات الإنتاج بنجاح، والتصور الذي تقدم المدرسة أو تعرف به نفسها بوصفها مؤسسة محايدة وعلمانية وتعمل على ضمان المعارف النزيهة والأخلاق الحميدة، بل أكثر من ذلك تدعي أنها تضمن الحرية والتحرر، بمعنى أنك ستضع طفلك داخل مؤسسة مدرسية (شبيهة بالمؤسسة السجنية)، وهي ستعمل جاهدا على ضمان الحرية والتحرر! ونجد في هذا الموقف الكثير من التناقض، والذي يحيل على أن المدرسة الرأسمالية متناقضة مع ذاتها ومبادئها فهي تدعي أنها تحرر بينما هي تسجن وتقيد الأفراد، نترككم مع هذا التناقض تكتشفونه بمعية لوي ألتوسير في هذه الفقرة: ” ومع ذلك، فإنه من خلال تعلم بعض المهارات المتضمنة في الْغَرْسِ الهَائِلِ لأَِيْدْيُولُوجِيَّةِ الطَّبَقَةِ المُهَيْمِنَةِ، يتم إلى حد كبير إعادة إنتاج علاقات الإنتاج في التكوين الاجتماعي الرأسمالي، أي علاقات الإنتاج. استغلال للمستغِلِّينَ ومن المستَغَلِّينَ إلى المستغِلِّينَ. إن الآليات التي تنتج هذه النتيجة الحيوية للنظام الرأسمالي تغطيها وتخفيها بشكل طبيعي أيديولوجية المدرسة السائدة عالميا، لأنها أحد الأشكال الأساسية للأيديولوجية البرجوازية السائدة: [كملاحظة مهمة هنا يقدم التَّصَوُرَ الذي تُقَدِّمُ المدرسة بِهِ نَفْسَهَا] أيديولوجية تُمَثِّلُ المدرسة كبيئة محايدة، خالية من الأيديولوجية (منذ… علماني)، حيث يَحْتَرِمُ المُعَلِّمُونَ “ضمير” و”حرية” الأطفال الموكلين إليهم (بثقة كاملة) من قبل “آبائهم” (وهم أيضًا أحرار، أي أصحاب أطفالهم) يجعلونهم يَصِلُونَ إلى الحرية والأخلاق والمسؤولية للبالغين من خلال قُدْوَتِهِمْ ومعرفتهم وأدبهم وفضائلهم “التحررية”. ” [21].
وهناك تحول آخر سيشهده موقف لوي ألتوسير من المدرسة، وهذا التحول هذه المرة ليس موجها صوب النقد الذي لمحناه في المرحلة الأولى، بل هذه المرة نجده يلعب دور الأبولوجي أي المدافع عن المدرسة، ذلك أنه رغم كل ذلك، يقر بأن المدرسة مفيدة لنا في عصرنا الحالي نفس الإفادة التي كانت الكنيسة مصدرها في القرون الوسطى القديمة، وكأنه أراد أن يؤكد رغم كل النقود التي وجهها إلى المدرسة مدى قيمة وأهمية وضرورة وإلزامية المدرسة، حيث نقرأ بمعيته هذا التحول المثير ! يقول معتذراً: ” أطلب المغفرة من السادة الذين، في ظروف مروعة، يحاولون الانقلاب على الأيديولوجية، وضد النظام، وضد الممارسات التي وقعوا فيها، وهي الأسلحة القليلة التي يمكنهم العثور عليها في التاريخ والمعرفة التي “يعلمونها”. إنهم نوع من الأبطال. لكنهم نادرون، وكم منهم (الأغلبية) ليس لديهم حتى بدايات الشك في «العمل» الذي يجبرهم عليه النظام (الذي يسحقهم ويسحقهم)، والأدهى من ذلك، أن يضعوا كل قلوبهم وبراعتهم أنجزته بالضمير الأخير (الطرق الجديدة المشهورة!). إنهم لا يدركون ذلك كثيرًا لدرجة أنهم يساهمون من خلال تفانيهم في الحفاظ على هذا التمثيل الأيديولوجي للمدرسة وتغذيته، مما يجعل المدرسة اليوم “طبيعية” ومفيدة لا غنى عنها، بل ومفيدة لمعاصرينا، مثل الكنيسة لقد كانت “طبيعية” ولا غنى عنها وسخية بالنسبة لأسلافنا قبل بضعة قرون. ” [22].
عندما نتحدث عن مؤسسة الكنيسة في العصور الوسطى الغابرة، فإننا نتحدث عن مؤسسة كانت بمثابة الأخطبوط آنذاك، حيث كانت لها سيطرة تامة وممتدة ومطلقة على سلطة الدولة، وتتحكم في جميع الأجهزة سواء المدرسة عبر تعليم ديني كنسي أو القانون عبر إحداث تشريعات وقوانين تتفق مع الكتاب المقدس، أو السياسة عبر إعمال سياسة بابوية في جميع مجالات الشأن العام، أو الثقافة عبر السماح فقط بنشر التقاليد والعادات والقيم والتعاليم الدينية المسيحية …إلى آخره، وهكذا في المرحلة المعاصرة ستحل المدرسة محل الكنيسة، وتصبح كذلك المدرسة بمثابة الأخطبوط، غير أنها لا تلعب دور التحكم، فهذا الأخير يعود للدولة، إلا أنها تنفتح على كل الميادين سواء (القانونية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والأخلاقية والقيمية…)، وهكذا ” في الواقع، تم استبدال الكنيسة اليوم بالمدرسة في دورها كجهاز الدولة الإيديولوجي المسيطر. إنها مقترنة بالعائلة، كما كانت الكنيسة في الماضي مقترنة بالعائلة. يمكننا بعد ذلك أن نؤكد أن الأزمة ذات العمق غير المسبوق، والتي تهز النظام المدرسي في العديد من الدول في جميع أنحاء العالم، والتي غالبًا ما تقترن بأزمة (تم الإعلان عنها بالفعل في البيان الشيوعي لكارل ماركس) والتي تهز نظام الأسرة، تأخذ معنى سياسيًا ، إذا اعتبرنا أن المدرسة (والمدرسة-العائلة) تشكل جهاز الدولة الأيديولوجي المسيطر، حيث يلعب الجهاز دورًا حاسمًا في إعادة إنتاج علاقات الإنتاج لنمط الإنتاج المهدد بوجوده من خلال الصراع الطبقي العالمي.” [23].
والآن سننتقل بشكل مباشر إلى المحور الثالث والأخير من مقالنا والذي يتطرق لمفهوم الأيديولوجيا واستعماله من قبل لوي ألتوسير، وفضلنا في هذا المحور الأخير، انتقاء مجموعة من النصوص التي تشير بشكل صريح إلى هذا المفهوم، وتشرحه وتفصل القول فيه، وذلك من أجل التعرف أكثر على تناول لوي ألتوسير لهذا المفهوم الفلسفي، الذي يشكل الركيزة الأساسية في فكره الفلسفي.
النص رقم 1: في مفهوم الأيديولوجيا (عناوين النصوص من اقتراحنا)
“نحن نعلم أن تعبير: الأيديولوجيا، صاغه كابانيس، وديستوت دي تريسي وأصدقاؤهما، الذين أرجعوا موضوعه إلى النظرية (الجينية) للأفكار. وعندما تناول ماركس هذا المصطلح مرة أخرى، بعد مرور 50 عامًا، فقد أعطاه، من أعماله المبكرة، معنى مختلفًا تمامًا. الأيديولوجيا إذن هي نظام الأفكار والتمثيلات التي تهيمن على عقل الإنسان أو المجموعة الاجتماعية. وسرعان ما واجهه الصراع الأيديولوجي السياسي الذي قاده ماركس من خلال مقالاته في جريدة Rhenish Gazette بهذا الواقع، وأجبره على تعميق حدسه الأول. ” [24].
النص رقم 2: في نظرية الأيديولوجيات.
” أولا لشرح السبب المبدئي الذي يبدو لي، إن لم يكن موجودا، على الأقل يجيز مشروع نظرية الإيديولوجية بشكل عام، وليس نظرية إيديولوجيات معينة ، والتي تعبر دائما، مهما كان شكلها (ديني). المواقف الطبقية الأخلاقية والقانونية والسياسية) .
ومن الواضح أنه سيكون من الضروري الانخراط في نظرية الأيديولوجيات ، في العلاقة المزدوجة التي أشير إليها للتو. سنرى بعد ذلك أن نظرية الأيديولوجيات تعتمد في نهاية المطاف على تاريخ التشكيلات الاجتماعية، وبالتالي على أنماط الإنتاج مجتمعة في التشكيلات الاجتماعية، وعلى الصراعات الطبقية التي تتطور هناك. بهذا المعنى، من الواضح أنه لا يمكن أن يكون هناك شك حول نظرية الأيديولوجيات بشكل عام، لأن الأيديولوجيات ( المحددة في العلاقة المزدوجة المشار إليها أعلاه: الإقليمية والطبقية) لها تاريخ ، من الواضح أن تحديده في الحالة الأخيرة أمر بالغ الأهمية. تقع خارج الأيديولوجيات وحدها، في حين لا تزال تتعلق بها.” [25].
النص رقم 3: الأَيْديولوجيَا الإِيدْيولوجيةُ idéologie idéologiques.
” وفي جميع الأحوال فإن الأيديولوجيا الإيديولوجية تعترف، رغم تشويهها الخيالي، بأن “أفكار” الذات الإنسانية موجودة في أفعاله، أو يجب أن توجد في أفعاله، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فإنها تنسب إليه أفكارا أخرى. المقابلة للأفعال (حتى المنحرفة) التي يقوم بها. تتحدث هذه الأيديولوجية عن الأفعال: سنتحدث عن الأفعال المُدرجة في الممارسات. وسوف نلاحظ أن هذه الممارسات تنظمها طقوس تُدرج فيها هذه الممارسات، ضمن الوجود المادي لجهاز أيديولوجي، حتى ولو كان جزءاً صغيراً جداً من هذا الجهاز: قسيس صغير في كنيسة صغيرة، جنازة، مباراة صغيرة في مجتمع رياضي، أو يوم دراسي في المدرسة، أو اجتماع أو اجتماع لحزب سياسي، وما إلى ذلك. ” [26].
النص رقم 4: الإنسان بطبعه حيوان أيديولوجي. L’homme est un être idéologique
” لكي نرى ما يلي [أو ما نقصد] بوضوح، يجب أن ندرك أن كلًا من كاتب هذه السطور، والقارئ الذي يقرأها، هم أنفسهم ذوات، وبالتالي ذوات أيديولوجية، أي أن كلا من المُؤَلِّفِ والقَارِئِ لهذه السطور يعيش «عفويًا» أو «طبيعيًا» أيديولوجيًا، بالمعنى الذي قلنا فيه أن «الإنسان بطبيعته حيوان أيديولوجي». ” [27].
النص رقم 5: تجليات الأيديولوجيات.
” تم طرح فكرة مفادها أن الأيديولوجيات تتحقق في المؤسسات، في طقوسها وممارساتها، الكيانات التعليمية المستقلة. لقد رأينا أنهم بهذه الصفة يساهمون في هذا الشكل من الصراع الطبقي، الحيوي بالنسبة للطبقة المهيمنة، والذي يتمثل في إعادة إنتاج علاقات الإنتاج. لكن وجهة النظر هذه نفسها، مهما كانت حقيقية، تظل مجردة. ” [28].
النص رقم 6: الدولة جهاز للصراع الطبقي.
” في الواقع، الدولة وجهازها لا معنى لهما إلا من وجهة نظر الصراع الطبقي، كجهاز للصراع الطبقي يضمن الاضطهاد الطبقي، ويضمن ظروف الاستغلال وإعادة إنتاجه. لكن لا يوجد صراع طبقي بدون طبقات معادية. من يقول الصراع الطبقي للطبقة المهيمنة يقول المقاومة والثورة والنضال الطبقي للطبقة المهيمنة.
لكن وجهة النظر هذه حول الصراع الطبقي في الكيانات الصناعية المستقلة لا تزال مجردة. في الواقع، فإن الصراع الطبقي في المعهد الدولي للتعليم هو بالفعل جانب من جوانب الصراع الطبقي، وهو في بعض الأحيان مهم وذو أعراض: على سبيل المثال النضال ضد الدين في القرن الثامن عشر، على سبيل المثال “أزمة” المدرسة العالمية للتعليم في جميع البلدان الرأسمالية اليوم. لكن الصراع الطبقي في الكيانات الصناعية المستقلة ليس سوى جانب واحد من الصراع الطبقي الذي يتجاوز الكيانات الصناعية المستقلة. إن الأيديولوجية التي تجعل الطبقة الحاكمة مهيمنة في الكيانات الصناعية المستقلة الخاصة بها هي بالفعل “تتحقق” في هذه الكيانات الصناعية المستقلة، لكنها تتجاوزها، لأنها تأتي من مكان آخر. ” [29].
النص رقم 7: حدود حدوس غرامشي عن مؤسسات الدولة.
” إن غرامشي، على حد علمنا، هو الوحيد الذي تقدم على الطريق الذي نسير فيه. كانت لديه فكرة “مفردة” مفادها أن الدولة لم تقتصر على جهاز الدولة (القمعي)، بل شملت، كما قال، عددًا معينًا من مؤسسات ” المجتمع المدني”: الكنيسة، المدارس، النقابات، إلخ. لسوء الحظ، لم ينظم غرامشي حدوسه، التي ظلت في حالة من الرموز الحادة ولكن الجزئية. ” [30].
ملاحظات ختامية:
في ختام مقالنا لا يسعنا سوى القول أن تصور لوي ألتوسير عن نظرية الدولة والأجهزة الأيديولوجية للدولة والنقود التي وجهها إلى مؤسسة المدرسة بوصفها جهازاً أيديولوجياً بإمتياز حل محل الكنيسة في القرون الوسطى، كل هاته النقود العميقة والجذرية (الراديكالية)، هي ما ميزت الفترة المعاصرة، حيث أن النقد والتفكيك والدحض والتفنيد وإعادة النظر والفحص والتمحيص والمساءلة والمراجعة الجذرية ومساءلة مدى التفكير le pensée sur les limites أو التَّفْكِيرُ في الْحُدُودِ هي من السمات الأساسية للفكر المعاصر والراهن، وهذا ما نلمسه لدى الفيلسوف الفرنسي الماركسي الجديد، حيث صرح بقيمة المدرسة الرأسمالية وفكر في حدوده، وانتهى في نهاية المطاف إلى التأكيد على الرغم من كل النقود الموجهة لها على أهمية وضرورة المدرسة التي هي بالنسبة له مفيدة جداً، وتجذر الإشارة هنا إلى أن أفكار لوي ألتوسير اتخذت مرحلتين أساسيتين، المرحلة الأولى المبكرة في حياة ألتوسير والتي اتسمت بالنقد والهدم والدحض والتفنيد والدعوة إلى الثورة على النظام والدولة، والمرحلة الثانية المتأخرة الأكثر حكمة ورصانة وهدوءاً التي سيعيد فيها النظر في كل أعماله النقدية ويراجعها ويغير من أفكاره ويعدل ويصلح فيها ويعلن فيها تخليه عن معظم أفكاره وطروحاته الثورية والماركسية، ولهذا على القارئ لمتن لوي ألتوسير أن يراعي هذا التحول في متن ألتوسير، فألتوسير الأول ليس هو ألتوسير الثاني، وبه وجب الإعلام والتنويه.
————-
المصادر المعتمد عليها:
[1]– Louis ALTHUSSER, “Idéologie et appareils idéologiques d’État. (Notes pour une recherche).” Article originalement publié dans la revue La Pensée, no 151, juin 1970. In ouvrage de Louis Althusser, POSITIONS (1964-1975), pp. 67-125. Paris: Les Éditions sociales, 1976, p 5.
[2]-[3]-[4]-[5]-[6]-[7]-[8]-[9]-[10]-ibidem, pp-6-32-36.ك
[11]-[12]-[13]-[14]-[15]-[16]-[17]-[18]-[19]-[20]-[21]-ibidem,pp-37-46.
[22]-[23]-[24]-[25]-[26]-[27]-[28]-[29]- ibidem, pp-47-58.
[30]-راجع غرامشي: الأعمال المختارة . الطبعات الاجتماعية، الصفحات 290، 291 (الحاشية 3)، 293، 295، 436. راجع أيضاً:
Lettres de la prison, Éditions Sociales, p.313.
*محمد فراح: طالب في المدرسة العليا للأساتذة بالرباط (جامعةمحمدالخامس)، سلك الإجازة في التربية تخصص التعليم الثانوي التأهيلي-الفلسفة، السنة الثالثة.
*المصدر: التنويري.