الاستعراب الألماني في القرن الواحد والعشرين: توماس باور وكتابه “ثقافة الالتباس”
ثقافة الالتباس
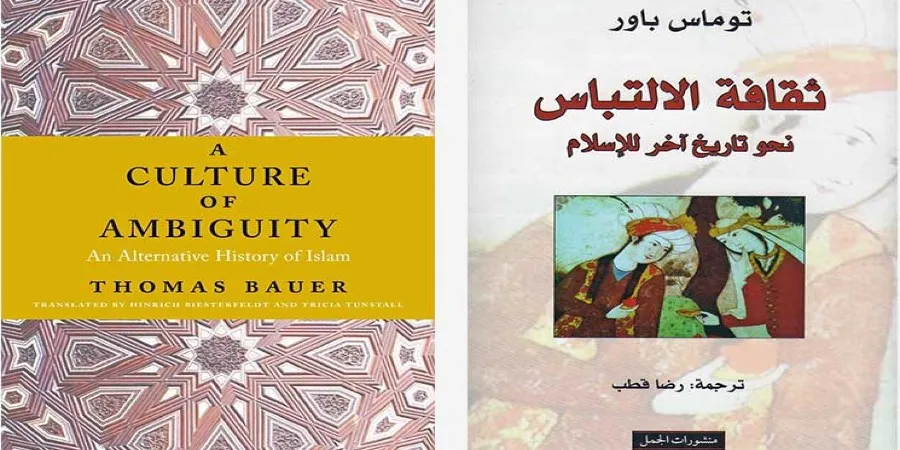
توماس باور المستعرب الألماني اختط لنفسه طريقا مختلفا إذ حاول أن يقدم إضافات جدية في مقارباته للثقافة العربية وللفكر الإسلامي وهي تتسم بشيء غير قليل من الروح الموضوعية والبعد عن الرؤية الاستشراقية التي اتسمت بها الدراسات الغربية للإسلام عموما والتي كانت محل نقد من قبل المفكر الفلسطيني الأمريكي إدوارد سعيد ، دراسات ومقاربات تمتلك أفكارا قبلية وخلفيات إيديولوجية ذات طابع استعلائي ومركزية ومساع تبشيرية عند بعض منهم لا تخفى بررت ربما الهيمنة وتعاونت معها بل كان بعضها خارطة طريق هذه الهيمنة .
ربما كان الاستعراب الألماني أكثرها قربا من الموضوعية وروح البحث ربما لأن ألمانيا لم تكن دولة إمبريالية مثل فرنسا وإنجلترا مثلا فهاتان الدولتان اقتسمتا العالم العربي برمته بعد تقسيم تركة الرجل المريض هذا الاستعمار الذي عانى العرب منه الويلات ولا يزال يعاني من مخلفاته إلى اليوم.
إذا كان باور امتدادا للمدرسة الاستعرابية الألمانية التي كان من رموزها بروكلمان ويوسف شاخت وآدم ميتز وسيغريد هونكه وفلايشر وفلوجل وهو متميز أكثر بجدية الطرح وفرادة الرؤية وليس معنى ذلك عدم وجود ثغرات في الاستعراب الألماني وتحيز عند بعضهم وربما استعلاء غير قليل عند بعضهم الآخر ولكن الطابع العام هو طابع البحث الرصين والرغبة في مقاربة الحقيقة واكتشافها عبر النصوص العربية الإسلامية والعمران والآثار عامة فكثير من المخطوطات وكنوز الثقافة العربية من أدب بشعره ونثره ومؤلفات في العلوم الإسلامية كان للألمان فضل تحقيقها وإخراجها إلى العالم كما كان لبحوثهم وتنقيبهم في العمران والآثار ومنهجيتهم الجادة والرصينة فضل في كشف روائع هذا التراث .
ليس غريبا إذا طابع الاحتفاء والتقبل الذي يبديه المجتمع الألماني للمسلمين في ألمانيا وكأن الألمان يطبقون فعليا تلك المقولة الما بعد حداثية والتي تفيد أن الهوية تغتني بالآخر بل وتجد معناها في الآخر المختلف ، وانعكس ذلك على السياسة الألمانية التي تحسن التعامل مع المسلمين المقيمين على أراضيها بصفتهم كمواطنين أو مقيمين ، ولا يعني هذا عدم وجد مشاكل مع اليمين مثلا ونزعته العدائية ولكنه يبقى يمينا مدانا من قبل الألمان أنفسهم ، هكذا إذا يستلهم الألمان المعاني التي نوه بها أديبهم الكبير غوته في مؤلفه الكبير الديوان الشرقي.
يأتي كتاب باور” ثقافة الالتباس نحو تاريخ آخر للإسلام” ليضيف لبنة في مقاربة الإسلام والعنوان ذاته يحيل على فكر مغاير ومقاربة مختلفة إذا أخذنا بعين الاعتبار أن العنوان عتبة أولى للمضمون “تاريخ آخر للإسلام” يعني بالتضاد أن هناك تاريخا رسميا أكاديميا هو غير ما يقصده الكاتب وهو التاريخ الذي صاغته الرؤية الاستشراقية الغربية ذات الطابع المركزي.
*القدس العربي 01 يوليو 2021
كتاب ضخم نسبيا في 478 صفحة نشرته دار الجمل في ألمانيا وبتعريب رضا قطب ، لقد انطلق الكاتب من مقولة لعالم فيزياء الكم ماكس بورن التي يقول فيها: (أعتقد أن أفكارا مثل الصواب المطلق والدقة المطلقة والحقيقة النهائية ….الخ هي لوثات عقلية لا ينبغي أن تمرر في أي علم …. إن هذا التبسيط للتفكير يبدو لي أكبر بركة جلبها لنا العلم الحديث والاعتقاد بامتلاك الحقيقة الوحيدة ومعتنقيها هي الأساس العميق لكل الشرخ في العالم” هذه المقولة التي يقتبسها باور من بورن تعد نقدا للمركزية الغربية في الصميم فهي التي تدعي امتلاك الحقيقة وأن ما عند الآخرين لا يعدو أن يكون شيئا تاريخيا في تطور الفكر الإنساني والحضارة تجاوزها الزمن فالحداثة الغربية هي المركز وهي المتن وما عداها هامش لا يؤبه له، ولا يمكن أن يشكل سوى عقبة كأداء في مزيد من التقدم والرخاء الإنساني.
العنوان ذاته عنوان ثوري ماذا يعني بثقافة الالتباس؟ إنه يعني أن الإسلام وهو يقصد المرحلة التي تمتد بين العصر العباسي حيث خصه الكاتب بفقرات قليلة ثم عصر السلاجقة مرورا بالمماليك وعصر العثمانيين والتي تقابل عند الأوروبيين ما يعرف بالعصور الوسطى قد عاش في ظل تعدد المعنى وأن ما يبدو تناقضا أو التباسا عاش إلى جنب مع المتداول في الإسلام ،هكذا استوعب الإسلام الفرق والمذاهب الإسلامية والصوفية والأفكار الأدبية والرؤى الشعرية المتسمة بالحرية الفردية ونزعة الاستمتاع بالحياة جنبا إلى جنب مع الأفكار التي توسم بالأصولية ، فالشعراء والفقهاء والمتصوفة وأرباب الفرق والمذاهب الفقهية والفكرية كلها عاشوا في ظل تعدد المعنى وفي دوحته ويحظى كل بالقبول في المجتمع الإسلامي ، في الوقت الذي كانت أوروبا في العصر الوسيط تعيش بمنطق الواحدية ورفض الآخر والعصبية المذهبية .
هذه المرونة والديناميكية والانفتاح على الآخر المختلف في ظل الإسلام تعود بالدرجة الأولى إلى القرآن ذاته النص الأول المؤسس للفكر والحضارة الإسلامية ،إن القرآن الكريم كما يرى الكاتب نص مفتوح قابل للقراءة المتعددة ولا تستنفذ معانيه بالتفاسير إن القراءات السبع أو العشر مثلا ليست راجعة فقط لاختلاف لهجات القبائل العربية بل إلى قاعدة تجيز التعدد في القراءة والتفسير وإن كان هناك ما يعيق ذلك ويقضى على الغنى والخصب في فهم وتفسير النص القٍرآني فليس سوى الترجمة لهذا يجعل الكاتب فصلين لعنوانين لافتين هما :هل يقول الله كلاما ذا بدائل ؟ وهل يتحدث الله حديثا له أكثر من معنى؟ .
في المأثور الإسلامي ينسب إلى الإمام علي بن أبي طالب قوله” القرآن حمال أوجه” وهذا بالذات ما يقصده باور، إن تعدد القراءة وتعدد المعنى صفة أصيلة في الإسلام وفي نصه المؤسس الأول وما القراءات السبع أو العشر إلا ذريعة أولى لتعدد المعنى إن ذلك التعدد هو الذي أغنى الإسلام بكل المذاهب الفكرية والفقهية والأصولية وحتى الفنية والأدبية ووجد في رحاب الإسلام قبولا بعكس الحداثة الغربية التي قضت على التعدد ومكنت لإيديولوجيا واحدة في الهيمنة هي الفهم الغربي للعالم ورؤيته وتفسيره الوحيد هو الممكن والمقبول .ولا ينسى الكاتب أن يوجه نقده للسلفية وأحد شيوخها ابن العثيمين فهو نظره بتنظيراته وتفسيراته يستلهم دون وعي منه تلك الإيديولوجيا الغربية في إنكار تعدد المعنى و تعدد القراءة وإقرار منهج واحد لا يجيز إلا فهما واحدا وقراءة واحدة لنصوص الإسلام ولعل الجمود التي يتسم به مجتمعه مثلا والنزوع إلى التقليد والاجترار يعود إلى هذه الخلفية السلفية التي ناهضت تعدد المعنى الذي يعد ركيزة في الإسلام.وما صراعات الوهابية مع الفرق الصوفية والمذاهب الفقهية والدينية وحربها الضروس التي شنتها على المختلفين إلا دليل على صحة نظر الكاتب .
لا شك أن الفكر النقدي الذي اتسم به الكتاب وطريقة والطرح والرؤية المنفتحة التي يمتلكها باور قد جعلته يطلع على نقائص فكر التنوير الذي حمله تيار التغريب كما يسمى والليبرالية كما تسمى تارة أخرى وقد وجه سهام النقد لها معيبا عليها تقربها من السلطة على حساب القيم التي نافحت عنها وبتنكرها للتراث وشعورها بالنقص أمام الآخر الأقوى (الغرب) صار ذلك الاتجاه التنويري والليبرالي عراب الاستبداد والتغريب ومكرس التبعية يتجلى ذلك في نقد الكاتب لطه حسين عميد الأدب العربي. ولاشك أن طه حسين يجنح في كتابه مستقبل الثقافة في مصر إلى تبرير هيمنة الرؤية الغربية بسبب مستوى التقدم والتمدن لكن العميد لم يكن عرابا للاستبداد وهو صاحب كتاب “المعذبون في الأرض” ووزير التعليم الذي دعا إلى مجانية التعليم، بعكس مثقفين آخرين كانوا ملكيين أكثر من الملك نفسه. وليس ببعيد أن نجد تزكية لهذا الرأي في مقدمة سارتر لكتاب فرانس فانون “معذبو الأرض” فقد حمل سارتر على البورجوازيات في المستعمرات السابقة ورآها مجرد بوق دعائي للغرب تكرس هيمنته متنكرة لقيمها وثقافتها ولشعوبها في الحرية الكاملة غير المشروطة ،بورجوازية وسيطة أضافت أعباء لشعوبها وخلفت المستعمر في تسيير بلدانها بل كانت وسيطا بينه وبين تلك الشعوب همها أن تحافظ على مكاسبها وامتيازاتها وقد دمغها بالمقولة المشهورة :”نحن نمتلك الكلمات وهم يستعيرونها”.
إن من يقرا الكتاب سوف يجابه بثقافة عربية وإسلامية مكينة وغزيرة لمؤلف الكتاب فمصادره ومراجعه عريقة تشعر بالتعب والاجتهاد والجهد المبذول يتجلى ذلك في الإحالات على المصادر والمراجع مما يعني أن الكاتب لا يصدر عن معرفة سطحية ولا يقدم خطابا إيديولوجيا مناقضا للخطاب الإيديولوجي الاستشراقي المعروف يقوم على المخالفة بغرض الشهرة والتزلف إلى العرب ولكنه خطاب علمي موضوعي تحدوه روح البحث عن الحقيقة والإخلاص لها ولو انتهى إلى نتائج لا يرضى عنها اليمين في أوروبا.
يقع الكتاب في فصول عديدة بعناوين لافتة ومحفزة مثل: التعدد الحضاري ،هل يقول الله كلاما ذا بدائل؟ ، نعمة الاختلاف ،الجد اللغوي والتلاعب اللفظي ،النظرة الرزينة للعالم وفي البحث عن اليقين.
عناوين مثيرة لمباحث جريئة تحفر في المخزون الثقافي العربي والإسلامي وتحيل على واقع عربي وإسلامي يتسم بتعدد المعنى والانفتاح مما أعطى ديناميكية ومرونة للفكر الإسلامي سمحت له بهضم الثقافات المجاورة وفي استيعاب أساليب المعيشة واللباس والعادات والتقاليد الموجودة عند الشعوب الإسلامية التي أسلمت في مجاهل إفريقيا وشرق آسيا وشرق أوروبا فلولا ديناميكية الإسلام ومرونته ووجود مبدأ تعدد القراءة وتعدد المعنى ما أمكن له أن يحظى بالقبول لدى تلك الشعوب.
يركز الكاتب على العصور التي تلت العصر العباسي الأول عصر التشكل كما يسميه (بدلا من ذلك سنعرض الحضارة الإسلامية في عصر ما بعد التشكل أي في الشكل الذي عليها مواجهة الحداثة فيه ، وذلك لأنه سواء في عصر بني بويه أو العصر العباسي الأول في معظمه يشيران إلى ما نظرنا إلى التاريخ الإسلامي بكامله إلى فترات تكوين لم يكن قد سلمت فيها التيارات الجوهرية التي ارتبطت فيما بعد بالإسلام السني. ولذلك فإنه قد بدا لي من المعقول أن أضع في بؤرة اهتمام دراستي إسلام ما بعد التشكل بجانب إسلام زمن الحداثة).
ينكر الكاتب أن الإسلام قد عرف عصورا وسطى كما عرفتها أوروبا وذلك راجع لتعدد المعنى وانفتاح الرؤية على مدى واسع من التأويل والاختلاف وكأن هوية الأمة الإسلامية في اختلافها وتعددها وبمجئ القرن التاسع عشر انتهى كل شيء حيث حلت الواحدية ورفض التعدد محل ذلك التنوع (في نهاية القرن التاسع عشر انتهى كل ذلك واختفت النظرية القياسية للبلاغة العربية من المناهج التعليمية . والشعر لم يعد مسموحا له أن يشتمل على تلاعب لفظي أو أن يكون مشبعا بتعدد المعنى بل ينبغي أن يعبر عن مشاعر صادقة بطريقة غير مصطنعة، بدأ الناس في الخجل من تراثهم الخاص وحتى يومنا هذا يرغب المثقفون العرب في محو ألف عام كاملة من تاريخ الأدب العربي إن لم يكن أكثر).
يستند باور في فكرته حول تعدد المعنى إلى اختلاف القراءات القرآنية فالقرآن الذي نزل على سبعة أحرف سمح بتعدد القراءة وقد كان ذلك قصدا لا اتفاقا وليس فقط مراعاة للهجات القبائل العربية فقط إن اختلاف القراءة قد أدى إلى مذاهب دينية وفكرية في الإسلام، القرآن الذي يصفه الإمام علي بأنه حمال أوجه غير أن المنزع الواحدي الذي ينزع إليه المسلمون قد عرقل تطورهم وجمد بهم وهذا منذ ظهور التيارات السلفية والأصولية التي يحمل عليها المؤلف حملة شعواء “إنه ليس العصر الوسيط والعصر الحاضر هم من يقفون متضادين بل يفعل ذلك الإصرار الحديث على إفراد المعنى والطاقة البعد حداثية المتطورة للتراث الإسلامي فيما بعد فترة التشكل). ولا يخفي بار إعجابه بجهد علماء الحديث (رغم الاتجاهات الإيديولوجية أو الفئوية…. فإنه مازال من المدهش كيفية تمكن علماء المسلمين بصورة كبيرة من إخضاع كل الأحاديث المروية باستمرار للمراجعة الصارمة وإبقائها بهذه الطريقة متجانسة بحق)، ولا ينسى أن يحمل حملة على السلفية وابن العثيمين(لقد نشأ المذهب الحنبلي في اختلاف مع الاتجاه الكلامي العقلاني للمعتزلة أي أنه كان في البداية اتجاها كلاميا بصورة خاصة ثم أصبح بعد ذلك مذهبا فقهيا.وهذا التوجه يفرض نفسه في صورة ربيبة المسمى باللامذهبية بتحفيز من الحداثة الغربية، إن السلفية تمثل بذلك الاتجاه العام في عقدنة الإسلام التي تمثل رد فعل على المطالبة الغربية الحديثة بالوضوح الأيديولوجي).
ينحى الكاتب باللائمة على مفكري العرب في القرن العشرين أولئك الذين في ظل حماستهم للفكر والثقافة الغربية وإعجابهم بالمستوى الحضاري الذي بلغه الغرب إلى حد تنكرهم لثقافتهم وتبنيهم للرؤية الغربية مما يعد تعديا على تنوع المعنى وتعدده وقد عبر عن ذلك شارل ملك حين قال (أن تكون في حذائه) أي نتبع الغرب في كل صغيرة وكبيرة لعلنا نبلغ أسباب الرقي يوما. وهو رأي سخيف إلى حد التنكيت يقول باور(ويعد الإصلاحيون الإسلاميون المحدثون في الغالب من أتباع نظرية التخلف تلك بحيث يضمنون بذلك الدعم الغربي ، إنهم يستسلمون لتقبل الفرضية الغربية التي وضعها يوسف شاخت بأن الفقه الإسلامي قد وصل بالشافعي إلى تكوينه النهائي في بداية القرن التاسع لكن هذا بالتأكيد ليس صحيحا ) وكان الكاتب يرد على نصر حامد أبي زيد على نصر حامد أبي زيد في كتابه “الإمام الشافعي وتأسيس الأيديولوجية الوسطية” فمنه استقى فكرة الكتاب.
تعتبر أسلمة الإسلام الأداة السياسية التي يتم بها إضفاء رؤية واحدة للعالم بالنسبة للغرب وإدانة كافة أشكال التعدد والاختلاف كقضية العراق 2003 وعدم التفريق بين المقاومة الوطنية والإرهاب وقد فضح ذلك يورغن تودينهوفر (هناك في المقاومة العراقية محاربون مسيحيون أكثر من إرهابي القاعدة). وكان الكاتب برنار نويل في كتابه “الموجز في الإهانة” الذي عربه الشاعر محمد بنيس قد انتبه إلى ذلك فعرى ثقافة الأسلمة التي يلجأ إليها الغرب لتشويه المقاومات المشروعة للعدوان الغربي والإسرائيلي على العالم العربي فحماس ليست سوى مقاومة وطنية مشروعة ضد الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة العراقية ليست سوى مقاومة مشروعة ضد الاحتلال الأمريكي والشيطنة التي يلجأ إليها الإعلام الغربي عبر إصباغ الطابع الإرهابي على تلك المقاومات بأسلمتها في شكل مجموعات أصولية متطرفة ليست سوى حلقة في مسلسل العدوان على الحرية وحق الشعوب في تقرير مصيرها وقتل كافة أشكال التعدد والرؤية المنفتحة على العالم.
ولا شك أن النقد الذي يوجه إلى الكتاب هو أنه قد يشعر المسلمين بالكمال والعصمة والسلامة من كل أذية والرضا عن أنفسهم مادام الكاتب قد أطنب في مدح التراث العربي الإسلامي والإشارة إلى تعدد القراءة فيه وانفتاحه على التأويل في حين أن الواقع العربي والإسلامي بعيد عن الأخذ بأسباب القوة والنهضة وأولها غياب الفكر لعلمي بمفهومه الكونتي وانتشار فكر ديني سلفي في الغالب وغياب الفكر العلمي والشفافية في تسيير الشأن العام وذلك يزيد من أزمة الأمة ووقوعها فريسة للتخلف والانحطاط والتبعية.
إن ولع الكاتب بالألاعيب اللفظية من حساب الجمل وتورية وجناس وما يقرأ طردا مديحا وعكسا هجاء والأبيات العواطل والأبيات الخيفاء والمعجمة وشتى ألوان الانحطاط في الكتابة التي يراها الكاتب علامة رقي وتعدد للمعنى وللقراءة لا يجد من المفكرين العرب المحدثين من يتفق معه. فهذا أدب انحطاط وليس أدب حياة ولا أدب قوة إن ذلك الأدب قد صاحب سبات الأمة وانحطاطها وما شاع فيها من طبقية واستبداد وفكر ديني متزمت وغياب التأليف العلمي الرصين .
في حين أن العصر العباسي الأول مثلا ما عرف الأدب العربي هذا اللون من الشعر والنثر المغرقين في التكلف والبهلوانيات اللفظية الجوفاء التي يقدرها باور ويثني عليها والتي ساهمت في انحطاط الأدب وخروجه من متن الحياة إلى هامشها.
والكتاب غني بمادته نوعي بمنهجه وبسعة ثقافة الكاتب اللغوية والأدبية والدينية فمصادره تدل على تمكنه من اللغة والثقافة العربية الإسلامية إلا من أخطاء قليلة كتحريفه لبعض أسماء الأعلام أو أخطاء معرفية كقوله بان العلاقة المثلية (الشذوذ) بين اثنين لا عقوبة عليها في الإسلام إذا كانت رضا بين الطرفين( الفاعل والمفعول به )؟ كما جاء في باب تعدد المتعة.
غير أن المترجم ولو أنه قام بجهد كبير مشكورا قد وقع في أخطاء لغوية وكثيرة كما وقعت الدار الناشرة للكتاب في أخطاء مطبعية تجعل متابعة الكتاب مهمة عسيرة وتضاعف جهد القارئ في التنبه للخطأ وإدراك الوجه الصحيح والمؤلف والدار مدعوان لتصحيح هذا الكتاب الكبير بمادته ومنهجيته ورؤيته المنفتحة والموضوعية معا.
ورغم كل ذلك فالكتاب جدير بالقراءة وجدير بالمناقشة وهو إضافة نوعية إلى المكتبة العربية وخرق للمألوف والمتداول في الكتابات الاستعرابية عن اللغة والإسلام كما عهدنا ذلك عند المستعربين المتسمة نظرتهم بالتعالي والتحيز والمركزية .
لقد كان باور مستعربا جيدا حرث في أرض أخرى بأدوات علمية وبنظرة علمية وبثقافة واسعة ورغم بعض نقائص الكتاب – كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه- مما جعل كتابه هذا فتحا معرفيا جديدا في الدراسات الغربية المقاربة للفكر وللثقافة العربية الإسلامية.
*المصدر: التنويري.





